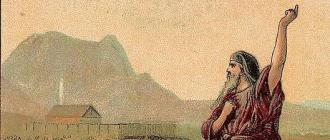من "فلسفة" العولمة إلى أيديولوجية العولمة: مصير روسيا. مشكلات الفلسفة السياسية الحديثة
إرسال عملك الجيد في قاعدة المعرفة أمر بسيط. استخدم النموذج أدناه
سيكون الطلاب وطلاب الدراسات العليا والعلماء الشباب الذين يستخدمون قاعدة المعرفة في دراساتهم وعملهم ممتنين جدًا لك.
تم النشر على http://www.allbest.ru
إن صورة الحداثة لن تكتمل دون الإشارة إلى يقينها التاريخي الجديد: العولمة. تُدخل العولمة انقسامات أو اختلافات هيكلية جديدة في التاريخ تُثري حداثة ما بعد الحداثة بشكل كبير.
ويجب القول أنه لا توجد وحدة في تفسير العولمة. الآراء هنا لا تتكاثر فحسب، بل تستقطب أيضا. بالنسبة للبعض، فهو توسيع لا شك فيه لفرص تأكيد الوجود الأصيل أو الفردي لجميع موضوعات العملية التاريخية: الأفراد، والفئات الاجتماعية، والشعوب، والبلدان، والمناطق. وبالنسبة لآخرين، فهي «الموجة التاسعة» من التاريخ، التي تجتاح كل الهويات والأصالة في طريقها. فمن ناحية، من الواضح أنهم يقومون بتبسيط الأمر: امنحوه الوقت وسيعمل كل شيء من تلقاء نفسه. ومن ناحية أخرى، فإنهم يبالغون في تصوير الأحداث، ويلومون كل الخطايا المميتة تقريباً: فوضى الحياة العامة وتجريمها، والتدهور الأخلاقي على نطاق واسع، وإفقار بلدان ومناطق بأكملها، والانتشار السريع لإدمان المخدرات، ومرض الإيدز، وما إلى ذلك.
دعونا نلاحظ أنه لا يوجد شيء جديد في النموذج الثنائي المتعارض لتصور العولمة. هذه وسيلة شائعة لتحديد وتوضيح مشكلة جديدة حقًا. إن العولمة هي، بطبيعة الحال، مشكلة جديدة. فريدة من نوعها، أو جديدة جذريًا، على وجه الدقة. والارتباك الأعظم في هذه المشكلة يأتي من أولئك الذين يساوون بين العولمة والتحديث. في الواقع، هذه عصور وعمليات تاريخية مختلفة تختلف اختلافا جذريا عن بعضها البعض. العولمة بمعنى التكامل، وزيادة النزاهة في إطار العصر الحديث (الزمن الجديد) هي التحديث؛ إن "تحديث" عصر ما بعد الحداثة (من الربع الأخير من القرن العشرين) هو في الواقع عولمة. يتم "منح" التحديث في الحالة الأخيرة بين علامتي تنصيص لسبب: أن العولمة متماسكة وعضوية ليس للتحديث، بل لما بعد الحداثة.
إن الرحم الأم للعولمة هو المجتمع ما بعد الصناعي، وهو مجتمع غربي في الأساس. ومن هناك تنمو، في تلك التربة توجد عصائرها الواهبة للحياة، وها هي في المنزل. لكن الشيء الرئيسي هو أنه هناك تؤتي ثمارها حقًا. ومع ذلك، مما قيل، لا يعني ذلك بأي حال من الأحوال أن العولمة ليست كوكبية، بل هي ظاهرة إقليمية حصرية ("المليار الذهبي")، وهي عملية "توحيد البلدان المتقدمة في معارضتها لبقية البلدان". من العالم."
العولمة عالمية لأنها لا تقاوم، بل تلتقط وتحتضن. وإذا كان هناك مواجهة فيها فهي تاريخية (بالنسبة للتطور السابق)، أي. زمانية وليست مكانية. ولكن لا شك أن هناك مشكلة هنا. إنها كيفية فهم هذا الالتقاط أو الاحتضان. في نظر البعض، تبدو العولمة وكأنها عملية تكنولوجيا معلومات متناحية، تغلف الكرة الأرضية بالكامل بشكل موحد دون انقطاع أو "تبلور" محلي. لكن هذا على الأرجح مفهوم خاطئ.
إن عملية العولمة في العالم الحديث لا تكاد تكون عالمية بمعنى أنها مستمرة وأمامية. واحدة من أكثر صورها انتشارًا ونجاحًا بلا شك هي شبكة الويب العالمية (الإنترنت). وفي رأينا أنه يمكن أن نبدأ منه في البحث عن البنية العامة للعولمة، ونسيجها التنظيمي.
إن العولمة هي استغلال عدم التجانس والاختلاف، وليس التجانس والتوحيد. يتم استغلال إمكانات هذا الأخير بالكامل في مرحلة التحديث.
هذا هو الفرح (المزايا) والحزن (العيوب) للوضع التاريخي الحالي. الفرح، المزايا: لا أحد يتعدى على ميزات أو اختلافات محلية أو إقليمية أو غيرها. ومن الغريب أن عملية العولمة هي التي سلطت الضوء عليها وقدمتها لنا بشكل كامل. يمكن للجميع (البلد، الشعب، الفئة الاجتماعية، الفرد) أن يؤكدوا أنفسهم بحرية (باختيارهم ومبادرتهم). الحزن وأوجه القصور: الاعتراف، إن لم يكن تشجيع الميزات أو الاختلافات، يتم جلبه إلى الحق في لمسها على الأقل. الآن يمكن الدفاع عن الأصالة إلى أبعد الحدود.
لقد أدت العولمة أيضًا إلى رفع مبدأ حياة السوق إلى أقصى الحدود وجعلته شاملاً في الاختراق. والآن لا يقتصر الأمر على السلع والخدمات فحسب، بل يمتد أيضًا إلى القيم ووجهات النظر والتوجهات الإيديولوجية. من فضلك، طرح، حاول، ولكن ماذا سيحدث، ما الذي سينجو، ما الذي سيفوز - المنافسة في السوق ستقرر. كل شيء، بما في ذلك الثقافة الوطنية، له الحق في الوجود، وفي الواقع، البقاء على قيد الحياة في ظروف أشد صراع السوق. ومن الواضح أنه لن تتمكن كل هوية من اجتياز اختبار السوق والمنافسة. وسوف تصبح حالات الإفلاس المعيارية أيضاً حقيقة واقعة، إن لم تكن بالفعل. بشكل عام، تجري عملية تشكيل ثقافة وجود عالمية موحدة. وفي ضوء هذا المنظور، من المرجح أن يتم الحفاظ على أنظمة القيم الوطنية الثقافية الأصلية كمحميات إثنوغرافية، على مستوى الفولكلور وفي شكله.
تستبعد عولمة ما بعد الحداثة الهجمات والمصادرات العدوانية - فكل شيء موجود فيها بالفعل. ليس هناك فائدة من الاعتماد على المساعدة الخارجية في مثل هذه الحالة. لكن الكثير، إن لم يكن كل شيء، يعتمد الآن على الاختيار التاريخي، على "إرادة التطور" لدى الأشخاص التاريخيين المستقلين تمامًا (بشكل هائل). الجميع، حسنًا، الجميع تقريبًا، لديهم فرصة لاختراق عصر ما بعد الصناعة. كل ما تبقى هو استخدامه.
لقد تم إحياء العولمة من خلال المنطق العضوي للتطور التاريخي، بدعم من المبادرة والنشاط الإسقاطي المستهدف للبشرية الغربية (وفي المستقبل - جميعها). نتيجة للتوسع، والأهم من ذلك، ملء "مساحة المعيشة" للتحديث. العولمة الحضارية الفلسفية
لا يمكن للعولمة أن تفشل. إنها مرحلة ضرورية في تطور البشرية. والتنوع ليس مستبعدا، بل على العكس من ذلك، فهو مفترض، ولكن الآن في إطار هذا النوع التاريخي.
بمعنى آخر، لا يوجد بديل (معاكس) للعولمة، بل هناك بدائل (خيارات) في إطار العولمة. وتمثلهم بعض الاستراتيجيات الوطنية للاندماج في عمليات العولمة الحديثة.
بدأ العديد من المؤرخين والفلاسفة في البحث عن تفسيرات للتطور الغريب ليس فقط للبلدان والمناطق الفردية في العالم، ولكن أيضًا لتاريخ البشرية ككل. وهكذا، في القرن التاسع عشر، ظهرت أفكار المسار الحضاري لتنمية المجتمع وانتشرت على نطاق واسع، مما أدى إلى ظهور مفهوم تنوع الحضارات. كان عالم الطبيعة والمؤرخ الروسي ن.يا. دانيلفسكي (1822-1885). وفي كتابه “روسيا وأوروبا” (1871)، محاولاً التعرف على الاختلافات بين الحضارات التي اعتبرها أنواعاً ثقافية وتاريخية إنسانية فريدة ومتباينة، فقد حدد زمنياً الأنواع التالية من تنظيم التكوينات الاجتماعية التي تعايشت عبر الزمن، وكذلك الأنواع المتعاقبة: 1) المصري، 2) الصيني، 3) الآشوري البابلي، 4) الكلداني، 5) الهندي، 6) الإيراني، 7) اليهودي، 8) اليوناني، 9) الروماني، 10) السامي الجديد، أو العربية، 11) الرومانية الجرمانية، أو الأوروبية، والتي أضيفت إليها حضارتان من أمريكا ما قبل كولومبوس، دمرهما الإسبان. الآن، كان يعتقد أن النمط الثقافي الروسي السلافي قادم إلى الساحة التاريخية العالمية، وهو مدعو، بفضل مهمته العالمية، إلى إعادة توحيد البشرية.
تم تطوير نظرية الحضارات بشكل أكبر في أعمال المؤرخ الإنجليزي أ.ج. توينبي (1889-1975).
بدأ العديد من المؤرخين والفلاسفة في البحث عن تفسيرات للتطور الغريب ليس فقط للبلدان والمناطق الفردية في العالم، ولكن أيضًا لتاريخ البشرية ككل. وهكذا، في القرن التاسع عشر، ظهرت أفكار المسار الحضاري لتنمية المجتمع وانتشرت على نطاق واسع، مما أدى إلى ظهور مفهوم تنوع الحضارات. كان عالم الطبيعة والمؤرخ الروسي ن.يا دانيلفسكي (1822-1885) من أوائل المفكرين الذين طوروا مفهوم تاريخ العالم كمجموعة من الحضارات المستقلة والمحددة، والتي أطلق عليها الأنواع الثقافية التاريخية للإنسانية. وفي كتابه “روسيا وأوروبا” (1871)، محاولاً التعرف على الاختلافات بين الحضارات التي اعتبرها أنواعاً ثقافية وتاريخية إنسانية فريدة ومتباينة، فقد حدد زمنياً الأنواع التالية من تنظيم التكوينات الاجتماعية التي تعايشت عبر الزمن، وكذلك الأنواع المتعاقبة: 1) المصري، 2) الصيني، 3) الآشوري البابلي، 4) الكلداني، 5) الهندي، 6) الإيراني، 7) اليهودي، 8) اليوناني، 9) الروماني، 10) السامي الجديد، أو العربية، 11) الرومانية الجرمانية، أو الأوروبية، والتي أضيفت إليها حضارتان من أمريكا ما قبل كولومبوس، دمرهما الإسبان. الآن، كان يعتقد أن النمط الثقافي الروسي السلافي قادم إلى الساحة التاريخية العالمية، وهو مدعو، بفضل مهمته العالمية، إلى إعادة توحيد البشرية.
تم تبني العديد من أفكار دانيلفسكي في بداية القرن العشرين من قبل المؤرخ والفيلسوف الألماني أوزوالد شبنغلر (1880-1936)، مؤلف العمل المكون من مجلدين “انحدار أوروبا”. في أحكامه حول تاريخ البشرية، في مقارنة الحضارات المختلفة مع بعضها البعض، كان سبنجلر أكثر قاطعة بما لا يقاس من دانيلفسكي. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن "تراجع أوروبا" كتب خلال فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي صاحبت الحرب العالمية، وانهيار ثلاث إمبراطوريات عظيمة والتغيرات الثورية في روسيا. حدد شبنجلر في كتابه 8 ثقافات عليا، تتطابق قائمة هذه الثقافات أساسًا مع الأنواع الثقافية والتاريخية لدانيلفسكي (المصرية، والهندية، والبابلية، والصينية، واليونانية الرومانية، والبيزنطية العربية، وأوروبا الغربية، والمايا)، كما استبقت ازدهارها. للثقافة الروسية. لقد ميز بين الثقافة والحضارة، فلم ير في الأخيرة سوى تراجع، المرحلة الأخيرة من تطور الثقافة عشية وفاتها، عندما يتم استبدال الإبداع بتقليد الابتكارات وطحنها.
إن تفسير شبنجلر لكل من تاريخ العالم وتاريخ الثقافات والحضارات المكونة له فرديًا هو تفسير قدري. تُعطى كل ثقافة مهلة زمنية معينة منذ نشأتها وحتى اضمحلالها - حوالي ألف عام.
تم تطوير نظرية الحضارات بشكل أكبر في أعمال المؤرخ الإنجليزي أ.ج. توينبي (1889-1975).
في عملية تطوير مفهوم الحضارات، شهدت وجهات نظر توينبي النظرية تطورًا كبيرًا، وفي بعض المواقف، حتى نوعًا من التحول.
التزم توينبي بمثل هذه الأفكار حول الحضارات التي كانت تشبه إلى حد كبير مفهوم سبنجلر: فقد أكد على تجزئة الحضارات، واستقلالها عن بعضها البعض، مما لا يسمح لها بتوحيد تاريخها الفريد في التاريخ العام للبشرية. وهكذا، نفى التقدم الاجتماعي باعتباره التطور التدريجي للإنسانية. كانت كل حضارة موجودة خلال الفترة التي خصصها لها التاريخ، على الرغم من أنها لم تكن محددة مسبقًا كما خصصها سبنجلر لثقافاته. وكانت القوة الدافعة وراء تطور الحضارات هي جدلية التحدي والاستجابة. وطالما كانت الأقلية المبدعة التي تتحكم في تطور الحضارة، أي نخبتها، قادرة على تقديم استجابات مرضية للتهديدات الداخلية والخارجية التي تهدد نموها المتميز، فقد تعززت الحضارة وازدهرت. ولكن بمجرد أن تبين أن النخبة، لأي سبب من الأسباب، عاجزة في مواجهة التحدي التالي، حدث انهيار لا يمكن إصلاحه: تحولت الأقلية الإبداعية إلى أقلية مهيمنة، وتحول الجزء الأكبر من السكان بقيادةهم إلى "البروليتاريا الداخلية" التي بمفردها أو بالتحالف مع "البروليتاريا الخارجية" (البرابرة) أغرقت الحضارة في الانحدار والموت. وفي الوقت نفسه، لم تختف الحضارة دون أن يترك أثرا؛ وفي مقاومة الانحدار، ولدت "دولة عالمية" و"كنيسة عالمية". اختفى الأول مع وفاة الحضارة، والثاني أصبح نوعا من "العذراء" - الوريثة التي ساهمت في ظهور حضارة جديدة.
في البداية، حدد توينبي تسع عشرة حضارة مستقلة ذات فرعين: المصرية، الأنديزية، الصينية، المينوية، السومرية، المايا، السند، الحيثية، السورية، الهلنستية، الغربية، الأرثوذكسية، الشرق الأقصى، الإيرانية، العربية، الهندوسية، البابلية، يوكاتان، المكسيكية؛ وكان فرعها في اليابان مجاوراً للشرق الأقصى، وفرعها في روسيا مجاوراً للأرثوذكس. بالإضافة إلى ذلك، تم ذكر العديد من الحضارات المتوقفة في تطورها، كما تم ذكر عدة حضارات فاشلة.
بعد ذلك، ابتعد توينبي تدريجياً عن المخطط المذكور أعلاه. بداية، بدا أن العديد من الحضارات قد تبنت بشكل متزايد تراث أسلافها. وهكذا، من بين الحضارات الـ 21 الأصلية، بقيت 15 حضارة، دون احتساب الحضارات الجانبية. يعتبر توينبي خطأه الرئيسي هو أنه في البداية في بناءاته التاريخية والفلسفية انطلق من نموذج هلينستي واحد فقط ووسع قوانينه إلى الباقي، وعندها فقط أسس نظريته على ثلاثة نماذج: الهلنستية والصينية والإسرائيلية.
وهكذا، فإن نظرية الحضارات في الأعمال اللاحقة لتوينبي والعديد من أتباعه انجذبت تدريجيًا نحو تفسير عالمي للتاريخ العالمي، نحو التقارب، وعلى المدى الطويل (على الرغم من التكتم الذي أحدثه تطور الحضارات الفردية) - نحو الروحانية. والوحدة المادية للبشرية.
تم النشر على موقع Allbest.ru
...وثائق مماثلة
مفهوم "العولمة". إن معلوماتية المجتمع هي أحد أسباب عولمته. العولمة في مجال الاقتصاد والسياسة. العولمة الثقافية: الظاهرة والاتجاهات. الدين والعولمة في المجتمع العالمي. النظريات الاجتماعية والفلسفية.
الملخص، تمت إضافته في 15/02/2009
فكرة الحضارة بمختلف مفاهيمها الفلسفية وخصائصها وأنماطها. المدخل الحضاري لتاريخ الفلسفة. مفهوم O. Spengler، Arnold، Joseph Toynbee، P.A. سوروكينا، ن.يا. دانيلفسكي. آلية ولادة الحضارات.
تمت إضافة الدورة التدريبية في 29/05/2009
طرق فهم طبيعة المجتمع. دور العقلانية في تنمية الكائن الاجتماعي وتكويناته النظامية والهيكلية. دراسة فلسفية للعملية التاريخية: تنوع الثقافات والحضارات. المشاكل الفلسفية لروسيا الحديثة.
الملخص، تمت إضافته في 28/01/2010
التنبؤ الاجتماعي والاستشراف العلمي كأشكال من الفهم الفلسفي لمشكلة المستقبل. تحليل المشاكل العالمية في عصرنا وترابطها وتسلسلها الهرمي. مفاهيم مجتمع ما بعد الصناعة والمعلومات وظاهرة العولمة.
الملخص، تمت إضافته في 15/04/2012
دراسة وجهات النظر الفلسفية لأفلاطون وأرسطو. خصائص وجهات النظر الفلسفية لمفكري عصر النهضة. تحليل تعاليم كانط حول القانون والدولة. مشكلة الوجود في تاريخ الفلسفة هي النظرة الفلسفية للمشاكل العالمية للإنسانية.
تمت إضافة الاختبار في 04/07/2010
الفهم الفلسفي لعمليات العولمة من وجهة نظر القيم. إشراك الكنائس المسيحية في حل المشاكل العالمية في عصرنا. التسامح كقيمة زائفة للوجود. جوهر وميزات مجتمع ما بعد الصناعة. عدم المساواة في المعلومات.
الملخص، تمت إضافته في 04/05/2013
سمات المعرفة الفلسفية باعتبارها انعكاسا لملامح الوجود الإنساني. مشكلة الإنسان في المعرفة الفلسفية والطبية. جدلية الاجتماعية البيولوجية في الإنسان. التحليل الفلسفي للمشاكل العالمية في عصرنا. معرفة علمية.
دليل التدريب، تمت إضافته في 17/01/2008
الإرهاب كمشكلة العولمة الحديثة وجوهرها والأسباب الرئيسية لظهورها في المجتمع وأساليب واتجاهات تنفيذها وأنواعها وأشكالها. الإرهاب السيبراني كتحدي اجتماعي وتهديد سياسي. فلسفة محتوى هذا النشاط.
تمت إضافة الاختبار في 04/05/2013
مقاربات واتجاهات في العلوم التاريخية الحديثة. أ. مفهوم توينبي الأصلي لتاريخ العالم وتقدمه؛ النهج الحضاري. جوهر وخصائص الحضارات المحلية ومفهوم “وجودها وتطورها وتفاعلها”.
الملخص، تمت إضافته في 29/12/2016
الخصائص والسمات المميزة لتطور الفلسفة البيلاروسية في عصر التنوير. تأثير أفكار التنوير على أنشطة الجمعيات القانونية والسرية في بيلاروسيا. السيرة الذاتية وتحليل الأفكار الفلسفية لبينيديكت دوبسزيفيتش وأندريه سنياديكي.
نتيجة لدراسة مادة هذا الفصل يكون الطالب :
يعرف
- خلفية العولمة، واتجاهات التكامل الرئيسية؛
- محتوى مفهوم المجتمع الصالح واختلافه عن المجتمع المثالي؛
- كيف تتجلى الرغبة في السمو في المجتمع الحديث؛
- النهج الأساسية لفهم العقلانية؛
يكون قادرا على
- تحليل تأثير العولمة على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع؛
- شرح طبيعة التغيرات في مجال الثقافة في مجتمعات ما بعد الصناعة؛
- استخدام أساليب مختلفة لفهم العقلانية؛
- تطبيق المعرفة المكتسبة لبناء أحكامك الخاصة عند دراسة العمليات والظواهر المختلفة؛
ملك
- الجهاز المصطلحي الرئيسي في مجال الفلسفة السياسية؛
- مهارات في تحليل مشاكل الفلسفة السياسية الحديثة.
- القدرة على صياغة الأحكام والحجج الخاصة بالفرد بشأن مشاكل معينة بناءً على المعرفة المكتسبة.
من بين العديد من مشاكل الفلسفة السياسية الحديثة، اخترنا تلك التي تظهر بطريقة أو بأخرى في مشاكل أخرى، ومنحها الزخم الأولي، وتحديد صياغتها ذاتها.
العولمة
العولمة هي عملية عالمية من التكامل الاجتماعي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي واللغوي والمعلوماتي. العولمة الحديثة هي تطور طبيعي لعدد من الظواهر والاتجاهات في تطور الحضارة. هنا فقط بعض منهم:
- الإمبراطوريات التاريخية كمجتمعات عالمية أولية تنفذ مشاريع سياسية عالمية معينة. ومن أوضح الأمثلة: إمبراطورية الإسكندر الأكبر، والإمبراطورية الرومانية، والإمبراطورية البريطانية؛
- فترة الاكتشافات الجغرافية العظيمة، والتوسع اللاحق للدول الأوروبية، والتقسيم الاستعماري للعالم والعديد من الإمبراطوريات الاستعمارية الكبيرة؛
- ظهور في القرن السابع عشر أولى الشركات العابرة للقارات (شركة الهند الشرقية الهولندية). تطوير هذه الممارسة الاقتصادية في المستقبل؛
- النقل عبر الممرات المائية العالمية، وتجارة الرقيق؛
- تطوير النقل (السكك الحديدية والطرق والطيران) والاتصالات (البريد والبرق والهاتف)؛
- الاتفاقيات والتحالفات الدولية الكبرى: سلام وستفاليا 1648، سلام فيينا 1815، اتفاقية يالطا 1945
تتجلى العولمة الحديثة في نمو اتجاهات مثل:
- تشكيل الأسواق العالمية، بما في ذلك سوق العمل، وحجم المنافسة العالمية فيها؛
- التقسيم العالمي للعمل وتخصص الاقتصادات، والاستعانة بمصادر خارجية من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية؛
- ونمو احتكارات القلة والاحتكارات، بما في ذلك الشركات عبر الوطنية؛
- توحيد العمليات الاقتصادية والتكنولوجية، والتشريع جزئيًا؛
- حركة رأس المال غير المنظمة؛
- تشكيل مجتمع المعلومات، مجتمع شبكة المشروع العالمي؛
- والهجرة المكثفة والتعددية الثقافية للدول القومية؛
- إنشاء وأنشطة المنظمات فوق الوطنية والعالمية - من الأمم المتحدة، واليونسكو، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، ورابطة الدول المستقلة؛
- تأثير العملات العالمية على العمليات الاقتصادية في مختلف البلدان، والدور المتزايد لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وأسواق الأوراق المالية؛
- والطبيعة العالمية للإنترنت والهواتف المحمولة وتكنولوجيا المعلومات؛
- نمو السياحة الدولية والاتصالات الإنسانية، بما في ذلك في مجال التعليم.
في الفلسفة السياسية، يمكن فهم العولمة بشكل موضوعي على أنها عملية متطورة من التكامل العالمي، مشروطة بالمسار العام للتطور الحضاري. ويمكن فهم العولمة بشكل تقييمي - من وجهة نظر نتائج وعواقب عملية العولمة. والحقيقة أن العولمة تؤدي إلى نشوء عدد من الظروف التي تعمل على خلق فرص غير مسبوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية: إذ يجري الآن تشكيل الأسواق العالمية؛ والمنافسة عالمية، مما يخلق حوافز قوية للتنمية المبتكرة؛ ويتم إنشاء فرص شراكة وتعاون غير مسبوقة؛ في الاقتصاد المعولم، ليس من الضروري أن تكون "كبيرًا وسمينًا"، فحتى الشركات الصغيرة قادرة على احتلال موقع احتكاري في شبكة الاقتصاد العالمي، ولكن لهذا يجب عليها أن تشكل عرضًا فريدًا. الفريدة عالميًا فقط.
وفي الوقت نفسه، فإن رفض العولمة يجعل المرء يعتمد عليها بشكل كامل على الفور، لأنه لا يمكن لأي مجتمع في العالم الحديث أن يتطور في عزلة اقتصادية كاملة.
ونتيجة لذلك، يتم الجمع بين تكامل السوق والتخصص العالمي، الأمر الذي يجعل في بعض الأحيان الجهود التي تبذلها بعض الدول لتطوير اقتصادات مكتفية ذاتيا غير ضرورية. على سبيل المثال، قامت الحكومة الاشتراكية في رومانيا بالتصنيع بتكلفة كبيرة. ولكن في الظروف الحديثة، تبين أن السيارات والدبابات والطائرات الرومانية غير ضرورية حتى بالنسبة لرومانيا نفسها.
حاليًا، الخطوط العريضة للاتجاهات في التخصص العالمي واضحة تمامًا:
- اقتصاد المعرفة ما بعد الصناعية - وخاصة البلدان التي كانت أول من خضع للتحديث؛
- الاقتصاد الصناعي - الدول الآسيوية في الغالب؛
- المواد الخام (من المعادن إلى المنتجات الزراعية) - دول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا.
إن الموقف التقييمي السلبي تجاه العولمة نشط للغاية في روسيا الحديثة، ويرجع ذلك إلى الوضع الضعيف للاقتصاد الروسي في المنافسة العالمية، ومناخ الاستثمار، والمجالات القانونية والاجتماعية. ففي العقد الأخير من القرن الماضي وحده، تم سحب أكثر من 300 مليار دولار من البلاد، وهو ما يعادل بالأسعار الحالية ما يقرب من ثلاث خطط مارشال، الأمر الذي جعل من الممكن استعادة اقتصادات ما بعد الحرب في البلدان الأوروبية.
إن الفوائد الاقتصادية للعولمة بالنسبة للمنتجين القادرين على المنافسة واضحة. لكن الفرص المتاحة في مجالات المعلومات والاجتماعية والثقافية والإنسانية لا تقل وضوحا. ومن ثم فإن العولمة تخلق فرصاً غير مسبوقة لتنمية رأس المال البشري، عندما يحصل الفرد، مع احتفاظه بهويته الثقافية الأساسية، على فرصة استكمالها بكفاءات حياتية أخرى، تمنح كل واحدة منها الفرد فرصاً إضافية لتحقيق الذات والمزايا التنافسية. في سوق العمل العالمي. في أوروبا الغربية الحديثة، يعتبر 50٪ فقط من السكان أنفسهم أوروبيين (أي أنهم يعتبرون أنفسهم في المقام الأول ينتمون إلى الاتحاد الأوروبي)، لكنهم لا يرون في ذلك تهديدًا لهويتهم الوطنية والعرقية، لأن كل ثقافة (لغة) والتقاليد التاريخية والخبرة الروحية) توفر كفاءات إضافية وتوسع رأس المال البشري وفرص الحياة للفرد.
وفي المجال السياسي وحتى القانوني، تخلق عمليات التكامل أيضًا حقائق إيجابية جديدة وضمانات سياسية وقانونية. على سبيل المثال، تصبح المطالبات المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بعض الأحيان الأمل الأخير لمواطني الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان دائمًا.
إن العولمة، بطريقة أو بأخرى، عملية غير متجانسة وغامضة. ومن الناحية السياسية، فهو يفجر النظام الويستفالي للدول القومية، ويحد من سيادتها. لقد بدأ الآن في الظهور نظام جديد من العلاقات المتبادلة والتفاعلات بين الدول، مع ميل نحو الدور القيادي الذي تلعبه الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي.
هناك نوع من المجتمع العالمي آخذ في الظهور (المجتمع العالمي) النخب (بما في ذلك على مستوى العلاقات والاتصالات الشخصية) ومجتمع معين من المنظمات الدولية عبر الدول (المجتمع الدولي).
والنتيجة السياسية الرئيسية هي الاتجاه نحو تشكيل وتأسيس نظام عالمي يرتبط بعدد من السمات المثيرة للجدل، مثل:
- التسلسل الهرمي للدول ودعمها المتبادل، مما يحد من السيادة. وتشكل أعلى هذه الدول هياكل فوق وطنية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة الثماني، ومجموعة العشرين، والتي يتم من خلالها تطوير القرارات التي تحدد المبادئ التوجيهية للتنمية العالمية؛
- وتطوير النقل العالمي وشبكات المعلومات والترابط بين الاقتصادات؛
- وعدم قدرة الدول الفردية على حل المشاكل العالمية بطبيعتها بنفسها؛
- الوعي بدور سلامة الحضارة الإنسانية، والترابط بين أجزائها، عندما يمكن أن يسبب التطوير المفرط للإقراض العقاري أزمة اقتصادية عالمية، ويمكن أن يؤدي تدمير الغابات في البرازيل إلى حدوث أعاصير وحرارة في أوروبا؛
- الدور القيادي لاقتصاد المعرفة، وقوة المعرفة غير ديمقراطية في جوهرها؛
- أزمة العلوم الاقتصادية والبيئة غير قادرة على التنبؤ بمواقف الأزمات. تعمل الاكتشافات العلمية على توسيع نطاق عجز العقل البشري؛
- إنذار (القلق، تجربة التهديد المستمر للأمن) كوعي بالمخاطر العامة - المخاطر في الاقتصاد والبيئة والأوبئة والكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان، واستخدام الأسلحة النووية؛
- أزمة النزعة الإنسانية التنويرية التي أعلنت القيمة الأساسية للإنسان واحتياجاته. تبين أن ثمار التنوير كانت، إن لم تكن مريرة، غامضة إلى حد ما؛
- إن إدراك أن هناك قيمًا أكبر من الإنسان، واعتماد الجميع على الجميع، يؤدي إلى المطالبة بقيم مشتركة جديدة، والحاجة إلى مؤسسات سياسية مناسبة تضمن الاحتفاظ بالسيطرة العامة.
ولا تساهم هذه السمات في تنمية الحرية أو "حوار الثقافات" الخلاق أو "توليفها". بل على العكس من ذلك، فهي تحفز الدوافع الأمنية، وتقييد الحريات، والتلاعب بالوعي العام، وهو ما يتجلى في حروب المعلومات، وتكامل أجهزة الاستخبارات، والحروب والثورات من "النوع الجديد".
ويرد في الجدول تحليل SWOT لـ "إيجابيات" و"سلبيات" العولمة. 10.1.
الجدول 10.1
الآثار الإيجابية والسلبية للعولمة
|
إيجابي |
سلبي |
|
|
إن العواقب الإيجابية والسلبية للعولمة لا يمكن فصلها وتفترض بعضها البعض، مثل قطبي مغناطيس واحد: من المستحيل فصل قطب واحد عن الآخر؛ بقطع المغناطيس، نحصل على مغناطيسين جديدين بنفس القطبين.
لذلك، من الضروري التعايش والعمل مع هذا التناقض والغموض الذي تتسم به العولمة كما هو الحال مع المرحلة الحالية من تطور الحضارة الإنسانية. وتكمن المفارقة السياسية للعولمة في حقيقة أن هذا النظام العالمي، الذي يحمل سمات إمبريالية معادية للديمقراطية، يلجأ إلى أفكار الديمقراطية وحقوق الإنسان.
لقد أعطى الجدل الدائر حول العولمة حياة ثانية للجغرافيا السياسية، حيث عارض كلاً من النهج الحضاري والتكويني للتاريخ السياسي.
يعتبر النهج التكويني، الذي قدمته الماركسية بشكل كامل ومفصل، العملية التاريخية كتغيير في التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية (النظام المشاعي البدائي، العبودية، الإقطاع، الرأسمالية، الشيوعية)، كل منها يعطي مستوى جديد من تطور المجتمع. القوى المنتجة للمجتمع والإنتاجية الاجتماعية للعمل، فضلا عن مستوى جديد من الحرية الفردية.
في النهج الحضاري (أ. توينبي، آي. دانيلفسكي، أ. شبنجلر) كل حضارة مكتفية ذاتيا، ويسمح بالتطور والتقدم التاريخي، ولكن لكل حضارة طريقها الخاص في التطور، ولا يوجد تقدم تاريخي تراكمي من هذا وجهة نظر.
الجغرافيا السياسية (K. Haushofer، R. Guenon، A. Dugin) ليست مهتمة بالتنمية من حيث المبدأ. من وجهة النظر هذه، هناك عوامل فقط: الموقع الجغرافي، حجم الإقليم، المناخ، الموارد الطبيعية، الخصائص الديموغرافية، الإمكانات العسكرية والاقتصادية. لقد نشأت الجغرافيا السياسية لخدمة السياسة الخارجية. كان هوشوفر هو من اقترح مفهوم المساحة المعيشية، والذي بمساعدته ألمانيا هتلر بررت توسعها الإمبراطوري. وتستمر هذه الميزة الجيوسياسية حتى يومنا هذا. إذا كان هذا يفسر أي شيء، فهو في العلاقات بين الإمبريالية، وبالتالي يخدم الطموحات الإمبريالية، وفي معارضتها للعولمة والعولمة، عادة ما يتبين أن الجغرافيا السياسية مرتبطة بتبرير القومية والشوفينية. إن التخصص والاستقطاب في العالم الذي تحكمه العولمة يؤدي إلى تراكم احتمالات الاستياء والاحتجاج، وأحد مظاهرها الإرهاب، الذي يرتبط في الأساس بتصاعد حدة الإسلام المتطرف. في الواقع، نحن نتعامل مع مشروع عولمي بديل، والذي يتم التعبير عنه في المطالبة بالعالمية العالمية، ومعيارية الحياة الاقتصادية واليومية، والتعليم، والتقليد السياسي القائم على فكرة الثيوقراطية. وتستحق أفكار الصراع الثقافي في الحضارة الحديثة اهتماما خاصا، سنوليه لها في الأقسام المخصصة للثقافة السياسية.
في بعض الأحيان تُتهم العولمة بأنها تعمل على التسوية، ليس فقط السلع والخدمات، بل وأيضاً الثقافة. ومع ذلك، مع تقدم التاريخ، يصبح من الواضح أن العولمة لا تؤدي إلى التجانس فحسب، بل تخلق الطلب على التفرد والأصالة. ويتجلى هذا بشكل مقنع في مثال الصين، ودول جنوب شرق آسيا، والهند، ومؤخراً البرازيل وجنوب أفريقيا. إن الرهان على التفرد الثقافي والتقاليد التاريخية، جنبًا إلى جنب مع تطور التقنيات الحديثة وتطور العلوم، يؤدي إلى نتائج واضحة.
والعولمة في حد ذاتها لا يمكنها أن تحرم الذاكرة التاريخية. على العكس من ذلك، فهو يخلق فرصًا للحفاظ عليه، وليس فقط تحويله إلى متحف، بل أيضًا إدراجه في التداول العالمي للاتصالات والأبحاث والاتصالات والسياحة. لقد أصبح إنشاء دولة ــ "بوتيك" فريد من نوعه ــ وسيلة متكررة حتى بالنسبة لدولة صغيرة للدخول بفعالية إلى الفضاء الثقافي والاقتصادي المعولم. وستقدم تجربة سنغافورة مثالا على خلق هوية وطنية جديدة تقوم على العديد من الثقافات العرقية والتطور البناء للتجربة الإمبراطورية.
إن التقليد الطائش للنماذج السياسية للآخرين، غير المدعومة بالتنمية الاقتصادية، أو تشكيل بيئة مؤسسية، أو تحقيق نوعية معينة من الحياة الاجتماعية، يجعل الدولة (الدولة والمجتمع) غير قادرة على المنافسة مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية. ليس من قبيل الصدفة أن حتى أكثر مناهضي العولمة اقتناعًا لم يعودوا يعارضون العولمة في المجال الاقتصادي، ويطلقون على أنفسهم اسم "مؤيدي العولمة البديلين"، ويعني ذلك ضرورة تهيئة الظروف لعبور الحدود دون عوائق ليس فقط للسلع والتمويل، ولكن أيضًا لعبور الحدود. الناس.
وفقًا لبريسر-بيريرا، فإن "اليمين الجديد" (الشركات عبر الوطنية) ينظر إلى العولمة باعتبارها فائدة، ويرى "اليمين القديم، مثل اليسار القديم" - كتهديد، و"اليسار الجديد" - كتحدي (الشكل 10.1). ).
أرز. 10.1.
من السهل أن نرى أن الداعمين الرئيسيين للعولمة هم الدوائر الاقتصادية وقطاع الأعمال. تسعى الدولة جاهدة إلى اتخاذ مكانتها الفريدة في السوق المعولمة، وتعظيم الفوائد من ذلك. وفي الوقت نفسه، يقوم ممثلو الجمهور ببناء علاقاتهم وهياكلهم فوق الوطنية.
والعلاقة بينهما من الناحية الهيكلية ("المثلث") تشبه هيكل الشراكة بين القطاعات بين قطاع الأعمال والدولة والجمهور المنظم. لذلك، من الأفضل ألا نتحدث كثيرًا عن معارضة الدفاعيات الاقتصادية للعولمة لانتقاداتها من جانب "اليمين" (الموقف الدولتي القومي) و"اليسار" (الموقف الليبرالي التضامني)، بل عن تكنولوجيا محددة لتفاعلهم. وهكذا، اقترح إي. جيدينز "طريقًا ثالثًا" في العولمة، يختلف عن الموقف المفرط في التفاؤل والموقف الانتقادي المفرط تجاه العولمة: الانتقال إلى اعتبار العولمة "من الداخل" هي المشكلة. ومن هذا الموقف، يكون دور الدولة "فوق" و"أسفل" السوق. أعلى بمعنى أن الدولة تتولى وظائف لا تستطيع الأعمال وريادة الأعمال توفيرها. نحن نتحدث عن توفير (إنشاء) فوائد غير قابلة للتجزئة مرتبطة بتنمية رأس المال الاجتماعي والبشري: "من أسفل السوق" هي البيئة والرعاية الصحية والمشاكل الديموغرافية، و"من الأعلى" هي التعليم والثقافة والحياة الروحية.
لقد أثار فهم العولمة مسألة دور الإمبراطوريات في التطور التاريخي بطريقة جديدة. والواقع أن العولمة باعتبارها فكرة الدولة العالمية كانت دائما حاضرة في التاريخ. وكانت مشاريعها و"السنونوات" و"اختبارات القلم" إمبراطوريات تاريخية، كل واحدة منها تطالب بمشروع سياسي عالمي معين.
كان مشروع العولمة هذا في القرن التاسع عشر هو الإمبراطورية البريطانية، التي غطت نصف العالم والتي "لم تغرب عنها الشمس أبدًا". لقد استنفد هذا المشروع نفسه مع بداية القرن العشرين. وتم إيقافها من قبل المشاريع الشمولية العالمية للشيوعية والفاشية.
وفقا لـ A. Kojève، فإن العولمة هي انتقال من الإمبراطوريات المحلية إلى العالمية الكاملة والتجانس، وهو نهج أقرب للسيطرة الكاملة على الطبيعة. وتفتح العولمة أيضاً آفاقاً لنشوء أخلاقيات جديدة: "الإيثار من أجل سلامة عالمية الإنسان". يمكن إرجاع جذور هذا النهج إلى علم الأحياء، ويمكن استمرار الأفكار حول الكائنات الحية اجتماعيًا، على سبيل المثال، من خلال تتبع خط التعقيد المتزايد للتنمية:
أحادي الخلية → متعدد الخلايا → كائن حي →
→ الأسرة → العشيرة (العشيرة) → المجتمع → الدولة →
→ الإنسانية.
وفي هذا الصدد، يمكن اعتبار العالم المعولم بمثابة المستوى التالي من التنظيم الذاتي وتكامل الحياة. وتستمر "اللاأنانية" الجينية للخلية في الجسد، في الفرد، في الأمة. في الواقع، يستهلك الشخص ما يتجاوز ما هو ضروري للفرد، مما يخلق فائضًا ضروريًا لتكاثر الأسرة. كما يفترض الاستهلاك العام وجود مورد لمزيد من التكامل المحتمل. من خلال إنتاج الفائض، يخلق الفرد والمجتمع، من ناحية، الموارد وآفاق تطورهما، ومن ناحية أخرى، اندماجهما في قدر أكبر من التكامل. يمكن أن تكون العولمة والإنترنت بمثابة أمثلة على هذا التطور الإضافي للطبيعة الاجتماعية البشرية.
إن العولمة في الوعي الجماهيري وفي أذهان المثقفين هي نظام جديد للسلطة والهيمنة. إن النموذج الفعلي للعولمة يختلف جذريا عن هذه الآراء.
إن العولمة الحقيقية تخلق ظروفا اجتماعية جديدة في جميع المجالات. إن الاستفادة من فوائد العولمة يعوقها الصراع بين الذوات والمجموعات، بين الذات والمجموعة، وكذلك بين المجموعات الصغيرة والأكبر. تؤثر القوة الهيكلية للعولمة على جميع طبقات الحياة الاجتماعية.
إحدى أهم المشاكل وأكثرها تعقيدًا في الدراسة الاجتماعية الفلسفية للعولمة هي العلاقة المتبادلة المستمرة بين عناصرها الوظيفية وغير الوظيفية.
وبالتالي، فإن العولمة ليست مركز قوة جديدًا غير مستكشف بعد، وليست حكومة عالمية، ولكنها في الواقع نظام جديد نوعيًا للعلاقات بين الجهات الفاعلة.
الكلمات الدالة: العولمة، الروابط العالمية، العالم المعولم، الليبرالية، الليبرالية الجديدة، ما بعد الحداثة، النظرية النقدية، الديمقراطية، ميول التدمير الذاتي، مجتمع التدمير الذاتي.
قبلة E. فلسفة العولمة(ص 16-32).
والعولمة في الوعي الجماهيري وفي فكرة المثقفين هي نظام جديد للقوة والتفوق. إن النموذج الحقيقي للعولمة يختلف عن هذه الآراء بشكل كبير.
إن العولمة الحقيقية تشكل ظروفا اجتماعية جديدة في جميع المجالات. إن الصراع بين الذوات والمجموعات، بين الذوات والمجموعة، وكذلك بين المجموعات الأصغر والأكبر، يمنع من الاستفادة من كل بركات العولمة. وتؤثر القوة الهيكلية للعولمة على جميع طبقات الحياة الاجتماعية.
واحدة من أهم المشاكل وأكثرها تعقيدًا في الدراسة الاجتماعية الفلسفية للعولمة هي الترابط المستمر بين عناصرها الوظيفية وغير الوظيفية.
وبالتالي، فإن العولمة ليست مركزًا جديدًا وغير معروف للقوى وليست حكومة عالمية، ولكنها في جوهرها نظام جديد نوعيًا للعلاقات بين الجهات الفاعلة.
الكلمات الدالة:العولمة، الروابط العالمية، العالم المعولم، الليبرالية، الليبرالية الجديدة، ما بعد الحداثة، النظرية النقدية، الديمقراطية، ميول التدمير الذاتي، مجتمع التدمير الذاتي.
أنا. عن العولمة
وفقًا للفهم الواسع المقبول عمومًا، فإن العولمة هي علم المشكلات واسعة النطاق، والتي تؤثر كل منها نوعيًا وبطريقة جديدة وملموسة بشكل متزايد على الفرد والإنسانية ككل. وبهذا المعنى، فمن الطبيعي أن يشمل مجال العولمة، على سبيل المثال، المشاكل البيئية، والمعادن، والهجرة، ومشاكل الصحة العالمية (حيث لم يعد من الممكن أن تقتصر عليها الدولة)، والاتجاهات العالمية الإيجابية والسلبية في التغير السكاني، والطاقة. الاستهلاك وتجارة الأسلحة والأزمة في مجال مكافحة المخدرات أو معضلة التكامل والاقتصاد العالمي.
هناك أيضًا تفسير آخر موسع للعولمة - وهذا ما سنتمسك به في هذا العمل - وهو لا يربط مشاكل وظواهر العولمة بقضايا "عالمية" محددة ناشئة بشكل منفصل (أو بمجموعة اعتباطية منها)، ولكن يستكشف الروابط الهيكلية والوظيفية في الوضع العالمي الجديد ككل.
أصبح المنعطف التاريخي العالمي في عام 1989 بارِزمرحلة من تطور العولمة. والسبب الرئيسي لذلك هو حقيقة أنه حتى عام 1989، أدى وجود نظامين عالميين إلى إبقاء عملية العولمة محصورة في حدود عملية محددة. وكل عنصر من عناصر العولمة تم اختياره بعناية لا يمكن أن يخرج من نظام هذه الأنظمة إلا من خلال جهود استثنائية.
نتيجة للسريع قفزة العولمة،والتي بدأت في عام 1989، تم إحياء أحد الخيارات الممكنة للعولمة، وهو الخيار المرتبط بها النظرية النقدية وأزمة الديون العالمية.وعلى هذا فإن التأثير المنتشر للعولمة لابد أن يؤثر على مشاكل النظرية النقدية وأزمة الديون العالمية.
من أهم وأصعب مشاكل الدراسة الاجتماعية الفلسفية للعولمة هو التفاعل المستمر بين عناصرها. العناصر الوظيفية وغير الوظيفيةوالجوانب التي تشبه التروس في الآلة. كلما أدركت العمليات العالمية طابعها العالمي، كلما أظهرت بوضوح خصائصها الوظيفية في أنشطتها. على سبيل المثال، كلما أصبحت البنية "العالمية" للاقتصاد العالمي أكثر وضوحا، كلما سادت التعريفات النظرية الوظيفية الأكثر وضوحا. من الناحية النظرية، العناصر الوظيفية وغير الوظيفية غير متجانسة،ولكن في الممارسة العملية هم عضويا و بشكل متجانسمتشابكة مع بعضها البعض.
ومن ثم فإن العولمة ليست مركز قوة جديدا غير مستكشف بعد، وليست حكومة عالمية؛ بل هي، في جوهرها، نظام جديد نوعيا. نظام العلاقات بين جميع الجهات الفاعلة. وتتمثل إحدى سماتها المحددة في القدرة "الديمقراطية" إلى حد ما على الوصول إلى العمليات والشبكات العالمية. ومن المنطقي تمامًا وصف الظاهرة الأساسية للعولمة باستخدام المعايير وصولو إمكانية الوصول. ومع ذلك، فإن هذا المجال يخفي جانبين من أضعف جوانب العولمة. العولمة تقضي على عدد من الاختلافات المحددة وتدمر الحدود، مما يوفر بشكل أساسيإمكانية الوصول العالمية. ولذلك، وبهذا المعنى، تعتبر العولمة "ديمقراطية": فالمشاركة في العمليات العالمية قد تمثل مفهومًا جديدًا "للمساواة". إن العولمة، التي يتضمن تطورها الديناميكي عناصر التمييز، من شأنها أن تكشف عن تناقض ليس فقط من الناحية النظرية، بل أيضا من الناحية العملية. وفي هذا الصدد، من الضروري إقامة توازن تاريخي عالمي للعولمة. وسيعتمد هذا التوازن على العلاقة النهائية بين الديمقراطية، وعلاوة على ذلك، بين المساواة في الوصول، والجوانب المميزة، أي العمليات الاجتماعية التدميرية الموجودة بالفعل في مجال نشاط هذين الاتجاهين..
المتعلقة بهذه المسألة ثانيةمشكلة ذات أهمية خاصة للقفزة النوعية في العولمة في عام 1989. وحقيقة أن العولمة تساهم في ظهور علاقات جديدة من حيث الجودة والتنوع ليست سوى وجه واحد من العملة. إن الطبيعة الجديدة نوعياً للعلاقات هي نتيجة اختفاء الوسطاء والطبقات الاجتماعية التي كانت تفصل الشخص في السابق عن المشاكل العالمية، والآن يمكن للجميع الوصول إلى الاتصالات المتعددة الأطراف في الشبكات العالمية مباشرة، أي دون أي وسطاء، مثل أي شخص. ممثل آخر . والوجه الآخر للعملة هو مسألة ما إذا كان، مع تطور العولمة، موارد جديدة حقا،قادرة على تلبية الطلبات المتزايدة الناتجة عن إمكانية الوصول. إن التقدم المظفر الذي حققته العولمة في حد ذاته يؤدي إلى زيادة في عدد الموارد، ولكن بحجم أصغر كثيراً من "حجم القدرة" المطلوب لعالم متزايد التوافر. وعدم القدرة على تلبية الحاجة إلى الوصول هو الذي يلحق ضرراً كبيراً بنظام راسخ من الاتصالات العالمية. وتذكرنا هذه التوقعات السلبية ببعض وسائل الإعلام التي تقدم تشكيلة واسعة من القنوات التلفزيونية، لكنها في الوقت نفسه مع تزايد توفرها لا تقدم زيادة نوعية في «مصادر» البرامج الترفيهية والثقافية. ونتيجة لهذا فإن كل ما يمكنهم تقديمه استجابة للاحتياجات المتزايدة هو برامج رديئة أو تكرار لا نهاية له للبرامج "القياسية" المجربة والحقيقية.
لقد أدت العولمة إلى ظهور عدد من البدائل في المجالات الأيديولوجية وكذلك الدولة والاجتماعية والثقافية ،وكل منها يحتاج إلى تفسير . من وجهة نظر نظرية العلم، فإن نظرية العولمة هي نظرية المجتمع، ومهما تم اختراع مفاهيم جديدة لم تكن موجودة سابقًا لظاهرة العولمة، فلا حاجة ولا فرصة لابتكار نموذج نظري جديد لهم.
وكما قلنا من قبل، فإن العولمة القائمة بالفعل ليست مركز قوة جديد أو حكومة عالمية، بل هي نظام نوعي جديد للعلاقات بين جميع الجهات الفاعلة، والسمة الرئيسية لها هي "العولمة"، أي القدرة على الوصول إلى عمليات وشبكات عالمية خاصة "ديمقراطية". في مجتمع عالمي معولم، تتغير العلاقة بين الشرق والغرب؛ في هذا النظام العالمي الجديد، القائم على أوجه الترابط الجديدة، تتشابك أدوار المدينين والدائنين، والفائزين والخاسرين. وفيما يتعلق برأس المال الاجتماعي، لا بد من الإشارة إلى اتجاه “الدوامة الهبوطية” التي سببتها العولمة، وهو ما يعني أن أنواع رأس المال الاجتماعي التي يستثمرها المجتمع في الأفراد يتم تقليصها نوعاً وكماً. وهذا هو في المقام الأول نتيجة أزمة المجال العام،وبناء على ذلك فإن تطوير "مجتمع المعرفة" يمكن أن يزيل هذه المشكلة. ومن الممكن أن يكشف نهج العولمة عن أوجه القصور في تلك النهج التي ظلت على مستوى التنمية الوطنية. يمكننا أيضًا النظر في اتجاهات العولمة على مستوى التعميم الفلسفي، مع الأخذ في الاعتبار الفئات كمعايير موضوع أنشطةو تحرير.
نتيجة لسقوط الاشتراكية، تولى النظام السياسي والاقتصادي النيوليبرالي موقعًا مهيمنًا، مما أدى إلى التحديد الخاطئ للنيوليبرالية والليبرالية. إن الخصائص الهيكلية والوظيفية للعالم العالمي تتشكل الآن على وجه التحديد من خلال هذا النظام النيوليبرالي. وفي مثل هذا السياق، يبرز الطريق الثالث: العلاقة غير المتكافئة بين النيوليبرالية والديمقراطية الاجتماعية.
يتم تنفيذ العولمة في العالم قيم ما بعد الحداثة. أما بالنسبة للمنهج التاريخي الفلسفي، فإننا لا نحاول تحديد الخصائص الأساسية لما بعد الحداثة من خلال مقارنتها بالحداثة. نحن نبتعد عن التعارض الواسع النطاق بين الحداثة وما بعد الحداثة، لأننا نؤمن إيمانا راسخا بأن جوهر ما بعد الحداثة يمكن الكشف عنه في علاقتها بالبنيوية والماركسية الجديدة. كانت هاتان الحركتان مهمتين بالنسبة لفلسفة الستينيات. في بعض الأحيان كانوا يكملون بعضهم البعض، وأحيانا كانوا يتعارضون. بحلول منتصف السبعينيات. توقفت الماركسية الجديدة عن الوجود فجأة كما تحدث عادة الكوارث الطبيعية، وفي نفس الوقت تقريبًا اعترفت البنيوية أيضًا بفشلها. وبدلاً من هاتين الحركتين القويتين، نشأ فراغ فلسفي، لا يعني، مع ذلك، «فراغ الفلاسفة»، أي غيابهم، إذ ظهر في ذلك الوقت مفكرون آخرون، رغم امتلاكهم السلطة السياسية، إلا أنهم لم يكونوا كذلك. لديهم نظامهم الفلسفي الخاص. لقد كان ذلك فراغا ما بعد الحداثةمكتملة بنجاح الفلسفة. ويترتب على ذلك أن الفلسفة الحديثة تقع تحت التأثير المهيمن المزدوج لما بعد الحداثة والليبرالية الجديدة-الوضعية الجديدة. الأهم تناظربين هذين الاتجاهين - في محاولة لإعادة ترتيب عملية التفكير بأكملها من خلال تنظيم عمليات تكوين المفهوم وبنية الكائن. لكن استراتيجياتهم تختلف: تطرح النيوليبرالية-الوضعية الجديدة التحقق الاختزالي باعتباره مطلبها الرئيسي، في حين تعتبر ما بعد الحداثة التحقق غير مقبول. ومع ذلك، فإن كلا الاتجاهين لهما ميزة مشتركة أخرى: الحد من نطاق قواعد التحقق الفلسفي، وكذلك استبعاده الكامل، لا يتم تنفيذه في إطار الخطاب الذاتي الحر، ولكن في بيئة التأثير بين الأشخاص.
إن التقدم الذي لا يمكن إنكاره للعولمة هو عنصر من عناصر تطور العقلانية الحديثة. ومع ذلك، لا يمكن إعادة بناء المسار الواضح لتطور العقلانية الحديثة دون ذكر التحرر، الذي له أيضًا أهمية تاريخية هائلة. إن الترشيد و"الصحوة" و"ديالكتيك التنوير" يجب أن تظهر في سياق جديد. كما ينبغي طرح مفهوم التحرر في الخطاب التاريخي والفلسفي لـ "الوداع" التاريخي العالمي للأساطير. كل انتقادات العقلانية الحديثة كانت مبنية على التحرر، وهو ما لم يحدث، على الرغم من أن الحاجة إليه نمت بالتوازي مع تطور العقلنة. إن استبعاد التحرر قد يشكل تهديدا خطيرا لعملية الترشيد والعولمة.
إن الارتباط بالحداثة بالمعنى التاريخي والفلسفي له أهمية حاسمة ليس فقط من وجهة نظر الأعداء المحتملين وصورة العدو. بالمعنى الإيجابي، فهو أمر حاسم، منذ ذلك الحين وفي بعض الجوانب المهمة، تتجه العولمة التي انبثقت بالفعل من تربة الحداثة، إلى محو أهم إنجازات الحداثة في الوقت الراهن.. يشير هذا إلى الاصطدام بين النوع الديمقراطي الاجتماعي الموحد لتطور دولة الرفاهية والتدمير النيوليبرالي الموحد لهذه الدولة. ونتيجة لهذا فإن السمة الأساسية الأكثر نموذجية للعالم الحديث ليست العولمة أو التكامل في شكله النقي، بل العولمة أو التكامل الذي يتحدد من خلال الديون العامة التي تميز كل البلدان.
إن دوامة رأس المال الاجتماعي الهبوطية هي أيضًا نتيجة لبنية العولمة هذه على وجه التحديد، وبالتالي فإن هذه الظاهرة هي أيضًا ذات طبيعة عالمية. ونحن لا نسعى إلى استبعاد "قصص النجاح" العديدة ــ الإنجازات الحضارية المبهرة التي حققتها العولمة. لكن الخصائص الهيكلية للعولمة التي ظهرت بالفعل في الوقت الحالي هي على وجه التحديد السبب وراء ذلك تصاعديدوامة من الإنجازات الكبرى و تنازليدوامة رأس المال الاجتماعي لا تتقاطع. فالعنصر المعرفي الذي ينطوي عليه الإنتاج الحديث هو جزء من المفهوم الأوسع لرأس المال المعرفي، في حين أن رأس المال الاجتماعي المستثمر في الأجيال اللاحقة لا يعاد إنتاجه على مستوى الحضارة الإنسانية. وهذا يعني ذلك أيضًا المستقبل يجب أن يصبح ساحة معركة بين الحضارة والهمجية،حتى لو لم يكن أي من تعريفات هذه المصطلحات يشبه المفاهيم الموجودة حتى الآن حول الحضارة والبربرية.
هناك عنصر مهم آخر في النظام الجديد في السياسة الدولية ("النظام العالمي الجديد")، وهو التفسير الجديد لمفاهيم "الهوية" و"الاختلاف". بحلول عام 1989، كان المنطق النيوليبرالي في فهم هذه المصطلحات قد حل محل المفاهيم الاشتراكية والمسيحية الأساسية للهوية والاختلاف. هذا يعني، أنه لا التضامن الاشتراكي ولا الحب الأخوي المسيحي يمكن أن يقلل من قوة الاختلاف التي لا هوادة فيها. الهوية النيوليبرالية ليست أكثر من احترام وضمان غير مشروط لحقوق وحريات الفرد (الذي يمكن أن تصبح حقوقه مجرد إجراء شكلي في سياق وجود عدد معين من الاختلافات الاجتماعية). في حالات كهذه فالاختلاف ليس مجرد اختلاف أو قيمة أو أيديولوجية، بل يمكن أن يصبح سمة هامة للوجود الاجتماعي.
وفي إطار هذا المفهوم، من المهم أيضًا تحليل الروابط القائمة بين العولمة والسياسةكأنواع خاصة من الأنشطة الاجتماعية أو الأنظمة الفرعية. وتنشأ هذه الحاجة من حقيقة مفادها أن السياسة اليوم، بالمعنى الدقيق للكلمة، تختلف عما كانت عليه قبل بضعة عقود. لكننا لن نفعل ذلك، لأن السياسة والنظام الفرعي السياسي والطبقات السياسية، على ما يبدو، ستأخذ مكانها تدريجيا في نظام العلاقات العالمية (وفي الاقتصاد العالمي الجديد). وهذا يعني أنه مع مرور الوقت، سيصبح من الممكن إجراء دراسة أكثر شمولاً للمجال السياسي (das Politische)، دون الحاجة إلى سرد جميع الإحداثيات الجديدة لتاريخ العالم.
ملامح الديمقراطية- قضية أساسية للعولمة واقتصاد عالمي عالمي جديد ونظام سياسي جديد يتكيف تدريجياً مع الإحداثيات الجديدة. بادئ ذي بدء، هذا سؤال المهامو الهياكل. ربما يكون هذا هو ما ينبغي أن يكون، حيث لا يمكن تنفيذ الأنشطة العالمية وتطويرها إلا على أساس الليبرالية الديمقراطية أو الديمقراطية الليبرالية. وبهذا المعنى فإن الديمقراطية الليبرالية هي "الطريقة المؤقتة" للعولمة.ولكن الخصائص الوظيفية والبنيوية للعولمة لابد أن تذكرنا بالحقيقة مكونات القيمةالديمقراطية الليبرالية، التي ضمنت الشرعية الحصرية للنظام السياسي قبل أن تتشكل المجالات الوظيفية والهيكلية بالكامل.
لقد امتد الطابع الديمقراطي للمجال السياسي إلى عدد من الوظائف الجديدة التي لا تزال غير واضحة. لقد خرجت القيم الديمقراطية من عالم القيم وتحولت إلى بنية ووظائف.
تواجه الديمقراطية الليبرالية ككل تحديات جديدة ومعقدة وغير معروفة في بعض الأحيان.. أولا، إنها الأساس الوظيفي والبنيوي للعولمة، وثانيا، علاقة العولمة تفرض الديمقراطية الليبرالية في مواجهة مشاكل لم تكن معروفة من قبل. تقوم الديمقراطية الليبرالية الآن على أفكار مختلفة، ويتوقع منها نتائج مختلفة، لكن التعريف الأساسي لا يتغير.
النموذج الحديث للعالم يعني ناضجةشكل من أشكال العولمة، السمة المميزة لها (من بين مفاهيم مهمة أخرى) هي الظاهرة الدين الحكوميتحديد الحدود الاقتصادية والسياسية للعولمة بشكل أساسي ولعب دور حاسم في تشكيل الخصائص النقدية العميقة للعولمة الحديثة. هذا هو النموذج العام الذي تجري ضمنه عملية توسعة الاتحاد الأوروبي واسعة النطاق. هذا التنوع في الوظائف يؤدي إلى حقيقة ذلك فحتى غياب النظرية له عواقبه السلبية،على الرغم من أنه من غير المرجح أن تصبح هذه القضية المركزية للمناقشة.
يرتبط أحد أكبر تحديات المستقبل بالمشكلة تنص على. ونقطة البداية هنا هي العلاقة بين العولمة والدولة القومية؛ إن الوعي السياسي العام مطلع على التوترات الجديدة وقضايا الشرعية الناشئة في هذا المجال. ومن وجهة نظر الدولة، هناك عنصر لا يقل أهمية وهو تنظيم العمليات السياسية والاقتصادية، التي تكون نتائجها ذات أهمية كبيرة. ومن الخصائص المهمة للمستقبل (ومجموعة القضايا التي يجب معالجتها) هو ذلك فالدولة ليست جهة فاعلة محايدة تمتلك خصائص وظيفية حصرية،لا سيما مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه بعد عام 1945، أخذت الدولة الحديثة على عاتقها المهام الحضارية وجميع المهام الاجتماعية تقريبًا على نطاق غير مسبوق، ولم يكن معروفًا تمامًا من قبل، ولا يمكن لمثل هذه المهام أن تنشأ إلا خارج الدولة، التي "اهتزت" حدودها. تحت تأثير عمليات العولمة التي دمرت "مساحات" كاملة من الشبكات الاجتماعية. وفي هذه الحالة تخسر الدولة.ولكن هناك اتجاه آخر، أصبحت علاماته واضحة بالفعل في العمليات العالمية الحديثة. وبالتالي فإن هناك بالفعل دولاً (وطنية) ناجحة تمكنت من الاستفادة من إنجازات العولمة وحتى التكامل من أجلها تحقيق أهدافهم الحقيقية كدول قومية،فضلا عن رغباتهم المنسية منذ زمن طويل في توسيع الدول القومية.
وقد استفادت هذه الدول إلى حد كبير بالفعل من توسع الاتحاد الأوروبي، والذي يمكن النظر إليه بطبيعة الحال باعتباره عملية من عمليات العولمة. إن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يصرف الرأي العام وأنظار الباحثين عن الأهمية الاستثنائية لوظائف دولة المستقبل، في حين أن الانحدار المطلق والنسبي للدولة، التي ركزت، لأسباب تاريخية، جميع الوظائف الاجتماعية والحضارية، تتجلى في صعوبات عملية محددة.
الجانب الفاعلبشكل عام - عنصر جديد ومثير للاهتمام في العولمة. ويمكن استخدام هذا المصطلح أيضًا لوصف الواقع السياسي والاجتماعي لعصر ما قبل العولمة. إلا أن العولمة تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ هذا المفهوم بشكل رئيسي بسبب فهو يحرر الجهات الفاعلة الفردية من العلاقات التنظيمية والأولية للكيانات السياسية والاجتماعية الأكبر،خاصة المنظماتوبالتالي ينظم عالم الممثلين بطريقة جديدة. وهذا يعني أن كل شخص هو في النهاية ممثل، وهذا ليس مجرد تلاعب بالكلمات. نحن فاعلون بالمعنى النظري والعملي، على الرغم من أننا لا نزال نربط هذا الجانب الجديد من العولمة بالاستبداد "الاستبدادي" الموجود حاليًا وليس بالمكونات الديمقراطية الموجودة أيضًا. وبطبيعة الحال، فإن كل ظواهر العولمة لها جوانبها الفاعلة، حتى مشكلة العلاقات مع البلدان النامية.
لكن الجهات الفاعلة في العولمة تنسحب في كثير من الأحيان، وهذا واضح للعيان عند مقارنة الوظائف العالمية المحددة الجديدة. تنشأ حالة غياب الجهات الفاعلة عندما تتشكل وظائف مهمة جديدة، في سياق العمليات السياسية أو غيرها من عمليات العولمة، ولكن لا توجد جهات فاعلة قوية ومسؤولة وشرعية بنفس القدر قادرة على تولي تنفيذ هذه الوظائف. بطبيعة الحال، في مثل هذا الوضع الأولي، يتم "توزيع" أماكن الممثلين بشكل غير صحيح: فإما أن الأماكن الفارغة ووظائف الممثلين الغائبين تمر دون أن يلاحظها أحد، أو أن مجموعات المصالح التي تتفاعل بسرعة تملأ هذا الفراغ، مما يشوه الفضاء السياسي بشكل خطير. النموذج الأساسي بسيط: لا يمكن وصف مجموعة المصالح التي تملأ الفراغ إلا بالفاعل بمعنى واحد محدد، أي بمعنى أنها تسعى حصريًا إلى تحقيق مصالحها الخاصة. ولتحقيق هدفها، يجب عليها، إلى حد ما، تشكيل الفضاء السياسي، ولكن بما أنها لا تفعل ذلك باعتبارها جهة فاعلة مشروعة وبناءة، فإن أنشطتها تعني حتما تدمير الفضاء السياسي.
ثانيا. النظرية النقدية والليبرالية
منذ انتصارها عام 1989، كانت الليبرالية (بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولا تعتبر بالمعنى الضيق كحزب) موضوعًا "أبديًا" لمناقشات العلوم السياسية والسياسية. إن هيمنة الليبرالية، بمعنى أولوية بعض الاتفاقيات الجديرة بالاهتمام، تشكل مشروعاً فعّالاً، حتى لو تم توجيهها بشكل خاطئ عن غير قصد (وفي بعض الأحيان عن قصد)، كما يتبين من المناقشة الدائرة حول فرانسيس فوكوياما. أحد المفاهيم الخاطئة هو صورة الليبرالية كحزب سياسي، على الأقل بالمعنى الإيديولوجي (وهو ما يمكننا أن نقول بثقة أنه لم يفز بعد من الناحية التاريخية العالمية). الاتجاه المفضل الآخر الذي يهمنا هو المبرر الوحيد والأساسي لما يحدث اليوم. يؤكد كلا الاتجاهين الخاطئين على مجموعة متنوعة من استراتيجيات التحييد ذات الدوافع الواعية وغير المحفزة، والتي تهدف إلى أخذ هذه الحالة المعزولة من انتصار الليبرالية إلى ما وراء حدودها المتأصلة. قليلون يعتقدون أن استراتيجيتي التحييد هاتين قد تخدمان أغراضًا مختلفة. قد يكون أحد هذه الأهداف هو تحييد سمات الهيمنة الجديدة، والتي على أساسها يمكننا، على سبيل المثال، بناء مطالب ليبرالية وديناميكية لعالم الليبرالية المنتصرة الجديد.
إلا أن هذا التحييد النسبي لتفسير معنى ودلالة أحداث 1989 لا يؤدي على الإطلاق إلى خسارة موجودالليبرالية لأهميتها كقاسم مشترك وموضوع لنقاش واسع طوال كل هذه السنوات. الليبرالية تظهر في كل الأمور، وفي المناقشات الحديثة تمثل كل القيم. في مثل هذه الحالة، يتم خلط المواقف الوصفية والمعيارية أو النسبية باستمرار. نحن ننتقد الاقتصاد والسياسة اليوم لكونهما "ليبراليين" بينما نأمل سرًا في الوقت نفسه أن ينظر الفاعلون ذوو العقلية "الليبرالية" إلى الاقتصاد والسياسة. الحاضر. ومن ناحية أخرى، فهذا يعني ضمنيًا أيضًا أننا نتحمل المسؤولية المحتملة عن الجانب السلبي من النظام، والذي يُعرف بأنه اقتصادي ليبرالي أو سياسي ليبرالي.
من وجهة النظر النظرية والعملية، فإن أكبر مشكلة في النقاش العلني أو السري الحديث حول الليبرالية هي على وجه التحديد المؤسسات الواسعة الانتشار التي جاءت مع الليبرالية (أحيانًا في شكل الليبرالية الجديدة) في إطار ما يسمى بالليبرالية. النظام الاقتصادي النقدي.ونحن نود أن نعارض مثل هذه المحاولة للاندماج، خاصة عندما يتعلق الأمر بوضوح المفاهيم. ومن الواضح أنه على الرغم من أن هذا الاهتمام هو في المقام الأول ذو توجه نظري بحت، إلا أن له أيضًا أهمية عملية واضحة لا يمكن إنكارها، حيث يمكن القول بثقة أنه في كل فترة تاريخية، يكون لإسناد جديد للغة السياسية بالضرورة تطبيق عملي واضح ( على سبيل المثال، ليس من المستغرب أن يطلق بعض "اليمين الجديد" على أنفسهم اسم "الجمهوريين" أو "الليبراليين"). ومع ذلك، فإننا لا نحاول أن نكون أصوليين هنا؛ فنحن واضحون تمامًا أن اللغة السياسية الرسمية لا يمكنها أبدًا تلبية جميع المتطلبات النظرية والتاريخية. في مثل هذا السياق، متطلبنا هو أن يعكس المبدأ السياسي النظري على الأقل ارتباطًا واضحًا بالأيديولوجية الأساسية أو الجوهر الأساسي للحركة السياسية أو المفاهيمية ذات الصلة.
إن أي إضعاف لليبرالية الكلاسيكية يتحول على الفور إلى مشكلة كبيرة. وعلى الرغم من البساطة الواضحة والشفافية التي تتسم بها الأحكام الأساسية لليبرالية، فإن هذا ممكن، لأن الليبرالية هي مزيج من العديد من "الحريات". في عام 1911، اعتبر إل تي هوبهاوس أن "الحريات" التالية هي عناصر الليبرالية التي تحدد فهمها الصحيح: "المدنية"، "المالية"، "الفردية"، "الاجتماعية"، "الاقتصادية"، "المحلية"، "المحلية" "،" الحريات "العنصرية" و"القومية" و"الدولية" و"السياسية" وكذلك "سيادة الشعب". في الواقع، الليبرالية فعالة تحت ضغط الحاجة المعقولة لتحقيق أو حماية جميع الحريات. لذلك، من الخطير للغاية دائمًا أن تتحول الحركات والمفاهيم التي تصنف نفسها على أنها "ليبرالية" إلى "اختزالية" في فهمها للحرية. علاوة على ذلك، فإن السؤال ليس ما هو مقدار الحرية أو الحريات "الأكثر" أو "الأقل" المطلوبة حتى يمكن وصفها بأنها "ليبرالية". بل السؤال هو أنه حتى التدهور الطفيف في جودة أو تقليص نطاق الحريات التي يؤمن بها الناس يؤدي إلى حقيقة أن الإيمان العام بالليبرالية كشيء "ليبرالي" يبدأ في التذبذب. أيإن إضعاف الليبرالية له تأثير مهم على مفهومها بأكمله. ومن هذا المنطلق فمن المنطقي افتراض ذلك خاصإن تبسيط الليبرالية/الليبرالية الجديدة إلى إطار النظام النقدي أمر غير مناسب. قبل أن نحدد هذه الظاهرة الجديدة، والتي تُفهم تحت مصطلح "النزعة النقدية"، سيكون من المفيد أن نحلل الليبرالية بإيجاز باعتبارها اتجاهًا سياسيًا و"نقطة تبلور" للأحزاب السياسية. إن مفتاح أي ليبرالية يكمن في الأيديولوجية الأساسية، والتي يتم التعبير عنها بشكل مناسب في أطروحة "اللعب الحر للقوى الحرة". أحد جوانب هذه القضية هو أن هذه الأطروحة تاريخياكان يعني لكل ممثل مهتم بالليبرالية السياسية كيف يرتبط هذا المفهوم بأفكار ذلك الوقت حول العالم، وما هي الأفكار التحررية العالمية حول النظام التي كانت هذه الفكرة مرتبطة بشكل لا ينفصم. جانب آخر مهم جدًا لهذه القضية هو أن تلك الأفكار أو المفاهيم أو المجموعات السياسية التي تظل مخلصة نسبيًا لأسس هذه الأيديولوجية الأساسية هي فقط التي يمكن أن تسمى ليبرالية بشكل شرعي.
ليس هناك شك في أن مصير الليبرالية كحركة سياسية يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان سيتم اتباع الأيديولوجية الأساسية بدقة أم لا. ومع ذلك، يمكننا أن نقول بنفس القدر من الثقة أنه كلما اقترب المسار السياسي أو الأيديولوجي الليبرالي من الواقع المقابل، كلما أصبح من الصعب عليه أن يظل ملتزمًا بالأفكار الأساسية. إن الوضع الذي نلاحظه في كثير من الأحيان يسمح لنا برؤية أن الليبرالية تتغلغل دائمًا بشكل أعمق في المؤسسات السياسية والاجتماعية، لكنها في الوقت نفسه، كمجموعة مستقلة، تفقد أهميتها وتأثيرها على الجماهير. وهذا ما يفسر أسباب اختفاء الليبرالية من المشهد لبعض الوقت باعتبارها مشاركًا سياسيًا مستقلاً موحدًا رئيسيًا: سياسي(لم يناضل الليبراليون من أجل توسيع كبير للاقتراع العام) و الاجتماعية(لقد تم دائمًا اتخاذ خطوات لتطوير التنظيم السياسي، لكن الأساس الاجتماعي لمثل هذه الحركة السياسية المستقلة قد تضاءل). بالإضافة إلى ذلك، قامت الليبرالية بإثراء الاتجاهات الأخرى بأفكار سليمة ومهمة، والآن لم يتم تقليص القاعدة الاجتماعية فحسب، بل أيضًا القاعدة الفردية المثلى لحزب سياسي ليبرالي مستقل بشكل كبير. إن التأكيد الجيد على أن البديل الليبرالي المستقل في السياسة يتقلص باستمرار هو حقيقة أنه بعد الاضطرابات التاريخية الأكثر فعالية وعظمة، تعود الليبرالية دائمًا إلى الظهور على الساحة السياسية في أول فرصة؛ وهذا يعني أيضًا أنه في العصور التاريخية "العادية" وفي فترات الانحدار، تتمتع الليبرالية النامية دائمًا بفرصة أكبر للتجديد على وجه التحديد في ظروف الاضطرابات الكبيرة جدًا.
نأتي الآن إلى المشكلة الأكثر صعوبة في الليبرالية الحديثة. وهذا، كما قلنا سابقًا، هو في الأساس ليبرالية التجديد. ولذا نود أن نلفت الانتباه مباشرة إلى الخلفية. عمليات السبعينيات والثمانينيات. أظهر موقفًا مختلفًا تمامًا: لم يتم تشكيل أيديولوجية ليبرالية جديدة فقطبعد انهيار نظام كبير آخر منظم بشكل مختلف، ولكن بالفعل، بمعنى ما، خلال فترة تراجعه، على غرار انهيار الإمبراطورية الرومانية الأخيرة وتطور وانتشار المسيحية المبكرة. من بين أمور أخرى، تشرح هذه التجربة التاريخية كيف يمكن أن تحدث أهم التبسيطات حتى الآن للأفكار الليبرالية الأساسية في إطار نظام "نقدي" موثوق به في سياق مقارنة بسيطة إلى حد ما بين نظام الليبرالية ونظام النقد.
قبل أن نبدأ في وصف مفهوم النظرية النقدية المستخدم في هذه الدراسة، يمكننا مقارنة الخصائص الرئيسية لهذه الأنظمة من منظور تاريخي عالمي. لقد كانت الاشتراكية القائمة بالفعل في السبعينيات والثمانينيات على وجه التحديد هي التي تبين أنها الموضوع المركزي الذي تعارضه الحركة الكلاسيكية. سياسيالليبرالية مع حقوق الإنسان والتي نشأت على النقيض من الوطنية، إذا تحدثنا بالمعنى الضيق، "النقدية" (اقرأ - أكثر اقتصادا) ، أدت إعادة التوزيع، والليبرالية المتجددة، وفقدان الأرض، إلى إنشاء هذا النظام النقدي العالمي الجديد، الذي يجمع بين مفهومين أصليين لا يوجد بينهما أي شيء مشترك تقريبًا. لقد تمكنت ليبرالية حقوق الإنسان والليبرالية الواضحة للقيود النقدية والمنظمة الجديدة الموجهة ضد إعادة التوزيع المركزي من العمل كوجهين لعملة واحدة، ولكن تحت تأثير الاشتراكية الحقيقية غير التنافسية بشكل واضح، وأجبرت على الدفاع عن نفسها مع الأخذ في الاعتبار موقعها الحقيقي في نظام الإحداثيات للواقع الجديد، أكثر من تأثير المناقشات الكلاسيكية والاقتصادية والسياسية التأويلية حقًا. ومن السهل إثبات العكس. فقط في السياسة الغربية يمكن لليبراليين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان أن يجدوا أنفسهم في معارضة القيود النقدية. وليس من المستغرب أن يتم تنفيذ مثل هذه السياسات الاقتصادية في الغرب من قبل السياسيين اليمينيين المتطرفين والمحافظين. كان نظام إضعاف الاشتراكية الحقيقية في حد ذاته مساحة سياسية لم تتمكن الليبرالية، التي انتقدت إعادة توزيع الدولة، من تشكيلها بشكل مباشر بسبب التنافر المعرفي مع ليبرالية حقوق الإنسان الكلاسيكية، على أساس أنه لم يتم تنظيم الأول ولا الثاني بشكل ليبرالي، وأن هذا بالضبط وفي إطار هذا النظام، أدى انتقاد إعادة التوزيع المركزي القوي للغاية (بالمعنى الاقتصادي) في حد ذاته إلى ظهور أفكار ليبرالية كلاسيكية حول "اللعب الحر للقوى الحرة". الاشتراكية الحقيقية لم "تسيء تفسير" هذا الوضع الجديد، بل ببساطة لم تعترف به، ولم تلاحظ أن مجرد وجوده جعل من الممكن إعادة تجميع القوى والأيديولوجيات بشكل استراتيجي كبير.وخلقت باستمرار حالات سابقة، والتي كانت في كل مرة تدعم بشكل مثالي البنية الجديدة (استنادًا إلى التوحيد العرضي لكلا الليبراليتين). وهكذا فشلت الاشتراكية الحقيقية في إظهار بعض عناصر مفهومها التي كانت تتعارض تماما مع الأيديولوجية الجديدة. على سبيل المثال، لم يعكس نموذجها المفاهيمي حقيقة أن الاشتراكية قد فهمت بالفعل بعض حقائق اقتصاد السوق، ولا الوضع الذي لا يمكن أن تتناسب فيه الاشتراكية مع هذا الواقع.
وهكذا، فإن ليبرالية ما بعد الشيوعية ذات التاريخ العالمي، والتي تحتفظ بقوتها، جمعت بين عناصر الليبرالية الكلاسيكية والليبرالية النقدية.ومع ذلك، فإن تطوير الأفكار الأساسية لم يقتصر على هذا. واليوم، أصبح الجمع بين الوصف الليبرالي للواقع السياسي والاجتماعي مع الوصف النقدي لنفس المجالات ظاهرة واسعة الانتشار في جميع أنحاء العالم، وهذا هو التبسيط الأكثر إشكالية لليبرالية حتى الآن. إن المقارنة الضمنية بين الليبرالية والمدرسة النقدية لا تنطوي على تفسير رسمي غير صحيح فحسب، بل إنها مضللة للغاية أيضا.
لكن قبل أن نبدأ في انتقاد مثل هذه المقارنة لا بد من توضيح ما نعنيه في هذا المقال بالنقدية أو النظام النقدي. وعليه، فإن هذا يعيدنا إلى النظام الاقتصادي (وبالدرجة الأولى النظام المالي والاقتصادي)، الذي ليس له تعريف أيضاً.
ونعني بالنقدية تماسكًا متجانسًا النظام السياسي والاقتصادي،والتي تنتشر بالتساوي وعلى نطاق واسع (وإن لم يكن عالميًا) من خلال الديون الداخلية والخارجية للدول، مما يؤدي إلى تشكيل نظام سياسي ديمقراطي ليبرالي وهيمنة قيم ما بعد الحداثة في عالم الناس.
علاوة على ذلك، سوف نفهم من خلال النظرية النقدية هذا بالضبطوهو النظام الذي تم قبول أنه يمكن تصنيفه بشكل عام على أنه ليبرالي. بالإضافة إلى ذلك، ويجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار أولاً، لم تتبع القوى السياسية "الليبرالية" في ذلك الوقت سياسة اقتصادية أكثر صرامة للقيود النقدية، حتى عن طريق الصدفة، ناهيك عن حقيقة أن المحافظين الراديكاليين الواعدين شنوا ثورة النضال الأيديولوجي ضد أي إعادة توزيع للدولة كأيديولوجية "يسارية" وفي الوقت نفسه نسيت تمامًا أن العديد من الطبقات الاجتماعية وعناصر إعادة التوزيع هذه لم يتم البدء بها وتنفيذها من قبل أيديولوجيين "يساريين" سريين، ولكن من خلال الاحتياجات السابقة لما يسمى. المجتمع الاستهلاكي. من المثير للدهشة، من وجهة نظر الاقتصاد الحديث، عدم وجود تناقضات كبيرة وعميقة بين القيود النقدية وإعادة التوزيع الحكومي؛ فهذه الجوانب لا تعمل كمعارضين، بل كمفهومين رئيسيين متسقين للسياسة الاقتصادية. ليس أقل إثارة للدهشة (وهذا ناتج عن المقارنة الحديثة بين النظرية النقدية والليبرالية، والتي بالنسبة لنا هي التبسيط الحديث الرئيسي لليبرالية) هو أن ر. ريغان وم. تاتشر، المضطران إلى استخدام هذا المفهوم باستمرار، يظهران للجميع على أنهما الليبراليين. إذا واصلنا تقديم حجج مماثلة، يمكننا تبرير الجانب الآخر. بعد كل شيء، في ذلك الوقت لم يكن هناك فقط نقديون لم يكونوا ليبراليين، ولكن أيضًا ليبراليين لامعين احتجوا على المدرسة النقدية (من بين آخرين، يمكن الاستشهاد بـ F. von Hayek كمثال).
إن حقيقة أن النظام السياسي والاقتصادي المهيمن الحديث ليس له اسم أمر خطير، وهذا أمر واضح. هذا يذكرنا جدا التغوطروبرت موزيل (أي النمسا-المجر)، الذي لم يكن له اسم واختفى فعلياً. وبطبيعة الحال، وبصرف النظر عن الاسم، فإن هذا النظام السياسي والاقتصادي العالمي موجود بالتأكيد كوحدة، ولكن لا يُنظر إليه على هذا النحو. وهي تتجلى كل يوم في أنشطتها كوحدة، على الرغم من أن هذه الوحدة معترف بها حاليًا وتوصف بأنها عملية عولمة. ومع ذلك، فإن عدم وجود اسم يؤدي إلى تصور عام بأن عامة الناس ينظرون إلى الوضع الحالي على أنه "طبيعي" و"غير مثير للمشاكل" بشكل عام. وفي نهاية المطاف، فإننا نشهد في الواقع أوضاعاً اقتصادية "طبيعية" وسياسات "طبيعية"، وهي الأكثر طبيعية التي يمكن تخيلها، أو على وجه التحديد الديمقراطية الليبرالية. يبدو النظام النقدي هنا خاليًا من أي مشكلة على الإطلاق، دون أي شك معقول. في هذه المرحلة، بالطبع، لن نقوم بتحليل النظام النقدي في حد ذاته. نريد فقط أن نلفت الانتباه إلى حقيقة أنه في مثل هذا التصور للنظام النقدي على أنه "طبيعي" يتم أيضًا تجاهل المقارنة غير المناسبة بين النظام النقدي والليبرالية. من المستحيل سرد جميع الأسباب والحجج هنا. وتظل الحجة الأكثر أهمية، كما هي الحال دائما، مختلفة: فالنظام النقدي بعيد كل البعد عن المكونات الثلاثة للفكرة الليبرالية الأساسية ("اللعب الحر للقوى الحرة")، حتى أن مصطلح "الليبرالية" يتبين أنه مجرد خداع كامل. يحد النظام النقدي إلى حد كبير من الحيز الاجتماعي للمناورة (إن لم يكن يدمره بالكامل)، وفي العديد من مجالات التنظيم الاقتصادي يقدم مركزية مفرطة، بحيث لم يعد من الممكن اعتباره جزءًا من المجال الليبرالي. ومرة أخرى، يفتقر مفهوم الدولة ضمن هذا النظام إلى الجوهرية. ومن خلال تقليص وظائفه الاجتماعية في كل الاتجاهات، يعمل النظام النقدي على تعزيز البيروقراطية في كافة المجالات المالية والاقتصادية المهمة، وهو ما لا يحدث أبدًا في الديمقراطيات "العادية".
في سياق التخفيضات في الضمان الاجتماعي، من الضروري أن نتذكر فرقا مهما: رسميا، لا يتم تخفيضه بسبب الديون من قبل النظام النقدي؛ جوهرها يكمن في حقيقة أن النظام النقدي يريد تدمير الكثيرين المحظوراتأو المساهمة في القضاء عليها . ويمكن أيضًا تفسير تدمير بعض الإنجازات الاجتماعية، من ناحية، على أنه ظاهرة مالية ومالية، ولكن من ناحية أخرى، فإن الظواهر المعنية اجتماعية المحظورات,ظلت سارية منذ ألفي عام من تاريخ الحضارة الأوروبية، وبعضها ساري المفعول منذ عام 1945 كحظر للمجتمع الصناعي الجديد والديمقراطية الأوروبية ما بعد هتلر كنظام جديد. أزرقكشرطعدم(شرط لا غنى عنه) للوجودالمجتمعات الغربية. بعد هذا التحليل، يمكننا أن نلقي نظرة مختلفة تمامًا على مصطلح "القضاء على الإنجازات الاجتماعية الإضافية"، في هذا النشاط لتدمير المحظورات، ولا يمكننا النظر بجدية في الحاجة إلى تعريف الليبرالية، لأن الليبرالية تفهم دائمًا الأيديولوجية الأساسية لـ "اللعب الحر". للقوى الحرة" بمعنى التحرر.
وإلى ما قيل بالفعل، يمكننا أن نضيف ذلك بالكامل يتم تنقيحهاالمجال السياسي برمته. في عالم النظام النقدي، يتم تخفيض قيمة النظام الفرعي بأكمله للشخصية السياسية بشكل جذري. السياسي هو شخص يمكنه، بلا شك، أن يعد بالكثير قبل الانتخابات، لكن ليس لديه أي فرصة تقريبًا لكسر نشاط النظام النقدي بأكمله بمفرده؛ وتتمثل مسؤوليتها الأكثر أهمية وصعوبة في الاختيار الديمقراطي للمنطقة التي ستخضع للتدابير التقييدية التالية. يبدو لنا أن مثل هذه التحولات لشخصية سياسية ليست بأي حال من الأحوال ظاهرة تستحق أن يطلق عليها اسم الليبرالية. هناك تناقض خطير آخر بين الأيديولوجية الأساسية الليبرالية والنظام النقدي الكبير، وهو أنه في حين أن "اللعب الحر للقوى الحرة" (الذي على أساسه ينشأ نظام فعال حقًا) يمكن التنبؤ به بشكل أساسي، فإن النظام النقدي "الحر" أثناء إن الفترات البالغة الأهمية من التدخل الواعي والعشوائي (بمعنى كارل شميت) تعتمد إلى حد كبير على القرارات السياسية. الفرق كبير جدًا ومهم لدرجة أنه لم تتم مناقشة أهميته النظرية. إن التدخل الحاسم، الذي له أهمية حاسمة، سوف يؤدي إلى مشاكل عميقة في نظرية الديمقراطية في المستقبل القريب، حيث يجب علينا في النهاية أن نأخذ في الاعتبار أيضًا من يقوم بهذا التدخل وعلى أساس أي حق اجتماعي وديمقراطي. وأخيرا، من وجهة نظر النظرية الديمقراطية، بالنسبة لمثل هذا التدخل "الاستثنائي"، لا يكفي أن يتحدث متحدث موهوب في وسائل الإعلام المؤثرة عن مدى خبرته ومتخصصه "الجيد"، وأنه يستطيع ذلك. وبناءً على ذلك، اتخاذ قرارات مشروعة بشأن القضايا والمشكلات الحالية.
ومع ذلك، وبالنظر إلى مثل هذه الحقائق، يعتقد العديد من منتقدي النظرية النقدية الصادقين والسطحيين إلى حد ما أن المدرسة النقدية ليست ديمقراطية حقًا. ومرة أخرى نعود إلى نقطة البداية الخفية التي ذكرناها من قبل: بالنسبة للنظام النقدي، تظل الاشتراكية الحقيقية، أو ما يسمى بالشيوعية، مشروعة، لأنها تثبت مرة أخرى أن التعايش بين الليبرالية السياسية الديمقراطية والليبرالية النقدية المقيدة يمكن أن يكون له بعض "المعنى". للاشتراكية القائمة. وفقط بالنسبة لشرعية النوع «الليبرالي» لا نجد دليلاً يذوب كالثلج في ظل أبسط الانتقادات. وبطبيعة الحال، يمكننا أن نتصالح مع حقيقة مفادها أن "الليبرالية"، مثل العديد من المصطلحات السياسية الأخرى، غامضة وغامضة وبلا حياة. ومع ذلك، بالنسبة لكل مصطلح، يجب أن نفكر في الحد الأدنى من الوحدة والارتباط مع الأيديولوجية الأساسية، وفي هذه الحالة يكون الأمر أكثر من مجرد مسألة مصطلحات.
إن تسمية الليبرالية بأنها نظام نقدي كبير (يُنظر إليها الآن من وجهة نظر الاشتراكية القائمة بالفعل، والتي اختفت الآن) على هذا الأساس هو احتيال من حيث الأخلاقيات المهنية. هناك جانب واحد فقط يشترك فيه المال الكبير والليبرالية الجديدة. ومع ذلك، فإن هذا الارتباط ليس قويا ولا ينفصم، ولا هو ترابط، كما يتصور في كثير من الأحيان. الاتصال الوحيد الموجود بالفعل بسيط التعايش،وهو، مع ذلك، ليس حاسما وليس شيئا حقيقيا. وفي ظروف تاريخية خاصة ومحددة للغاية، ظهرت إلى الوجود المفاهيم السياسية للديمقراطية الليبرالية التي تحمي حقوق الإنسان ونظام نقدي أكثر انغلاقًا؛ وفي ظل ظروف تاريخية أكثر تحديدًا، أصبح هذا التعايش بين المفهوم السياسي للديمقراطية الليبرالية لحقوق الإنسان والنظام النقدي الأكثر انغلاقًا سمة مميزة للأيديولوجية والخطابة الليبرالية غير العادية. وهذا الارتباط هو تعايش حقيقي، لأنه من الممكن، من حيث المبدأ، أن يرفضه الطرفان. نحن نأخذ في الاعتبار الحالات التي يمكن أن يوجد فيها نظام نقدي أكثر انغلاقًا بشكل منتج مع نفس الديمقراطية من النوع المحافظ، وكذلك مع المتغيرات المحافظة للنظام السياسي غير الديمقراطي (الفاشية وما بعد الشيوعية).
حتى الآن، لم يتم وصف النظام النقدي الكبير بشكل كامل، على الرغم من أنه يمثل نظامًا ناجحًا وسهلاً مفهومةموضوع للاقتصاد والسياسة، وكذلك للمجتمع. إنها تمثل سياسة اقتصادية ذات طبيعة ليبرالية، على الرغم من أنها ليست فقط غير ليبرالية (يمكننا بالفعل أن نقول هذا بشكل مؤكد بناءً على المناقشات السابقة)، ولكنها بالمعنى الضيق ليست سياسة اقتصادية، حيث أن لديها القليل من القواسم المشتركة. مع الاقتصاد على هذا النحو. إنها تلك السياسة الاقتصادية، أو الاقتصاد السياسي، الذي يهتم حصريًا بالمعاملات المالية، وبذلك، يولي اهتمامًا خاصًا للظروف المواتية للمعاملات المالية العامة، ونتيجة لذلك، في ظروف المديونية المزدوجة للدولة، يتم توفير كميات كبيرة من الأموال. ومن الممكن دائما أن تنتقل تدفقات الأموال من المجال العام إلى آخرين. ولا يحدث هذا لأن هذه المجالات العامة لم تعد بحاجة إلى موارد نقدية، بل تحت تأثير حجة واعدة أكثر بساطة: في ظل ظروف معينة، يصبح من السهل تحويل هذه الموارد. هذا المفهوم الأساسي للنظام النقدي الكبير يحدد لكل فاعل مجال لعبه الخاص، والذي بدونه، كما قلنا، كان (أو ربما لا) يتعامل مباشرة مع العمليات الاقتصادية الحقيقية، لأن المفهوم يعكس منطق البيروقراطية والبيروقراطية. الإجراءات المالية، والتي تتوافق مع صياغة "عالم على الورق"، حيث يمكن للعمليات الاقتصادية الحقيقية أن تتقدم بسرعة كبيرة جدًا و(بالمعنى السلبي) بسهولة مطلقة.
ولهذا السبب فإن النظام النقدي بخصائصه هو "سياسة اقتصادية"، يمكن أن يوجد مكونه الاقتصادي (إلى حد ما) بشكل مستقل عن السياسة، كما يمكن للعنصر السياسي أن يوجد بشكل مستقل عن الاقتصاد. ومن الضروري أن نذكر أننا هنا نتعامل مع مزيج جديد من الاقتصاد والسياسة. كل خطوة نقدية (اقتصادية) سياسية، وكل خطوة نقدية (سياسية) اقتصادية. يتعامل النظام النقدي مع الاقتصاد والمجتمع فقط في الحالات الحدودية؛ وبطبيعة الحال، فإن هذا النظام ليس غير مبال بما إذا كان المجتمع يحاول مقاومته. بالنسبة للنقديين، فإن "الظروف الاستثنائية"، وفقا لكارل شميت، هي الحالة الاجتماعية الوحيدة التي تجذب انتباهه. بل إنها لا تهتم حتى بالعمليات الاقتصادية، أي أنها «حرة» والالتزام الوحيد المطلوب منها هو التوافق مع الأوضاع المالية العامة. وبما أننا نتحدث بالفعل عن "الحرية"، فلا بد من القول إن العمليات الاقتصادية ليست فقط "حرة"، بل إن العمليات الاجتماعية والجهات الفاعلة هي أيضًا "حرة"؛ وهذا، إذا ترجم إلى لغة مالية، يعني أنهم يستطيعون أن يفعلوا ويختبروا عملياً ما يحلو لهم، وكل هذا صحيح وقانوني. يظهر هنا اختلاف مهم آخر عن الأيديولوجية الليبرالية الرئيسية، لأنه في إطارها كان هناك بالفعل وعي بأنه لا ينبغي لأحد أن ينتهك المحظورات,وهو ما، كما أشرنا أعلاه، لا يمكن أن يقال على الإطلاق عن نظام نقدي كبير. يعيش نظام نقدي كبير مع المجتمع في نوع من «الزواج»، في حين أنه لا يستطيع الحكم على حالة «زوجه» إلا من خلال صرخات معاناته.
هذه هي النتيجة المنطقية لوجود نظام كبير قادر على ربط السياسة والاقتصاد بشكل وثيق بحيث يؤدي إلى تكوين لغته الخاصة، والتي، على الرغم من مفهوم العديد من فلاسفة اللغة، ليست "مجرد" لغة، ولكنه باختصار نظام من المفاهيم يتوافق معناها مع الأهداف الأصلية. وبالتالي فإن لغة النظام النقدي الضخم تمحو كل الفروق بين العمليات على المستوى الكلي والجزئي؛ ويترتب على ذلك أن موظفي المدارس والممرضات يسددون ديون الجيش أو الصناعة الثقيلة أو محطات الطاقة الكهرومائية من خلال رفضهم "الطلب على السلع الاستهلاكية". وبالتالي فإن شرط التوازن المالي، في لغة النظرية النقدية، هو "الاستهلاك الزائد"، حتى لو لم تحقق الدولة المعنية أدنى مستوى من الاستهلاك في الدول الغربية. في هذه اللغة، كل كائن له خصائصه السوقية الخاصة: جسدية أو عقلية أو خيالية أو طوباوية. في اعتقاده الذي لا نهاية له بأن كل شيء هو (ويجب أن يكون) سوقًا، لا ينسى النظام النقدي الرئيسي دراساته السابقة للتاريخ الاقتصادي فحسب (مثل تلك التي أجراها كارل بولاني)، بل ينسى أيضًا دراساته الحالية للحدود الحديثة للعالم. سوق. الموضوع الرئيسي ليس تدفئة المستشفى، بل سن المواطن (ويفضل أن يكون ذلك بخصائصه الاقتصادية والعلمية)، والذي يتم تقديمه على أنه "مرتبط بالسوق" و"معتمد على السوق". وفي حين يتعين على المواطنين العاديين المسؤولين في العمل أن يعوضوا عن ديون الحكومة على حساب معيشتهم المادية، فإن الساسة والمصرفيين، حتى الآن، لم تتم إدانتهم قانونيا قط بتهمة التخطيط للديون. من الواضح أن قواعد قانون الكازينو هنا هي خسارة أكبر قدر ممكن، وكلما كان ذلك أفضل.
تزعم سياسة المدرسة النقدية (وهذه سمة معينة من سمات الواقع) أنها «رد فعل» لحالة اجتماعية جديدة، يمكن وصفها، مجازيًا على الأقل، بأنها «مرض المجتمع». ومع ذلك، في الواقع، تعتبر النظرية النقدية في حد ذاتها مرضًا اجتماعيًا، فهي لا تشترك مع العمليات الاقتصادية الحقيقية والمحظورات الاجتماعية والأهداف الحقيقية للأيديولوجية الليبرالية الرئيسية إلا في القليل جدًا مما يجعل مثل هذا التصنيف مبررًا تمامًا. وإذا أضفنا إلى هذه الحقائق كل المشاكل الديمقراطية والنظرية، فيمكننا أن نفهم الصورة بشكل أعمق.
إن الاتجاه الرئيسي لمجتمع مدمر ذاتياً هو نمو الدين العام، الذي لا يستطيع الاقتصاد مواكبةه حتى في ظل ظروف السوق الأكثر ملاءمة. أخيل لا يستطيع اللحاق بالسلحفاة.وبالتالي فإن المجتمع المدمر ذاتياً هو مجتمع غير قادر على الحفاظ (من خلال مؤسسات الدولة) على مستوى حديث متطور للغاية سريعالحضارة المزدهرة التي حققتها ذات يوم. وهذه ليست مجرد مسألة اقتصادية. إذا تم إغلاق المنجم بسبب عدم الربحية، فلن يؤدي ذلك إلى التدمير الذاتي الاجتماعي. ولكن إذا اضطرت الدولة إلى اتخاذ خطوة كبيرة إلى الوراء في مجال التعليم أو الرعاية الصحية، فإن ميول التدمير الذاتي سوف تصبح واضحة على الفور. لذلك، فإن المشكلة الرئيسية لمجتمع مدمر ذاتيًا ليست الاقتصاد: فالتدهور الاقتصادي ليس هو المشكلة الرئيسية، لأنه لا يتبعه سوى النمو الاقتصادي في ظل ظروف أكثر ملاءمة.
ليس فقط أن مثل هذه الفترة لا تساهم في تراكم القيم الحضارية أو الإنسانية، بل إنها في كثير من الأحيان لا يمكنها حتى ضمان الوجود البسيط. ومن وجهة النظر هذه، فإن الهوية الذاتية للدولة والمجتمع والمواطن أصبحت موضع شك. ولذلك فإن الدولة أو المجتمع أو المواطن لا يملك الفرصة لتحسين القيم الإنسانية العالمية، بل عليه أن يستنزف هذه القيم، بل ويدمرها.
إن مجتمع التدمير الذاتي هو واقع جديد وواسع الانتشار في عصرنا، يدعو إلى إصلاح المفاهيم الأساسية للحياة الاجتماعية.
مناسب فهملقد كان انهيار النظام النقدي الضخم مستمراً لبعض الوقت - في السياسة كما في الاقتصاد - وهذه مشكلة طويلة الأمد ومستمرة ومعقدة. إن مشكلة الفهم هذه معقدة للغاية، حيث أن النظام النقدي الكبير يقدم عدة جوانب في وقت واحد واحدمجتمع. تتجلى الطبيعة التدميرية للنظام النقدي الكبير بشكل تدريجي ودائم في سلسلة معينة من الخطوات، ومن الواضح أن هذه الخطوات ليست مرتبطة ببعضها البعض. ومن ناحية أخرى، فإن الهجمات والتدخلات النقدية تظهر دائما في أيديولوجية العقلانية النيوليبرالية التي لا تشوبها شائبة. ويصبح الفهم الاجتماعي لنظام نقدي كبير أكثر تنوعًا إذا اعتبرنا أن الجرافة النقدية تدمر أحيانًا تلك المؤسسات الاجتماعية التي في الحقيقةجاهزة للانخفاض ولم تعد قابلة للحياة. بطبيعة الحال، هناك بعض الخطوات المنطقية ولكن المحفوفة بالمخاطر تجعل هذه الإجراءات النقدية غير قانونية تماما. ومع ذلك، من ناحية أخرى، يظهر على الفور وجه آخر لنظام نقدي كبير، قريب من الإجراءات المعقولة الناجحة "ضد الإرادة"، أي القسوة، التي لم يسبق لها مثيل تقريبًا في العقود السلمية و"التراجع إلى لا شيء"، وهو ما يمكن رؤيته بسهولة في الهجمات على المجتمع (غير معروف ولكن قريب). في الواقع، تصل قسوة هذه الهجمات إلى حد انتهاك المحظورات، وليس من السهل العثور على تفسير لذلك. لقد تطرقنا قليلاً إلى مسألة انتهاك المحظورات، والآن أصبح السياق السياسي لهذه القسوة أكثر أهمية. ولا يستحق الأمر على الإطلاق أن نتخلى عن التفكير في عدد المجتمعات التي تعاني من أمراضها القاتلة وتهزها الأزمات، والتي قد تتمكن من البقاء إذا سمحت أو تمكنت من تحمل مثل هذه القسوة التي يجسدها نظام نقدي ضخم. وهنا تكمن مشكلة انتهاك النظرية النقدية للمحظورات، كما ناقشنا من قبل، في أنها لم تعد تُنتهك في التاريخ الحديث. ومن هنا الاستنتاج - الأساس والشرط الأيديولوجي لانتهاك المحظورات هو على وجه التحديد معاداة الشيوعية.
وبطبيعة الحال، يبقى السؤال ما إذا كان الهجوم على الاشتراكية الحقيقية الباهتة مبررا، وما إذا كان من الضروري دعم هذا الهجوم أيديولوجياً بالحجج والمساعدة الودية. أولا وقبل كل شيء، المفارقة هي أن مناهضة الشيوعية لم تنتصر إلا عندما صاغت هذا الهدف كاتجاه أيديولوجي، وتفاجأت عندما وجدت أن الشيوعية قد ماتت بنجاح. إذا فهمنا القسوة بهذه الطريقة، فسوف يظهر قريبا وجه آخر لنظام نقدي كبير، وهو: صفة فعالة ومهمة - القدرة على التكامل الوظيفي للعمليات الدولية الحديثة. مما لا شك فيه أن الافتقار الواضح إلى الأساليب اللازمة لتحقيق هذا التكامل من شأنه أن يؤدي إلى فهم كيفية دمج عمليات الاقتصاد الكلي الضخمة وغيرها من العمليات في صورة مشتركة وتوزيعها عبر الوظائف. إن النجاح الكبير الذي يحققه أي نظام نقدي رئيسي يتلخص في كونه هيمنة وظيفية، وليست هيمنة سياسية مباشرة، في حين أن كل هيمنة في السابق كان لابد أن تكون على الأقل سياسة خارجية. ومع ذلك، فإن هذه الميزة تعيدنا مرة أخرى إلى مسألة صعوبة الإدراك والقدرة على التفسير. إن السلطة الوظيفية ليست مجرد ظاهرة جديدة، بل هي أيضاً أداة يمكن من خلالها حل القضايا المعقدة المتعلقة بالشرعية السياسية على أفضل وجه.
وإذا كان لنا أن نحول انتباهنا الآن إلى الجانب الوظيفي من النظرية النقدية، فمن المؤكد أن الصورة سوف تتغير مرة أخرى. تظهر صورة النظرية النقدية "اليومية". بالطبع، لا تحدث المعارك البحرية كل يوم، ولا تحدث الهجمات النقدية كل يوم، فهذه هي الحياة اليومية، وهي تحدث دائمًا على خلفية المدرسة النقدية. ولا يمكننا أيضًا التأكد من أنها لن تحدث مرة أخرى أبدًا. ولا يوجد سلام نقدي مطلق، وهو ما يعني أيضاً أن الحرب ستستمر في المستقبل المنظور.
إن النظام النقدي الكبير لا يحدد نفسه، مما يجعل من الصعب إدراكه ووصفه. فهو لا يحتوي على شيء أو أشياء يعتمد عليها، ولكن هذا لا يعني أن جميع مكوناته لها نفس المصير. ويقترن النظام النقدي الكبير بهيمنة قيم معينة في المجتمع، والتي يمكن اعتبارها نتيجة مباشرة له. إنه يغير جميع الأنظمة الفرعية، والتي بدونها سوف تتوقف عن الوجود. فالنظام النقدي الكبير يقدم نفسه على أنه "طبيعي"، وكشيء لا يمكن تأكيده إلا من وجهة نظر ليبرالية، على الرغم من أن هذا "الشيء" مولود من مبادئ ليبرالية. الآن يبدو لنا أن الأمر ليس كذلك.
وفي هذا السياق، تغيرت الليبرالية الجديدة بشكل كبير. بعد الانتصار الواسع النطاق، ظلت النيوليبرالية هي المنظم الوحيد للعولمة على المسرح السياسي الأيديولوجي، وفي ذروة هيمنتها في الوعي الاجتماعي والسياسي، بدأت في التعرف على النظام العالمي الاجتماعي والاقتصادي القائم بأكمله. فهو لم يصل بعد إلى مستوى عالٍ من تنفيذ النظام العالمي القائم والعولمة والترشيد (بالمعنى الاجتماعي النظري)، وهو ما يعزز أيضًا الاتجاهات التي تولدها «محاولات توديع» الأساطير. إذا كانت النيوليبرالية هي نتيجة لهذا المستوى العالي من العقلنة في هذا النظام النظري، فلا ينبغي لها أن تمر عبر أشكال التحرر الجديدة المتطورة.
الترجمة من الإنجليزية بواسطة K. A. Biryukova
كما يمكننا أن نلاحظ بسخرية إلى حد ما، فإن هذا ممكن بسبب الإلمام به بعضتعد الميزات الجديدة للمجال السياسي (das Politische) في حد ذاتها نجاحًا كبيرًا جدًا، بينما لا يوجد أي أمل عمليًا في التعرف عليها الجميعالميزات الجديدة بشكل عام. وبما أن التكيف الجزئي للممارسة السياسية مع العلاقات الجديدة قد حدث بالفعل، فليست هناك حاجة لإعادة بناء كاملة للعلاقات النظرية للعولمة من أجل اكتشاف هذه العلاقات.
وبطبيعة الحال، فإن هذا التحول للقيم إلى هياكل/وظائف يثير أيضًا مشاكل علمية ونظرية مجردة.
من المتوقع أن يحد النظام الديمقراطي من الهجرة ولكنه في الوقت نفسه يجعل ذلك ممكنا.
في 31 مارس 2004، في بوليفيا، فجر عامل منجم نفسه في مبنى البرلمان. وكان السبب المباشر لتصرفاته هو عدم حصوله على معاش تقاعدي، وكان منطقه لا تشوبه شائبة. وطالب بالمبلغ الذي دفعه تدريجياً كضرائب لدولة بوليفيا خلال فترة عمله،
ولم يفعل ذلك بدون أسباب قانونية.
بلد متخيل في رواية ر. موزيل "الرجل بلا صفات" في إشارة إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية (تقريبًا).
الفهم الفلسفي لمشكلة العولمة
1. مفهوم "العولمة"
4. العولمة في المجال السياسي
5. العولمة الثقافية: الظاهرة والاتجاهات
6. الدين والعولمة في المجتمع العالمي
7. النظريات الاجتماعية والفلسفية للعولمة
7.1. نظرية الإمبريالية
7.2. نظريات النظام العالمي بقلم E. Giddens وL. Sklar
7.3. نظريات الاشتراكية العالمية
7.4. نظرية "العوالم الخيالية"
7.5. دريدا حول عملية العولمة
1. مفهوم "العولمة"
وينبغي فهم العولمة على أنها تجتذب غالبية البشرية إلى نظام واحد من العلاقات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية استنادا إلى أحدث وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كان الشرط الأساسي لظهور ظاهرة العولمة هو نتيجة عمليات الإدراك الإنساني: تطور المعرفة العلمية والتقنية، تطور التكنولوجيا، التي مكنت الفرد من إدراك الأشياء بحواسه الموجودة في أجزاء مختلفة. الأرض والدخول في علاقات معهم، وكذلك إدراكها بشكل طبيعي، وإدراك حقيقة هذه العلاقات.
العولمة هي مجموعة من عمليات التكامل المعقدة التي تغطي تدريجيا (أو غطت بالفعل؟) جميع مجالات المجتمع البشري. هذه العملية في حد ذاتها موضوعية ومشروطة تاريخياً بالتطور الكامل للحضارة الإنسانية. ومن ناحية أخرى، فإن مرحلتها الحالية تحددها إلى حد كبير المصالح الذاتية لبعض البلدان والشركات عبر الوطنية. مع تكثيف هذه العمليات المعقدة، تبرز مسألة إدارة ومراقبة تطورها، والتنظيم المعقول لعمليات العولمة، في ضوء تأثيرها الغامض تمامًا على المجموعات العرقية والثقافات والدول.
أصبحت العولمة ممكنة بفضل التوسع العالمي للحضارة الغربية، وانتشار قيمها ومؤسساتها إلى أجزاء أخرى من العالم. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط العولمة بالتحولات التي حدثت داخل المجتمع الغربي نفسه، في اقتصاده وسياسته وأيديولوجيته، على مدى نصف القرن الماضي.
2. معلوماتية المجتمع كأحد أسباب إنشاء مجتمع عالمي
وتؤدي عولمة المعلومات إلى ظهور ظاهرة "مجتمع المعلومات العالمي". هذا المصطلح واسع جدًا ويشمل، أولاً وقبل كل شيء، صناعة المعلومات العالمية الموحدة، التي تتطور على خلفية الدور المتزايد باستمرار للمعلومات والمعرفة في السياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ويفترض هذا المفهوم أن المعلومات تصبح كمية في المجتمع تحدد كافة أبعاد الحياة الأخرى. والواقع أن ثورة المعلومات والاتصالات الجارية تجبرنا على إعادة التفكير في موقفنا من مفاهيم أساسية مثل المكان والزمان والعمل. ففي نهاية المطاف، يمكن وصف العولمة بأنها عملية ضغط للمسافات الزمانية والمكانية. "ضغط الوقت" هو الجانب العكسي لضغط الفضاء. يتم تقليل الوقت اللازم لإكمال الإجراءات المكانية المعقدة. وبناء على ذلك، يتم ضغط كل وحدة زمنية، ومليئة بكمية من النشاط أكبر بعدة مرات مما كان يمكن إنجازه من قبل. وعندما يصبح الزمن شرطا حاسما لوقوع العديد من الأحداث الأخرى بعد إجراء معين، فإن قيمة الوقت تزداد بشكل كبير.
ما سبق يسمح لنا أن نفهم أن المكان والزمان لا يتم ضغطهما بمفردهما، ولكن في إطار إجراءات معقدة - منفصلة مكانيًا وزمانيًا -. يكمن جوهر الابتكار في إمكانية الإدارة الفعالة للمكان والزمان على نطاق عالمي: الجمع بين كتلة من الأحداث في أوقات مختلفة وفي أجزاء مختلفة من الأرض في دورة واحدة. في هذه السلسلة المنسقة من الأحداث والحركات والمعاملات، يكتسب كل عنصر على حدة أهمية بالنسبة لإمكانية الكل.
3. العولمة في المجال الاقتصادي
ومن أسباب العولمة في المجال الاقتصادي ما يلي:
1. زيادة الاتصال التواصلي في العالم. إنه مرتبط بتطور النقل وبتطور وسائل الاتصال.
ويرتبط تطور اتصالات النقل بالتقدم العلمي والتكنولوجي، مما أدى إلى إنشاء وسائل نقل سريعة وموثوقة، مما أدى إلى زيادة حجم التجارة العالمية.
لقد أدى تطور تقنيات الاتصال إلى حقيقة أن نقل المعلومات يستغرق الآن جزءًا من الثانية. في المجال الاقتصادي، يتم التعبير عن ذلك في النقل الفوري لقرارات الإدارة إلى المنظمة الأم، في زيادة سرعة حل مشاكل الأزمات (الآن يعتمد فقط على سرعة فهم موقف معين، وليس على سرعة البيانات تحويل).
2. توسيع الإنتاج خارج الحدود الوطنية. بدأ إنتاج السلع يفقد تدريجياً توطينه الوطني البحت ويتم توزيعه بين المناطق الاقتصادية حيث تكون أي عملية وسيطة أرخص. الآن يمكن أن تكون شركة الإدارة موجودة في مكان واحد، منظمة التصميم - في مكان مختلف تمامًا، إنتاج الأجزاء الأولية - في الثالث والرابع والخامس، تجميع المنتج وتصحيحه - في السادس والسابع، التصميم - تم تطويره في المركز الثامن، ويتم بيع المنتجات النهائية - في المركز العاشر، الثالث عشر، الحادي والعشرين، الرابع والثلاثين...
تتميز المرحلة الحالية للعولمة في تطور المجال الاقتصادي بما يلي:
1. تشكيل الشركات عبر الوطنية الضخمة، التي حررت نفسها إلى حد كبير من سيطرة دولة معينة. لقد بدأوا هم أنفسهم في تمثيل الدول - ليس فقط الدول "الجغرافية"، ولكن الدول "الاقتصادية"، التي لا تعتمد كثيرًا على الأرض والجنسية والثقافة، ولكن على قطاعات معينة من الاقتصاد العالمي.
2. ظهور مصادر تمويل غير حكومية: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير وغيرها. هذه بالفعل "دول مالية بحتة"، لا تركز على الإنتاج، بل تركز حصريًا على التدفقات النقدية. ميزانيات هذه المجتمعات غير الحكومية غالبًا ما تكون أكبر بعدة مرات من ميزانيات الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتشكل هذه "الدول الجديدة" اليوم القوة الموحدة الرئيسية للواقع: فأي دولة تسعى إلى الانضمام إلى العمليات الاقتصادية العالمية تضطر إلى قبول المبادئ التي ترسيها. وهو يستلزم إعادة بناء الاقتصاد المحلي، وإعادة البناء الاجتماعي، وفتح الحدود الاقتصادية، ومواءمة التعريفات والأسعار مع تلك المحددة في السوق العالمية، وما إلى ذلك.
3. تشكيل النخبة العالمية - دائرة ضيقة جدًا من الأشخاص الذين يؤثرون فعليًا على العمليات الاقتصادية والسياسية واسعة النطاق. ويرجع ذلك إلى توظيف الإدارة العليا في جميع أنحاء العالم.
4. استيراد العمالة ذات المهارات المتدنية من أفقر دول العالم الثالث، ولكنها غنية بالموارد البشرية، إلى أوروبا والولايات المتحدة، حيث يوجد انحدار ديموغرافي.
5. الخلط المستمر بين "الحقائق الوطنية". يأخذ العالم سمات الكسور: بين أي نقطتين تنتميان إلى مجموعة واحدة (اقتصاد واحد، ثقافة وطنية واحدة)، يمكن للمرء دائمًا وضع نقطة ثالثة تنتمي إلى مجموعة أخرى (اقتصاد آخر، ثقافة وطنية أخرى). ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه يوجد على طول "طريق العولمة" تياران مضادان: التغريب - إدخال أنماط (أنماط الحياة) الغربية إلى الجنوب والشرق، والاستشراق - إدخال أنماط الشرق والجنوب إلى الجنوب والشرق. الحضارة الغربية.
6. أصبحت المناطق غير الغربية من البشرية أهدافًا للعولمة الاقتصادية؛ وفي الوقت نفسه، تفقد العديد من الدول جزءًا كبيرًا من سيادتها، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الوظائف الاقتصادية، في حين أنها "ليست أكثر من أدوات لتعزيز الرأسمالية العالمية". ويتحمل العديد منهم تكاليف العولمة الاقتصادية، التي أصبحت غير متكافئة، حيث تتركز الثروة إلى درجة غير مسبوقة في قطب واحد والفقر في القطب الآخر.
وبالتالي، يصبح الاقتصاد هو المجال الرئيسي للعولمة، والذي ينتشر منه حتماً إلى مجالات أخرى من المجتمع، مسبباً تغييرات اجتماعية واجتماعية وثقافية وسياسية بعيدة المدى تتجاوز التركيز الذي تنشأ فيه.




والتبادل الثقافي، الذي يجب أن تلعب فيه طرق تدريس المدارس العليا والثانوية دورًا مهمًا. الفصل الثاني أشكال استخدام تقنيات الشبكات في سياق عولمة التعليم إن التطور السريع لتقنيات الاتصالات، ولا سيما الإنترنت والوسائط المتعددة في السنوات الأخيرة، لم يسهم فقط في ظهور الاهتمام المتزايد باستخدام أجهزة الكمبيوتر في... .





وظائف الفلسفة. ولم تعد تسعى إلى تقديم المعرفة العالمية حول العالم، وإدراج الإنسان في هذا العالم، فضلاً عن المعرفة العلمية الموجودة. ولا يتطلب هيكلها العالمية أو المنهجية أو الطبيعة الشاملة على الإطلاق. وبناء على ذلك، تفقد الوظائف المعرفية والمنهجية والأيديولوجية للفلسفة أهميتها السابقة. وفي الوقت نفسه، تزداد أهمية الوظيفة الحاسمة...
حول تكوين صورة مشوهة للعالم في العقل تتطور نتيجة لسلسلة من التأثيرات الهادفة. الهدف هو دراسة وتحليل ملامح عملية العولمة الحديثة كمرحلة من مراحل التطور الاجتماعي. ولتحقيق هذا الهدف، تم حل المهام التالية: دراسة العولمة كمشكلة اجتماعية فلسفية؛ استكشاف الظاهرة الاجتماعية للعولمة ...
الحجم الإجمالي 4.6 ر.ل. وتم اختبار أحكام ونتائج الدراسة في تدريس مقررات العلوم السياسية وعلم الاجتماع السياسي، مقررات خاصة "الدولة الروسية كمؤسسة سياسية في سياق العولمة"، "نظريات التطور السياسي والعولمة" في كلية الفلسفة والعلوم التقنيات الاجتماعية في جامعة ولاية فولغوغراد. مناقشة الأطروحة والتوصية بها...
إن صورة الحداثة لن تكتمل دون الإشارة إلى يقينها التاريخي الجديد: العولمة. تُدخل العولمة انقسامات أو اختلافات هيكلية جديدة في التاريخ تُثري حداثة ما بعد الحداثة بشكل كبير.
ويجب القول أنه لا توجد وحدة في تفسير العولمة. الآراء هنا لا تتكاثر فحسب، بل تستقطب أيضا. بالنسبة للبعض، فهو توسيع لا شك فيه لفرص تأكيد الوجود الأصيل أو الفردي لجميع موضوعات العملية التاريخية: الأفراد، والفئات الاجتماعية، والشعوب، والبلدان، والمناطق. وبالنسبة لآخرين، فهي «الموجة التاسعة» من التاريخ، التي تجتاح كل الهويات والأصالة في طريقها. فمن ناحية، من الواضح أنهم يقومون بتبسيط الأمر: امنحوه الوقت وسيعمل كل شيء من تلقاء نفسه. ومن ناحية أخرى، فإنهم يبالغون في تصوير الأحداث، ويلومون كل الخطايا المميتة تقريباً: فوضى الحياة العامة وتجريمها، والتدهور الأخلاقي على نطاق واسع، وإفقار بلدان ومناطق بأكملها، والانتشار السريع لإدمان المخدرات، ومرض الإيدز، وما إلى ذلك.
دعونا نلاحظ أنه لا يوجد شيء جديد في النموذج الثنائي المتعارض لتصور العولمة. هذه وسيلة شائعة لتحديد وتوضيح مشكلة جديدة حقًا. إن العولمة هي، بطبيعة الحال، مشكلة جديدة. فريدة من نوعها، أو جديدة جذريًا، على وجه الدقة. والارتباك الأعظم في هذه المشكلة يأتي من أولئك الذين يساوون بين العولمة والتحديث. في الواقع، هذه عصور وعمليات تاريخية مختلفة تختلف اختلافا جذريا عن بعضها البعض. العولمة بمعنى التكامل، وزيادة النزاهة في إطار العصر الحديث (الزمن الجديد) هي التحديث؛ إن "تحديث" عصر ما بعد الحداثة (من الربع الأخير من القرن العشرين) هو في الواقع عولمة. يتم "منح" التحديث في الحالة الأخيرة بين علامتي تنصيص لسبب: أن العولمة متماسكة وعضوية ليس للتحديث، بل لما بعد الحداثة.
إن الرحم الأم للعولمة هو المجتمع ما بعد الصناعي، وهو مجتمع غربي في الأساس. ومن هناك تنمو، في تلك التربة توجد عصائرها الواهبة للحياة، وها هي في المنزل. لكن الشيء الرئيسي هو أنه هناك تؤتي ثمارها حقًا. ومع ذلك، مما قيل، لا يعني ذلك بأي حال من الأحوال أن العولمة ليست كوكبية، بل هي ظاهرة إقليمية حصرية ("المليار الذهبي")، وهي عملية "توحيد البلدان المتقدمة في معارضتها لبقية البلدان". من العالم."
العولمة عالمية لأنها لا تقاوم، بل تلتقط وتحتضن. وإذا كان هناك مواجهة فيها فهي تاريخية (بالنسبة للتطور السابق)، أي. زمانية وليست مكانية. ولكن لا شك أن هناك مشكلة هنا. إنها كيفية فهم هذا الالتقاط أو الاحتضان. في نظر البعض، تبدو العولمة وكأنها عملية تكنولوجيا معلومات متناحية، تغلف الكرة الأرضية بالكامل بشكل موحد دون انقطاع أو "تبلور" محلي. لكن هذا على الأرجح مفهوم خاطئ.
إن عملية العولمة في العالم الحديث لا تكاد تكون عالمية بمعنى أنها مستمرة وأمامية. واحدة من أكثر صورها انتشارًا ونجاحًا بلا شك هي شبكة الويب العالمية (الإنترنت). وفي رأينا أنه يمكن أن نبدأ منه في البحث عن البنية العامة للعولمة، ونسيجها التنظيمي.
إن العولمة هي استغلال عدم التجانس والاختلاف، وليس التجانس والتوحيد. يتم استغلال إمكانات هذا الأخير بالكامل في مرحلة التحديث.
هذا هو الفرح (المزايا) والحزن (العيوب) للوضع التاريخي الحالي. الفرح، المزايا: لا أحد يتعدى على ميزات أو اختلافات محلية أو إقليمية أو غيرها. ومن الغريب أن عملية العولمة هي التي سلطت الضوء عليها وقدمتها لنا بشكل كامل. يمكن للجميع (البلد، الشعب، الفئة الاجتماعية، الفرد) أن يؤكدوا أنفسهم بحرية (باختيارهم ومبادرتهم). الحزن وأوجه القصور: الاعتراف، إن لم يكن تشجيع الميزات أو الاختلافات، يتم جلبه إلى الحق في لمسها على الأقل. الآن يمكن الدفاع عن الأصالة إلى أبعد الحدود.
لقد أدت العولمة أيضًا إلى رفع مبدأ حياة السوق إلى أقصى الحدود وجعلته شاملاً في الاختراق. والآن لا يقتصر الأمر على السلع والخدمات فحسب، بل يمتد أيضًا إلى القيم ووجهات النظر والتوجهات الإيديولوجية. من فضلك، طرح، حاول، ولكن ماذا سيحدث، ما الذي سينجو، ما الذي سيفوز - المنافسة في السوق ستقرر. كل شيء، بما في ذلك الثقافة الوطنية، له الحق في الوجود، وفي الواقع، البقاء على قيد الحياة في ظروف أشد صراع السوق. ومن الواضح أنه لن تتمكن كل هوية من اجتياز اختبار السوق والمنافسة. وسوف تصبح حالات الإفلاس المعيارية أيضاً حقيقة واقعة، إن لم تكن بالفعل. بشكل عام، تجري عملية تشكيل ثقافة وجود عالمية موحدة. وفي ضوء هذا المنظور، من المرجح أن يتم الحفاظ على أنظمة القيم الوطنية الثقافية الأصلية كمحميات إثنوغرافية، على مستوى الفولكلور وفي شكله.
تستبعد عولمة ما بعد الحداثة الهجمات والمصادرات العدوانية - فكل شيء موجود فيها بالفعل. ليس هناك فائدة من الاعتماد على المساعدة الخارجية في مثل هذه الحالة. لكن الكثير، إن لم يكن كل شيء، يعتمد الآن على الاختيار التاريخي، على "إرادة التطور" لدى الأشخاص التاريخيين المستقلين تمامًا (بشكل هائل). الجميع، حسنًا، الجميع تقريبًا، لديهم فرصة لاختراق عصر ما بعد الصناعة. كل ما تبقى هو استخدامه.
لقد تم إحياء العولمة من خلال المنطق العضوي للتطور التاريخي، بدعم من المبادرة والنشاط الإسقاطي المستهدف للبشرية الغربية (وفي المستقبل - جميعها). نتيجة للتوسع، والأهم من ذلك، ملء "مساحة المعيشة" للتحديث. لا يمكن للعولمة أن تفشل. إنها مرحلة ضرورية في تطور البشرية. والتنوع ليس مستبعدا، بل على العكس من ذلك، فهو مفترض، ولكن الآن في إطار هذا النوع التاريخي.
بمعنى آخر، لا يوجد بديل (معاكس) للعولمة، بل هناك بدائل (خيارات) في إطار العولمة. وتمثلهم بعض الاستراتيجيات الوطنية للاندماج في عمليات العولمة الحديثة.