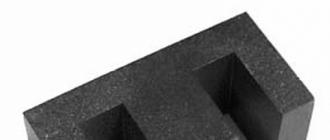موضوع الدراسة الإنسانية هو الإنسان نفسه. الإنسان كموضوع للمعرفة. الإنسان كموضوع للمعرفة العلمية
الإنسان هو موضوع دراسة كل من العلوم الطبيعية (العلوم الطبيعية) والعلوم الروحية (العلوم الإنسانية والاجتماعية). هناك حوار مستمر بين المعرفة الطبيعية والإنسانية حول مشكلة الإنسان وتبادل المعلومات والنماذج النظرية والأساليب وغيرها.
تحتل الأنثروبولوجيا مكانة مركزية في مجمع تخصصات العلوم الطبيعية حول الإنسان؛ والموضوع الرئيسي لدراستها هو النشأة البشرية، أي أصل الإنسان والمجتمع (6.2، 6.3). لحل مشاكلها الخاصة، تعتمد الأنثروبولوجيا على بيانات من علم الأجنة، وعلم الرئيسيات، والجيولوجيا وعلم الآثار، والإثنوغرافيا، واللغويات، وما إلى ذلك.
العلاقة بين البيولوجي والنفسي والاجتماعي في الإنسان، وكذلك الأسس البيولوجية للنشاط الاجتماعي، تعتبر من قبل علم الأحياء الاجتماعي وعلم الأخلاق (6.8).
إن دراسة النفس البشرية، والعلاقة بين الوعي واللاوعي، وخصائص الأداء العقلي، وما إلى ذلك، هي مجال من مجالات علم النفس يوجد فيه العديد من الاتجاهات والمدارس المستقلة (6.4، 6.5).
مشكلة العلاقة بين الوعي والدماغ، والتي تعد أيضًا أحد موضوعات دراسة العلوم الطبيعية للإنسان، تقع عند تقاطع علم النفس والفيزيولوجيا العصبية والفلسفة (7.7).
الإنسان كجزء من الطبيعة الحية، فإن طبيعة تفاعلاته مع المحيط الحيوي هي موضوع الاعتبار في علم البيئة والتخصصات ذات الصلة (5.8).
وهكذا يمكننا القول قطعاً أن مشكلة الإنسان ذات طبيعة متعددة التخصصات، والنظرة العلمية الطبيعية الحديثة للإنسان هي معرفة معقدة ومتعددة الأبعاد يتم الحصول عليها ضمن مختلف التخصصات. كما أن النظرة الشاملة للإنسان وجوهره وطبيعته مستحيلة دون استخدام بيانات من المعرفة والفلسفة الإنسانية والاجتماعية.
22. يعني مصطلح "المحيط الحيوي" بالترجمة الحرفية مجال الحياة، وبهذا المعنى تم تقديمه لأول مرة في العلوم في عام 1875 على يد الجيولوجي وعالم الحفريات النمساوي إدوارد سوس (1831 - 1914). ومع ذلك، قبل ذلك بوقت طويل، تحت أسماء أخرى، على وجه الخصوص، "مساحة الحياة"، "صورة الطبيعة"، "القشرة الحية للأرض"، وما إلى ذلك، تم النظر في محتواها من قبل العديد من علماء الطبيعة الآخرين.
في البداية، كل هذه المصطلحات تعني فقط مجمل الكائنات الحية التي تعيش على كوكبنا، على الرغم من الإشارة في بعض الأحيان إلى ارتباطها بالعمليات الجغرافية والجيولوجية والكونية، ولكن في الوقت نفسه، تم لفت الانتباه إلى اعتماد الطبيعة الحية على القوى والمواد ذات الطبيعة غير العضوية. وحتى صاحب مصطلح «المحيط الحيوي» إ. سوس في كتابه «وجه الأرض» الذي نشر بعد ثلاثين عامًا تقريبًا من طرح المصطلح (1909)، لم يلحظ ذلك تأثير عكسيالمحيط الحيوي وعرفه بأنه "مجموعة من الكائنات الحية محدودة المكان والزمان وتعيش على سطح الأرض".
أول عالم أحياء أشار بوضوح إلى الدور الهائل للكائنات الحية في تكوين القشرة الأرضية هو Zh.B. لامارك (1744 – 1829). وأكد أن جميع المواد الموجودة على سطح الكرة الأرضية والتي تشكل قشرتها تكونت نتيجة نشاط الكائنات الحية، وقد أثرت نتائج هذا المنهج بشكل فوري في دراسة المشكلات العامة المتعلقة بتأثير العوامل الحيوية، أو الحية، على اللاأحيائية. أو الظروف المادية. لذلك، اتضح، على سبيل المثال، أن التكوين مياه البحريتم تحديده إلى حد كبير من خلال نشاط الكائنات البحرية. النباتات التي تعيش على التربة الرملية تغير بنيتها بشكل كبير. حتى أن الكائنات الحية تتحكم في تكوين غلافنا الجوي. يمكن بسهولة زيادة عدد الأمثلة المماثلة، وكلها تشير إلى وجود ردود فعل بين الطبيعة الحية وغير الحية، ونتيجة لذلك تغير المادة الحية بشكل كبير وجه أرضنا. وبالتالي، لا يمكن النظر إلى المحيط الحيوي بمعزل عن ذلك الطبيعة الجامدةالذي يعتمد عليه من جهة ويؤثر عليه من جهة أخرى. لذلك، يواجه علماء الطبيعة مهمة التحقيق على وجه التحديد في كيفية وإلى أي مدى تؤثر المادة الحية على العمليات الفيزيائية والكيميائية والجيولوجية التي تحدث على سطح الأرض وفي القشرة الأرضية. مثل هذا النهج وحده هو الذي يمكن أن يعطي فهمًا واضحًا وعميقًا لمفهوم المحيط الحيوي. هذه هي بالضبط المهمة التي حددها لنفسه العالم الروسي البارز فلاديمير إيفانوفيتش فيرنادسكي (1863 – 1945).
المحيط الحيوي والرجل
تشكل الإنسان الحديث منذ حوالي 30-40 ألف سنة. منذ ذلك الوقت، بدأ عامل جديد يعمل في تطور المحيط الحيوي - من صنع الإنسان.
أول ثقافة أنشأها الإنسان هي العصر الحجري القديم ( العصر الحجري) استمرت ما يقارب 20-30 ألف سنة!؟! فقد تزامنت مع فترة طويلة، واليوم توصل خبراء من جامعة كانساس إلى نتيجة مفادها أن هذه الأحداث مبنية على عوامل خارج كوكب الأرض. تعتمد فكرتهم على حقيقة أن جميع النجوم في مجرتنا وفي الكون ليست في نقاط ثابتة على الإطلاق، ولكنها تتحرك حول مركز ما، على سبيل المثال، مركز المجرة. أثناء حركتهم، يمكنهم المرور عبر أي مناطق ذات ظروف غير مواتية وإشعاع عالي.
ونظامنا الشمسي ليس استثناءً في هذه الحالة، فهو يدور أيضًا حول مركز المجرة، وتبلغ فترة دورانه 64 مليون سنة، أي تقريبًا نفس مدة دورات التنوع البيولوجي على الأرض.
يقول العلماء أن مجرتنا درب التبانة تعتمد في جاذبيتها على مجموعة من المجرات تقع على بعد 50 مليون سنة ضوئية. وفقا لأدريان ميلوت وميخائيل ميدفيديف، علماء الفلك في جامعة كانساس، أثناء تحركها، تقترب هذه الأجسام حتما من بعضها البعض، مما يؤدي إلى اضطرابات جاذبية قوية، ونتيجة لذلك يمكن أن تتغير مدارات الكواكب.
وفقا للعلماء، نتيجة للنهج الدوري، تحدث انحرافات الجاذبية التي تؤثر أيضا على الأرض. ونتيجة لهذه التغييرات، هناك زيادة إشعاع الخلفيةونتيجة لحقيقة أن الكوكب يمكن أن يغير مداره حول الأرض قليلاً، يمكن أن يتغير المناخ بشكل كبير جدًا، وهو ما قد يؤدي في الواقع إلى انقراض جماعي للحيوانات في تاريخ كوكبنا.
في الطريق إلى مجال نو
في العالم الحديثيتلقى مفهوم "المحيط الحيوي" تفسيرًا مختلفًا - كظاهرة كوكبية ذات طبيعة كونية.
أصبح الفهم الجديد للمحيط الحيوي ممكنا بفضل إنجازات العلم، الذي أعلن عن وحدة المحيط الحيوي والإنسانية، ووحدة الجنس البشري، والطبيعة الكوكبية للنشاط البشري وتناسبها مع العمليات الجيولوجية. يتم تسهيل هذا الفهم من خلال الازدهار غير المسبوق ("الانفجار") للعلوم والتكنولوجيا، وتطوير الأشكال الديمقراطية للمجتمع البشري والرغبة في السلام بين شعوب الكوكب.
إن عقيدة انتقال المحيط الحيوي إلى الغلاف الجوي هي ذروة الإبداع العلمي والفلسفي لـ V. I. Vernadsky. في عام 1926، كتب أن "المحيط الحيوي، الذي نشأ عبر الزمن الجيولوجي وثبت في توازنه، يبدأ في التغير بشكل أعمق تحت تأثير النشاط البشري". لقد كان هذا المحيط الحيوي للأرض، الذي تغير وتحول باسم البشرية ولصالح البشرية، هو الذي أطلق عليه اسم الغلاف النووي.
تم تقديم مفهوم الغلاف النووي كمرحلة حديثة، يختبرها المحيط الحيوي جيولوجيًا (مترجم من الكلمة اليونانية القديمة noos - العقل، أي مجال العقل)، في عام 1927 من قبل عالم الرياضيات والفيلسوف الفرنسي إي. ليروي (1870 - 1954) ) في محاضراته بباريس . أكد E. Leroy أنه توصل إلى هذا التفسير للمحيط الحيوي مع صديقه عالم الجيولوجيا وعالم الحفريات الرائد شاردين (1881 - 1955).
ما هو مجال نو؟ في عام 1945، كتب V. I. Vernadsky في أحد أعماله العلمية: "الآن، في القرنين التاسع عشر والعشرين، بدأ عصر جيولوجي جديد في تاريخ الأرض. أطلق بعض الجيولوجيين الأمريكيين (D. Lecomte وC. Schuchert) على هذه الحقبة اسم "العصر النفسي"، في حين أطلق عليها آخرون، مثل الأكاديمي أ.ب. بافلوف، حقبة جيولوجية "بشرية المنشأ". تتوافق هذه الأسماء مع ظاهرة جيولوجية عظيمة جديدة: لقد أصبح الإنسان قوة جيولوجية، تغير وجه كوكبنا لأول مرة، قوة تبدو أساسية. ومزيد من ذلك: "لأول مرة، فهم الإنسان حقًا أنه من سكان الكوكب ويمكنه - ويجب عليه - أن يفكر ويتصرف في جانب جديد، ليس فقط في جانب الفرد أو الأسرة أو العشيرة أو الدول أو اتحاداتها ولكن أيضًا في الجانب الكوكبي. هو، مثل كل الكائنات الحية، يمكنه التفكير والتصرف في الجانب الكوكبي فقط في مجال الحياة - في المحيط الحيوي، في قشرة أرضية معينة، والتي يرتبط بها بشكل لا ينفصم، بشكل طبيعي ولا يمكنه المغادرة منها. وجودها هو وظيفتها. ويحمله معه في كل مكان. وهو حتماً، بطبيعة الحال، يغيرها باستمرار.
إن عملية انتقال المحيط الحيوي إلى الغلاف النووي تحمل في حد ذاتها حتماً سمات النشاط البشري الواعي والهادف والنهج الإبداعي. V. I. لقد فهم فيرنادسكي أن البشرية يجب أن تستخدم موارد المحيط الحيوي على النحو الأمثل، مما يحفز قدراتها كموئل بشري. يعتقد العالم أن الفكر العلمي سيقود البشرية على طول الطريق إلى مجال نو. في الوقت نفسه، أولى اهتمامًا خاصًا للعواقب الجيوكيميائية للنشاط البشري في بيئته، والتي أطلق عليها تلميذه الأكاديمي إيه إي فيرسمان فيما بعد اسم "التولد التكنولوجي". V. I. كتب فيرنادسكي عن الإمكانيات التي تنفتح أمام الإنسان في استخدام مصادر الطاقة خارج المحيط الحيوي - طاقة النواة الذرية، التي لم تستخدمها الكائنات الحية من قبل. إن تطوير تدفقات الطاقة بشكل مستقل عن المحيط الحيوي، وكذلك تخليق الأحماض الأمينية - العنصر الهيكلي الرئيسي للبروتين - يؤدي إلى حالة بيئية جديدة نوعيا. هذه مسألة تتعلق بالمستقبل، لكن الناس الآن يسعون جاهدين لبناء علاقاتهم مع "الغطاء الحي" للكوكب، والحفاظ على التنوع البيولوجي. وهذا يظهر التفاؤل العميق في تعاليم فيرنادسكي: بيئةتوقفت عن مواجهة الإنسان كقوة خارجية مجهولة وقوية ولكنها عمياء. ومع ذلك، من خلال تنظيم قوى الطبيعة، يتحمل الإنسان مسؤولية هائلة. هذه هي الطريقة التي ولد بها المحيط الحيوي الجديد والأخلاق البيئية في القرن العشرين.
التغلغل بعمق في الأنماط الأساسية للتنمية الطبيعة المحيطة، V. I. كان فيرنادسكي متقدمًا بشكل كبير على عصره. ولهذا فهو أقرب إلينا من كثير من معاصريه. كان مجال رؤية العالم دائمًا يدور حول مسائل التطبيق العملي للمعرفة العلمية. ومن وجهة نظره، فإن العلم لا يحقق غرضه بالكامل إلا عندما يتناول احتياجات ومتطلبات الإنسان بشكل مباشر.
في عام 1936، V. I. كتب فيرنادسكي، في عمل كان له تأثير كبير على تطور العلوم وغير آراء أتباعه إلى حد كبير، "الفكر العلمي كظاهرة كوكبية" (لم يُنشر مطلقًا خلال حياته): "لأول مرة احتضن الإنسان حياته، بثقافتها، الغلاف العلوي بأكمله للكوكب - بشكل عام، المحيط الحيوي بأكمله، منطقة الكوكب بأكملها المرتبطة بالحياة.
الصورة العلمية الطبيعية الحديثة للعالم وحدوده معرفة علمية
لم تكن العلاقة بين العلم والميتافيزيقا (الفلسفة والدين) بسيطة على الإطلاق، لأن الأفكار حول العالم التي تولدها غالبًا ما يتبين أنها غير متسقة تمامًا أو غير متوافقة تمامًا. هذا في حد ذاته ليس مفاجئًا على الإطلاق، لأن كل مجال من مجالات المعرفة هذه له ديناميكيات التطوير الخاصة به، وتقاليده وقواعد اللعبة، ومصادره ومعايير الحقيقة الخاصة به؛ لا يمكن ضمان اتساق هذه "صور العالم" المختلفة بطبيعتها في كل لحظة بسبب عدم الاكتمال الأساسي لأي معرفة. ومع ذلك، فإن حاجة الشخص الداخلية إلى الاتساق وسلامة النظرة إلى العالم لم تتغير، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى الوعي والتوفيق بين التناقضات المذكورة أعلاه، أو على الأقل تفسيرها المرضي.
في كل لحظة من التاريخ، هذه التناقضات في الفرد و الوعي العامتكتسب خصوصيتها، وتركز على قضايا مختلفة وغالباً ما تكون مسيسة، لتصبح على سبيل المثال إحدى النقاط الأساسية حملة انتخابيةفي الولايات المتحدة الأمريكية أو جذب انتباه الصحافة فيما يتعلق دعاوى قضائيةحول محتوى البرامج التعليمية المدرسية. يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى نوع من انفصام الوعي العام، عندما يخسر الإنسانيون و"علماء الطبيعة". لغة متبادلةوالتوقف عن فهم بعضنا البعض. كيف يمكنك أن تتميز الوضع الحاليهذه المشكلة الأبدية؟
يبدو لي أن هناك عدة نقاط رئيسية هنا. هناك العديد من الاكتشافات الجديدة وغير المعروفة في الرياضيات والعلوم الطبيعية والتي تغير بشكل جذري الصورة العلمية الطبيعية للعالم ونهج العلم الحديث تجاه القضايا المثيرة للجدل أيديولوجياً.
إحدى هذه القضايا هي مبدأ السببية والإرادة الحرة. ينطلق العلم الطبيعي من حقيقة أن العالم طبيعي أولاً، وثانيًا، أن قوانين تطوره معروفة. بدون هذه الافتراضات، لا يمكن للعلم أن يعمل، لأنه إذا لم تكن هناك قوانين، فإن موضوع المعرفة يختفي؛ إذا كانت هذه القوانين موجودة ولكنها غير مفهومة، فإن المعرفة العلمية باطلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن كل شخص يرى أن حرية إرادته لا شك فيها حقيقة تجريبيةرغم كل الحجج العلمية أو الفلسفية أو الدينية التي تنفي ذلك. إن السببية والانتظام العالميين يتعارضان مع الإرادة الحرة الحقيقية، وإذا لم يكن هناك مكان في الصورة العلمية للعالم لهذه الحقيقة الأولية في إدراكنا، فيبقى إما اعتبار هذه الحقيقة النفسية وهمًا للإدراك، أو الاعتراف بمثل هذا الوهم. صورة علمية للعالم على أنه خاطئ أو غير مكتمل بالأساس.
في مثل هذا العالم المتشعب، كان المجتمع الأوروبي المتعلم موجودًا منذ حوالي قرنين من الزمان - خلال فترة الهيمنة الكاملة للنظرة العلمية الآلية للعالم. فسرت ميكانيكا نيوتن-لابلاس العالم بأنه يتكون حصريًا من الفراغ والجسيمات، والتي تم وصف التفاعل بينها بشكل لا لبس فيه من خلال قوانين الميكانيكا؛ إن إضافة هذه الصورة إلى النظرية الميكانيكية لحرارة بولتزمان-غيبس والديناميكا الكهربائية لماكسويل لم تنتهك بأي حال من الأحوال هذه الحتمية العالمية وعززتها فقط من خلال إظهار إمكانية تقليل عوامل أخرى. معروف للعلمالظواهر إلى معادلات تكاملية للحركة تستنتج المستقبل من الماضي بشكل لا لبس فيه. لم يكن هناك مكان للإرادة الحرة، وبالتالي للدين والأخلاق القائمة على هذه الحرية، في مثل هذه الصورة العلمية الطبيعية للعالم. تبين أن الأفكار الدينية والأخلاقية والعلمية غير متوافقة من الناحية المفاهيمية.
ولا يزال هذا الصراع بين المادية العلمية الطبيعية والوعي الديني والأخلاقي يسمم الأجواء الفكرية والفكرية مجتمع حديث، على الرغم من حقيقة أن العلم قام خلال العقود الماضية بمراجعة ادعاءاته بشكل جذري. أصبحت مقتنعة بالاستحالة الأساسية للحد من الأداء أنظمة معقدةإلى القوانين التي تحدد تفاعلات عناصرها، ويقترب من إمكانية التنبؤ بمستقبل العالم بناءً على حالته الحالية بعناية أكبر. لقد تم الآن رفض حتمية لابلاس بشكل نهائي باعتبارها نتيجة خاطئة وخاطئة. ولكن كم من الناس يعرفون ما هي الثورة العلمية التي أدت إلى هذا التعديل الجذري؟ الفيزياء المدرسية تتجاهل هذا ثورة علميةوما زالت الأفكار التي عفا عليها الزمن حول الإمكانيات المحتملة للعلوم الطبيعية تهيمن على وعي المجتمع المتعلم.
وهناك أسباب موضوعية لهذا التأخر. إن مفاهيم التنظيم الذاتي، والديناميكيات غير الخطية، والفوضى، التي تبرر رفض السببية المستمرة والشاملة للكون، هي مفاهيم صعبة رياضيًا وتتعارض في كل خطوة مع أفكارنا المعتادة. إن تفكيرنا التقليدي، المبني على تجاربنا اليومية، هو تفكير خطي وسببي؛ لقد اعتدنا على الاعتقاد بأن الظهور التلقائي لهياكل معقدة عالية التنظيم من حالة متجانسة أمر مستحيل، وحتى عندما يتم إثباته في تجارب مرئية للغاية وبسيطة وقابلة للتكرار بشكل جيد، مثل تفاعل بيلوسوف-زابوتنسكي، فإنه يعطي الانطباع من نوع ما من الخدعة أو المعجزة.
بل إن الأمر الأكثر صعوبة هو إدراك مدى جدية استنتاجات النظرة العالمية التي تتبع الاعتراف بواقع الظواهر الفيزيائية العفوية غير الحتمية. بعد كل شيء، لا توجد مثل هذه الظواهر على هامش العالم المادي، مثل بعض التفاصيل الغريبة غير المهمة التي لا تغير الصورة العامة. على العكس من ذلك، فهي مدمجة في النقاط الرئيسية في تطور العالم ككل وتحدد ديناميكياته بطريقة حاسمة. من نقاط التشعب للحلول إلى المعادلات التطورية، أي النقاط التي يُفقد فيها الاستمرار الفريد للحلول في الوقت المناسب، ومن التقلبات التي تنشأ عند هذه النقاط، تنمو الحلول التي تتوافق مع جميع الهياكل المرصودة فعليًا للعالم المادي - من المجرات وأذرعهم الحلزونية للنجوم وأنظمة الكواكب. يؤدي عدم الاستقرار الحراري لمادة الوشاح إلى ظهور القارات والمحيطات، ويحدد تكتونية الصفائح، وهذا بدوره يحدد جميع أشكال التضاريس الرئيسية على جميع المقاييس المكانية: من النمط العام للشبكة الجبلية (شبكة الأنهار وسلاسل الجبال) ) للأشكال المميزة للمناظر الطبيعية. هذه الديناميكيات التطورية غير خطية: فهي لا تحدد الأشكال التي يتم تشكيلها فحسب، بل تعتمد أيضًا على الأشكال المثبتة تاريخيًا. هذه التقيمات(اللاخطية الأساسية) تؤدي إلى قوانين عامة للتشكل، وإلى التعقيد التدريجي ونمو التنوع. يمكن القول أن هذا، التشكل الجيني، أو الديناميكيات المورفولوجية، على عكس التشكل الوصفي، يتخذ حاليًا خطواته الأولى فقط، لكنه مثير للإعجاب أيضًا، لأنه يرسم صورة للعالم تختلف اختلافًا جوهريًا عما اعتدنا عليه من المدرسة.
الكلمة الأساسية للصورة الجديدة للعالم هي "بشكل عفوي". وفي الواقع، فهو يعني رفض مبدأ السببية الفيزيائي عند وصف أهم الأحداث في تطور الأنظمة المعقدة. يمكن تفسير العفوية على أنها حادث، غير مشروط بأسباب مادية، أو على أنها مظهر من مظاهر قوى ومبادئ خارقة للطبيعة بمختلف أنواعها: إرادة الله، العناية الإلهية، الانسجام المحدد مسبقًا، بعض الأبدية، الخالدة. المبادئ الرياضيةبروح لايبنيز أو سبينوزا. لكن كل هذه التفسيرات تقع بالفعل خارج إطار العلم الطبيعي، ولا يفرضها العلم بأي حال من الأحوال، ولكنها لا تستطيع أن تتعارض معه. وبعبارة أخرى، فإن الصورة الطبيعية العلمية الجديدة للعالم لا تسمح لنا بفصل الفيزياء عن الميتافيزيقا وجعلهما مستقلين عن بعضهما البعض.
الاستنتاج التالي المهم من الناحية الأيديولوجية هو الاستحالة الأساسية على الأقل لتوقعات طويلة المدى عالية الجودة لتطوير أنظمة غير خطية معقدة إلى حد ما. ينشأ مفهوم "أفق التنبؤ": وبالتالي، فإن توقعات الطقس الأكثر أو أقل موثوقية ممكنة لمدة أسبوع أو أسبوعين مقدما، ولكنها مستحيلة بشكل أساسي لمدة ستة أشهر. والحقيقة هي أن الأنظمة المعقدة تتميز بجاذبية المسارات التطورية إلى الحدود في مساحة الطور التي تفصل المناطق ذات أنظمة الاستقرار المختلفة، وبالتالي تغيير الأنظمة (مع وقت مميز معين للبقاء في منطقة ذات نظام معين). هذه الحقيقة تجعل من المستحيل حتى التنبؤ النوعي لفترة تتجاوز الوقت المميز لتغيير النظام. من حيث المبدأ، الأمر نفسه ينطبق على التنبؤ بتغير المناخ، فقط الفترة هنا أطول من التنبؤ بالطقس. لن نتمكن أبداً من التنبؤ بتغير المناخ بعد مرور ثلاثة إلى أربعة عقود من الزمن، كما لن نتمكن من استقراء الأنماط الإحصائية التي تم تحديدها في الماضي على نحو جدير بالثقة في فترة أبعد من الفترة التي أنشئت فيها هذه الأنماط. إن الديناميكيات الفوضوية للعملية تستبعد هذا الاحتمال بشكل أساسي.
وهنا يكشف العلم مرة أخرى عن الحدود الأساسية التي لا يمكن إزالتها لقدراته التفسيرية والتنبؤية. وهذا لا يعني بالطبع تشويه سمعته كمصدر للمعرفة الموضوعية والموثوقة، بل يجبرنا على التخلي عن مفهوم العلموية، أي الفلسفة التي تؤكد القدرة المطلقة ولا حدود لإمكانيات العلم. ورغم أن هذه الاحتمالات كبيرة، إلا أن لها حدودها، وعلينا في النهاية أن نتحلى بالشجاعة ونعترف بهذه الحقيقة.
التكنولوجيا الحيوية والعلوم الطبيعية والعلوم الهندسية
التنظيم الهيكليالتكنولوجيا الحيوية (بما في ذلك الروابط مع العديد من مجالات علم الأحياء، مع الكيمياء والفيزياء والرياضيات، مع العلوم التقنية والهندسة والأنشطة التكنولوجية، مع الإنتاج) تجعل من الممكن دمج العلوم الطبيعية والمعرفة العلمية والتقنية والإنتاج والخبرة التكنولوجية في إطارها. وفي الوقت نفسه، فإن أشكال التكامل بين العلم والإنتاج التي يتم تنفيذها في إطار التكنولوجيا الحيوية تختلف نوعيا عن أشكال التكامل التي يتم تنفيذها في تفاعل العلوم الأخرى مع الإنتاج. أولا، يتم استخدام التقنيات التقنية في مجالات علم الأحياء التي كانت بالفعل نتيجة للتكامل مع الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم التحكم الآلي - الهندسة الوراثية، والبيولوجيا الجزيئية، والفيزياء الحيوية، والالكترونيات الحيوية، وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، تشكيل مفاهيم التكنولوجيا الحيوية ، وهي ذات طبيعة اصطناعية، تعكس لحظة معينة في الحركة نحو نظام من المفاهيم التقنية العامة، التي تغطي، بالإضافة إلى المفاهيم التقليدية، أنواعًا جديدة من الأشياء التقنية والأنشطة الفنية. ثانيا، في شكل التكنولوجيا الحيوية، يتم تحديد الاتجاه لتطوير طريقة تكنولوجية جديدة للإنتاج، حيث ستكون هناك مرحلة تهدف إلى استعادة التوازن الطبيعي المضطرب. وتظهر التكنولوجيا الحيوية أيضًا مزاياها في هذا الصدد البيئي: فهي قادرة على العمل بطريقة تجعل من الممكن استخدام المنتجات التي تم الحصول عليها في مراحل فردية من التوليف في دورات إنتاج معقدة، أي أنه يصبح من الممكن تطوير عمليات إنتاج خالية من النفايات.
المجال الواعد في مجال التكنولوجيا الحيوية هو الهندسة الوراثية. ترتبط قابلية التصنيع للهندسة الوراثية بالقدرة على استخدام أشياءها ومعارفها ليس فقط لأغراض الإنتاج، ولكن على وجه التحديد لتطوير تقنيات جديدة. العمليات التكنولوجية. وهي تكنولوجية في محتوى أنشطتها البحثية، لأنها تعتمد على تصميم وبناء جزيئات الحمض النووي "الاصطناعية". من الناحية المنهجية، تتمتع الهندسة الوراثية بجميع علامات التصميم: مخطط تصميمي يعكس خطة الباحث ويحدد الاتجاه المستهدف للكائن المستقبلي، اصطناعية الكائن قيد الدراسة: نشاط تصميمي هادف، وتكون نتيجته كائن اصطناعي جديد - جزيء الحمض النووي.
كما ترون، فإن الهندسة الوراثية تكنولوجية سواء من الناحية الخارجية (الإنتاجية والتكنولوجية) أو الداخلية (المحتوى الفعلي للعلم وأساليبه).
ترتبط ميزات الهندسة الوراثية كتقنية بالخصائص النوعية للتصميم فيها مقارنة بالتصميم في المجالات الهندسية والتقنية. تكمن هذه الخصوصية في حقيقة أن نتيجة التصميم هي أنظمة ذاتية التنظيم، والتي، كونها بيولوجية، يمكن تصنيفها في نفس الوقت على أنها مصطنعة (تقنية). يجب أيضًا التأكيد على أنه إذا كان التصميم والتنفيذ الفني للأنظمة الجديدة في الأنشطة الهندسية مرتبطًا بأنشطة تصميم النظام، فإن التصميم في علم الأحياء يرتبط بالنظام الكامل للطرق والمعرفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية الجزيئية، والتي تم دمجها في النظرية. النموذج الذي يسبق النظام الاصطناعي.
ترتبط النجاحات الهائلة التي حققها علم الوراثة حاليًا بشكل أساسي بدراسة الآليات الوراثية للفيروسات والبكتيريا. لقد كانت وراثة الفيروسات، ولا سيما العاثيات، هي التي قدمت المادة الرئيسية لفك الشفرة الوراثية، وقد فتح عمل س. بينزر على العاثيات الطريق لإثبات تجريبي للطبيعة المعقدة للجين. لقد أثرت نجاحات علم الوراثة الجزيئية على وراثة الحيوانات والنباتات، وتغيرت بشكل كبير، إن لم يكن مسار البحث، فعلى الأقل فهم العديد من المشكلات - وراثة معايير التفاعل، والحصانة الوراثية، وما إلى ذلك. خصوصيتها الخاصة ، معبرًا عنها في الشكل المورفولوجي و الخصائص الفسيولوجية جسم الإنسان، وفي درجة دراستها.
الظرف الأخير، على الرغم من أنه يبدو للوهلة الأولى أنه ذو أهمية ثانوية، إلا أنه ذو أهمية كبيرة فيما يتعلق بعلم الوراثة العام. لا يكاد يوجد نوع آخر تمت دراسة تنوعه بمثل هذا الاكتمال والدقة. لقد جمعت بعثات علماء الأنثروبولوجيا، التي أجريت على مدار الخمسين إلى السبعين عامًا الماضية إلى جميع أنحاء العالم، مواد هائلة حول التباين الجغرافي للخصائص المورفولوجية البشرية، وجعلت من الممكن تحديد مجموعاتها الجغرافية - الأجناس البشرية، وجعلت من الممكن تحديد الخطوط العريضة وبشكل عام حل مشاكل التسلسل الهرمي وعلاقات الأنساب. على مدار الثلاثين عامًا الماضية، توسعت دراسة علم وظائف الأعضاء العرقي على نطاق واسع، وأظهرت انتظامًا واضحًا في التوزيع الجغرافي للعديد من الخصائص الفسيولوجية. جنبا إلى جنب مع هذا، في البحوث الأنثروبولوجية، كما هو الحال في البحوث الطبية والفسيولوجية، تم إيلاء اهتمام وثيق لمشكلة الاختلافات الدستورية وارتباطها بأنواع النشاط العصبي العالي. بشكل عام، يبدو أن هذه المشكلة لا يمكن حلها إلا من قبل علماء الأنثروبولوجيا والأطباء، حيث تمت دراسة أنواع ردود الفعل العصبية والآليات النفسية العصبية عند البشر بتفصيل أكبر بكثير من الحيوانات.
يسمح لنا عدد كبير من اكتشافات الحفريات برسم صورة عامة للتغيرات في النوع الجسدي للشخص بمرور الوقت. وقد فتحت الدراسات التشريحية والجنينية المقارنة إمكانية تحديد الأنماط المورفولوجية لتطورها. من خلال دراسة الأدوات القديمة وحياة القدماء، المراحل الرئيسية في تطور التنظيم الاجتماعي للمجموعات البشرية البدائية، وعلاقاتها الاقتصادية والعرقية، ونمو أعدادها، وطبيعة الاستيطان، ودور الاختلاط في هذه العمليات تتم استعادة. وبالتالي، فإن تاريخ النوع البشري، وكذلك جغرافيته ومورفولوجيته، يتم دراسته بشكل أفضل من تاريخ أي نوع حيواني.
مثل هذه المعلومات الكاملة حول أنواع التباين البشري، وتوزيعها في الزمان والمكان، وجزئيًا عن أسباب هذه التغييرات، تخلق الأساس لدراسة العديد من المشكلات الوراثية على مستوى أعلى مما هو ممكن في علم الوراثة الحيوانية. وتشمل هذه الاضطرابات الأيضية الوراثية، والتشوهات والانحرافات الصبغية، واعتلالات الهيموجلوبين واضطرابات تخثر الدم الوراثية، والبروتينات وأنزيمات البلازما (جميعها على مستوى الجسم)، وأنماط التوزيع الجغرافي للجينات (الجغرافيا الجينية)، ودور العزلة في شدة العمليات الجينية التلقائية، والدور النسبي للبانميكسيا والعزلة في عمليات تكوين السباق، والمعدل، والطفرات (كل هذا على مستوى السكان). لذلك، يتم تضمين المواد الأنثروبولوجية والبشرية بشكل متزايد في التقارير المتعلقة بعلم الوراثة العام وتمثل البيانات الرئيسية لتحليل وحل عدد من القضايا الأساسية.
الآن بضع كلمات حول الخصوصية النوعية كموضوع للدراسة الوراثية. إنها تكمن في طبيعته الاجتماعية. مع ظهور المجتمع وتطور العلاقات الاجتماعية، تتدخل لحظات جديدة تحولها في الأنماط البيولوجية. وتشمل هذه تطوير الكوكب بأكمله تقريبًا، والاختلاط غير المحدود بين الأجناس ومحو حدود المناطق العرقية، والتداخل والتأثير المتبادل للثقافات، وزيادة المعدات التقنية، وفتح إمكانيات غير محدودة لهجرة الجينات - باختصار، جميع المتطلبات الأساسية التي تخلق حالة من البانميكسيا. يتتبع مسارات هجرة الجينات عبر مسافات شاسعة، ويدرس استقرارها والتغيرات في معدل الطفرات أثناء الهجرة، ويحدد مناطق التركيزات الأكثر كثافة للجينات وطبيعة العلاقة بينها، وبالتالي بناء جسر بين علم الوراثة، على من ناحية، والنظاميات والتصنيف من ناحية أخرى.
زواج الأقارب، والتنافر المتبادل بين الشعوب التي تتحدث لغات مختلفة، وخاصة لغات عائلات لغوية مختلفة، وأنظمة الطبقات، وتمايز الممتلكات، والانتماء إلى ديانات مختلفة تعمل في الاتجاه المعاكس - تخلق ما يسمى بالعزلة الاجتماعية. تكمن خصوصيتها في أنها توسع بشكل كبير الأساس للحكم على نماذج الحواجز الوراثية وديناميكيات عملها مع مرور الوقت وأشكال تأثيرها على التركيب الجيني للسكان. وبالتالي، يتم إثراء جميع جوانب علم الوراثة السكانية بشكل كبير من خلال البيانات التي تم الحصول عليها في الدراسات الأنثروبولوجية والبشرية.
لذا فإن خصوصية الإنسان ككائن وراثي تكمن في اجتماعيته التي تعد شرطا أساسيا لظهور العديد من الظواهر الوراثية على مستوى السكان، وفي المعرفة الكاملة بأنواع التقلبات في جسم الإنسان، مما يجعله من الممكن تفصيل العمليات الجينية التي تمت دراستها بشكل عام في كائنات أخرى.
- Benser S. البنية الدقيقة للمنطقة الوراثية في البكتيريا // Proc. طبيعة. أكاد. الخيال العلمي. غسل. (العاصمة)، 1955. المجلد. 41: شرحه. حول طوبولوجيا البنية الوراثية الدقيقة // المرجع نفسه. 1959. المجلد. 45. وتجدر الإشارة إلى أن البنية المعقدة للجين تم التنبؤ بها منذ ما يقرب من 40 عامًا من قبل عالم الوراثة السوفييتي الرائع أ.س.سيريبروفسكي. انظر: Serebrovsky A. S. تأثير الجين الأرجواني على العبور بين الأسود والكلنتوبار في ذبابة الفاكهة melanogaster // Zh. com.exprm. مادة الاحياء. سر. أ. 1926. ص. 2، لا. 1/2؛ إنه هو. دراسة التماثل التدريجي // المرجع نفسه. 1930. ت6، العدد. 2؛ سيريبروفسكي إيه إس، دوبينين إن بي. اكتساب مصطنعالطفرات ومشكلة الجينات // نجاحات التجارب. مادة الاحياء. 1929. العدد. 4. A. S. Serebrovsky هو عالم رومانسي نموذجي، وقد قدم مساهمة كبيرة في علم الوراثة النظري وأثريه بعدد من المفاهيم الأساسية. S.: Shapiro N. I. في ذكرى A. S. Serebrovsky // علم الوراثة. 1966. رقم 9؛ مالينوفسكي أ.أ. حول مسألة
طرق دراسة شروط العملية الإبداعية // الإبداع العلمي. م، 1969. - لا توجد ملخصات شاملة للمواد المتراكمة. يتم ملء هذه الفجوة جزئيًا فيما يلي. الطبعه: Eickstedt R. Rassengeschichte der Menscheit. شتوتغارت. 1934؛ Biasuttl K. Rpzze i popoli della terra: In 4 vol. تورينو، 1959-1960؛ Lundman B. Umriss der Rassenkunde des Menschen in geschichtlicher Zeit. كوبنهاغن، 1952؛ شرحه. الجغرافيا Vnthropologie. شتوتغارت، 1968؛ Alekseev V. P. الجغرافيا الأجناس البشرية. م، 1974.
- مورانت أ. توزيع فصائل الدم البشرية. أكسفورد، 1954؛ Walter H. Die Bedeutung dor serologischen Merkmale fiir die Rassenkunde // Die neuc Rassrnkimde /Hrsg. آي شويتسكي. شتوتغارت، 1962؛ Harrison G.، Weiner J.، Tanner I.، Barnicot N. علم الأحياء البشري: مقدمة. لتطور الإنسان وتنوعه ونموه. نيويورك. ل.. 1964؛ روس. ترجمة: Harrison J.، Weiner J.، Tanner J.، Barnicott N. علم الأحياء البشري. م، 1968؛ Prokop O. Lehrbuch der menschlichen Blut- und Serumgruppen. لايبزيغ، 1966؛ Voronoe A. A. الجغرافيا العرقية للأنواع الرئيسية من الهابتوغلوبين - بروتين المصل // Sov. الأجناس البشرية. 1968. رقم 2. هذه المجالات من الأنثروبولوجيا تجتذب الآن الاهتمام في جميع أنحاء العالم، والأدب ينمو بمعدل رائع.
- بعد الأعمال الأولى لـ E. Kretschmer، الذي كان يميل إلى حد كبير إلى آراء متطرفة، ظهرت مقالات تضع المشكلة في إطار البحث التجريبي الدقيق. انظر: روجينسكي يا يا مواد عن دراسة العلاقة بين اللياقة البدنية والمهارات الحركية // الأنثروبول. يحكم على 1937. رقم 3؛ Malinovsky A. A. الارتباطات الأولية والتقلبات في جسم الإنسان // بروك. معهد علم الخلايا والأنسجة والأجنة. 1948. ت.2، العدد. 1. تم تناول جانب مختلف قليلاً من المشكلة في كتاب يا يا روجينسكي في الفصل "حول أنواع الشخصيات وأهميتها في نظرية تكوين الإنسان". انظر: روجينسكي يا.يا.مشاكل التولد البشري. م، 1969.
- تم تلخيص معلومات شاملة حول الاكتشافات الأحفورية: Heberer G. Die Fossilgeschichte der Hominoidea // Primatologia: Handbuch der Primatenkunde/Hrsg. إتش هوفر، أ. شولتز، د. ستارك. باسل؛ نيويورك، 1956؛ بيفيتو جي. الرئيسيات. الحفريات البشرية /// سمة الحفريات. ص، 1957. ت 7؛ Gieseler W. Die Fossilgeschichte des Mencshen // "rJ:e Evolution der Organismen. شتوتغارت، 1959. دينار بحريني. 2؛ أشباه البشر الأحفورية وأصل الإنسان // Tr. معهد الإثنوغرافيا التابع لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. ن.س. م، 1966. ت 92؛ Alekseev V. P. علم الإنسان القديم في العالم وتكوين الأجناس البشرية. العصر الحجري القديم. م، 1978.
- انظر: روجينسكي يا.يا.مشاكل التولد البشري. الفصل. ثانيا.
- جميع المواد ذات الصلة متناثرة عبر مئات المقالات والدراسات الخاصة. للحصول على ملخصات، ليست كاملة، ولكنها تحتوي على الببليوغرافيا الرئيسية، راجع: الحياة الاجتماعية للإنسان المبكر // منشورات صندوق الفايكنج في الأنثروبولوجيا. نيويورك، 1961. ن 31؛ Grigoriev G. P. بداية العصر الحجري القديم الأعلى وأصل الإنسان العاقل. ل.، 1968؛ طبيعة وتطور المجتمع البدائي على أراضي الجزء الأوروبي من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. م، 1969 (مقالات كتبها A. A. Velichko و M. D. Gvozdover، G. P. Grigoriev و A. N. Rogachev)؛ Bibikov S. N. بعض جوانب النمذجة البيئية القديمة للعصر الحجري القديم // Sov. علم الآثار. 1969. رقم 4. للحصول على ملخصات للبيانات والأدبيات، انظر: Efroimson V.P. مقدمة في علم الوراثة الطبية. م، 1968؛ Konyukhov B.V. النمذجة البيولوجية للأمراض البشرية الوراثية. م" 1969؛ أساسيات علم الوراثة الخلوية البشرية. م.، 1969؛ مشاكل الوراثة الطبية. م، 1970؛ آفاق علم الوراثة الطبية. م، 1982. مراجعة قصيرةللحصول على مشاكل ذات صلة، راجع: Alekseev V.P. الجغرافيا البشرية // العلوم والإنسانية. م، 1968.
- للحصول على ملخصات للبيانات والأدبيات، راجع: Efroimson V.P. مقدمة في علم الوراثة الطبية. م، 1968؛ Konyukhov B.V. النمذجة البيولوجية للأمراض البشرية الوراثية. م" 1969؛ أساسيات علم الوراثة الخلوية البشرية. م.، 1969؛ مشاكل الوراثة الطبية. م، 1970؛ آفاق علم الوراثة الطبية. م، 1982. للحصول على لمحة موجزة عن المشاكل ذات الصلة هنا، انظر: Alekseev V.P. الجغرافيا البشرية // العلوم والإنسانية. م، 1968.
- للحصول على لمحة موجزة عن المشاكل ذات الصلة هنا، راجع: Alekseev V.P. الجغرافيا البشرية // العلوم والإنسانية. م، 1968.
- لقد انجذب دائمًا الاهتمام الأكبر في علم الوراثة البشرية إلى العزلة وتأثيرها على التركيب الوراثي للسكان. للحصول على نتائج دراسات محددة، انظر ما يلي. الأعمال: Ginzburg V. V. طاجيك الجبال: (مواد عن أنثروبولوجيا الطاجيك كاراتجين ودارفاز). م. ل.، 1937؛ Glass V.، Sacks M.، Jahn V.، Hess S. الانجراف الوراثي في عزلة دينية: تحليل لأسباب الاختلاف في فصيلة الدم وترددات الجينات الأخرى في مجموعة صغيرة من السكان // عامر. طبيعة. 1952. المجلد. 86، ن 828؛ قراءات في العرق. سبرينغفيلد (الثالث)، 1960؛ Hainline J. التلقيح والتقلب الوراثي (المصلي) في ميكرونيزيا // آن. إن واي أكاد. الخيال العلمي. 1966. المجلد. 134، المادة. 2؛ جايلز إي.، والش في.، برادلي إم. التطور الجزئي في غينيا الجديدة؛ دور الانجراف الوراثي // المرجع نفسه: Gadzhiev A. N. أنثروبولوجيا المجموعات السكانية الصغيرة في داغستان. محج قلعة، 1971؛ رينكوف يو جي الأنثروبولوجيا وعلم الوراثة للسكان المعزولين (العزلات القديمة للبامير). م.، 19C9. بيان عام للسؤال: جلاس V. التغيرات الجينية في السكان البشريين، وخاصة تلك الناجمة عن تدفق الجينات والانحراف الوراثي // Adv. جينيت. نيويورك، 1954. المجلد. 6. لم تتم دراسة حالة البانميكسيا ودورها في تكوين العرق إلا بشكل أقل بكثير. للحصول على مناقشة عامة للمشكلة، راجع: Alekseev V. P. طرق تكوين العرق والتوزيع الجغرافي للجينات للخصائص العنصرية // Sov. الأجناس البشرية. 1967. رقم 1.
- انظر على سبيل المثال: Dubinin N.P., Glembotsky Ya.L. علم الوراثة السكانية والاختيار M., 1967. تُستخدم البيانات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي لفصائل الدم لدى البشر لتسليط الضوء على دور العمليات الجينية التلقائية في الظروف التي لا تحتوي على اختيار (الفصل 1). الرابع: ص62-70).
- وقد لوحظ هذا الظرف بشكل مستقل من قبل العديد من الباحثين الذين فحصوه من وجهات نظر مختلفة: روجينسكي يا.يا.مشكلة أصل الإنسان العاقل // التقدم في علم الأحياء الحديث. 1938. ت9، العدد. 14)؛ إنه هو. بعض مشاكل المرحلة اللاحقة من التطور البشري في الأنثروبولوجيا الحديثة // Tr. معهد الأنتوغرافيا التابع لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. ن.س.م.؛ ل.، 1947. ت 2؛
Kremyansky V. A. الانتقال من الدور القيادي في الاختيار إلى الدور القيادي للعمل // التقدم في العصر الحديث ، علم الأحياء. 1941. ت 14، العدد. 2(5); Davidenkov S. M. المشاكل الوراثية التطورية في علم الأمراض العصبية. ل.، 1947. - وينعكس في عقيدة مجال نو. انظر: التقدم في العصر الحديث، علم الأحياء. 1944. ت 18، العدد. 2. المصطلح مستعار من E. Leroy: Le Roy E. L’exigence Idealiste et le fuit d’evolution. P. ، 1927. بروح مثالية، تم تطويرها من قبل P. Teilhard de Chardin في كتاب "ظاهرة الإنسان" (م، 1965؛ الطبعة الثانية. م، 1987). حول نظرته للعالم، انظر: Pluzhansky T. بعض ملامح آراء تيلارد دي شاردان // من إيراسموس
في هذا اليوم:
أعياد الميلاد 1817 ولد أوستن هنري لايارد- اكتشف عالم الآثار الإنجليزي وباحث نينوى والنمرود المكتبة الملكية الشهيرة للألواح المسمارية لآشور بانيبال. الاكتشافات 1813 يوهان بوركهارتفتح المعابد المصرية في ابو سمبل.
يرتبط الفهم الفلسفي للإنسان ببعض الصعوبات. عند التفكير في شخص ما، يقتصر الباحث على مستوى المعرفة العلمية الطبيعية في عصره، وظروف الوضع التاريخي أو اليومي، وتفضيلاته السياسية الخاصة. كل ما سبق يؤثر بطريقة أو بأخرى على التفسير الفلسفي للشخص. لذلك حديثة الفلسفة الاجتماعيةعند دراسة المشاكل الإنسانية، فهو لا يهتم فقط بالمشاكل الإنسانية نفسها، ولكن أيضًا بمشكلة أخرى دائمة الحضور، والتي أطلق عليها V. S. Barulin "العلاقة بين الإنسان والفلسفة".
1. الإنسان كموضوع للمعرفة العلمية
إن العلاقة بين الفلسفة والإنسان، وكذلك المشكلة الاجتماعية الفلسفية ككل، قد تغيرت وتطورت تاريخيا. في الوقت نفسه، في تاريخ الفلسفة يمكن تمييز معلمتين لتطور الفلسفة:
1) درجة فهم المشكلة الإنسانية كمبدأ أولي منهجي للفلسفة. بمعنى آخر، بقدر ما يدرك الفيلسوف أن الإنسان هو المركز والمعيار والهدف الأسمى لكل فلسفة، ما مدى أهمية هذا المبدأ.
2) درجة الفهم الفلسفي للإنسان نفسه ووجوده ومعنى وجوده واهتماماته وأهدافه. بمعنى آخر، إلى أي مدى أصبح الشخص موضوعًا منفصلاً ومميزًا للتفكير الفلسفي، وبأي عمق نظري، وبأي درجة من مشاركة جميع وسائل التحليل الفلسفي التي يعتبرها.
وهكذا، كانت مشكلة الإنسان دائمًا في مركز البحث الفلسفي: بغض النظر عن المشكلات التي تتناولها الفلسفة، كان الإنسان دائمًا هو المشكلة الأكثر أهمية بالنسبة لها.
حدد العالم الألماني الحديث إي. كاسيرير أربع فترات تاريخية في تاريخ الدراسات الإنسانية:
1) دراسة الإنسان عن طريق الميتافيزيقا (العصور القديمة).
2) دراسة الإنسان باللاهوت (العصور الوسطى)،
3) دراسة الإنسان بالرياضيات والميكانيكا (العصر الحديث).
4) دراسة علم الأحياء البشري.
لدراسة الإنسان كموضوع معقد للغاية للمعرفة العلمية، طور الفكر الفلسفي سلسلة كاملة من المفاهيم التي تتيح لك الإجابة بشكل كامل وشامل على سؤال حول جوهر وطبيعة الإنسان، ومعنى وجوده.
بادئ ذي بدء، الإنسان هو أعلى مستوى من الكائنات الحية على وجه الأرض، وهو موضوع النشاط والثقافة الاجتماعية التاريخية. مفهوم مفهوم الرجلعام، يعبر عن السمات العامة للجنس البشري، شخص اجتماعي. يجمع هذا المفهوم بين السمات البيولوجية والاجتماعية العامة للشخص.
لدراسة الفرد في الفلسفة والعلوم الأخرى، يتم استخدام مفهوم "الفرد". تشير الفردية إلى السمات والصفات الأصلية والفريدة المتأصلة في فرد معين.
الشخصية هي الصفات الاجتماعية للفرد، التي يكتسبها في عملية التعليم والتعليم الذاتي، والنشاط الروحي والعملي والتفاعل مع المجتمع. يتمتع الإنسان أولاً وقبل كل شيء بصفات روحية. الشخصية لا تعطى للإنسان من الخارج، بل يمكن أن تتشكل بواسطته فقط. الشخصية الحقيقية ليست ظاهرة مجمدة، بل هي ديناميكية بالكامل. الشخصية هي دائمًا الإبداع والنصر والهزيمة والبحث والاكتساب والتغلب على العبودية والحصول على الحرية.
الشخصية تحمل دائمًا طابع عصر معين. تتميز الشخصية الحديثة بالمستوى العالي من التعليم والنشاط الاجتماعي والبراغماتية والاستدلال والعزيمة. الإنسان المعاصر هو الشخص الذي أتقن القيم والمثل الديمقراطية والعالمية. فهو لا يفصل مصيره عن مصير شعبه والمجتمع ككل.
الإنسان بطبيعته كائن نشيط ونشط. إلى حد كبير، هو نفسه يخلق حياته ومصيره، فهو مؤلف التاريخ وعالم الثقافة. النشاط بأشكاله المختلفة (العمل، السياسة، المعرفة، التعليم، إلخ) هو وسيلة للوجود الإنساني كشخص، خالق عالم جديد. في سياق ذلك، لا يتغير فقط العالمبل أيضا طبيعته الخاصة. جميع صفات وقدرات الناس لها طبيعة تاريخية محددة، أي. أنها تتغير أثناء النشاط. وفي هذا الصدد، أشار ك. ماركس إلى أن جميع الحواس الخارجية الخمس للإنسان تم إنشاؤها من خلال تاريخ العمل والصناعة. بفضل النشاط، يكون الشخص كائنًا بلاستيكيًا ومرنًا. إنه احتمال أبدي غير مكتمل، فهو دائمًا في حالة بحث وفي العمل، في اختراق طاقته الروحية والجسدية المضطربة.
لدى الإنسان آلية ليس فقط للميراث البيولوجي، ولكن أيضًا للميراث الاجتماعي. يحدث الميراث الاجتماعي في المجتمع أثناء التنشئة الاجتماعية. التنشئة الاجتماعية هي عملية تكوين الشخصية، والتي تحدث في المقام الأول من خلال التعليم كنوع خاص من النشاط.
الإنسان لديه طريقة حياة جماعية. فقط في إطار هذه الأنشطة يمكنه تكوين وتطوير صفاته. إن ثراء عقل الإنسان وعالمه العاطفي واتساع آرائه واهتماماته واحتياجاته يعتمد إلى حد كبير على اتساع نطاق تواصله وتفاعله مع الآخرين.
يتمتع الشخص أيضًا بعدد من الصفات الأخرى. يعرف الناس كيفية إنشاء الأدوات وتحسينها باستمرار. إنهم قادرون، على أساس المعايير الأخلاقية، على تنظيم علاقاتهم الخاصة.
لقد تغيرت النظرة الفلسفية لمشكلة الإنسان كموضوع للمعرفة مع مرور الوقت. يمكن تتبع تطور وجهات النظر الفلسفية حول الإنسان منذ العصور المبكرة جدًا. خلال الفترة بأكملها، تغيرت وجهات النظر حول موقف الشخص ومكانه في نظام معرفة الفلسفة بشكل كبير، وتحولت وتطورت. وفي الوقت نفسه تغيرت وجهات النظر حول مكانة الإنسان تبعاً للتغير العام في وجهات النظر الفلسفية حول كل ما هو موجود، ولم تبتعد أبداً عن التدفق العام للفكر الفلسفي.
يمكن تنظيم تعريفات طبيعة وجوهر الإنسان المقدمة في الفلسفة العالمية بطرق مختلفة. دعونا نتناول خيارًا يميز بين ثلاثة طرق:
ذاتي (الشخص هو في المقام الأول عالمه الداخلي الذاتي) ؛
موضوعي (الإنسان نتاج وحامل للظروف الخارجية الموضوعية لوجوده) ؛
التوليف (الإنسان هو وحدة الذاتية الداخلية والموضوعية الخارجية).
إن أتباع هذه الأساليب إما يتشاركون في مفاهيم "طبيعة" و"جوهر" الشخص، أو لا يفعلون ذلك. في الحالة الأولى، تُفهم الطبيعة البشرية على أنها الأصالة، وخصوصية الإنسان ككائن حي، والجوهر هو أساسه المحدد والرائد والمتكامل.
في التدريس الفلسفيهناك ثلاثة مستويات لمفهوم "الشخص":
1. الإنسان بشكل عام باعتباره تجسيدًا للجنس البشري في
بشكل عام كائن عام (مثال - عبارة "الرجل ملك".
طبيعة")؛
2. الإنسان التاريخي الملموس (الإنسان البدائي
3. شخص يؤخذ على حدة كفرد.
ومن الضروري أيضًا تحديد مفهوم "الشخصية"، ويتم تحديده اعتمادًا على النهج المتبع في طبيعة الإنسان وجوهره. في الفلسفة الروسية الحديثة، في أعقاب تقليد الماركسية، تعد الشخصية شخصا ككائن اجتماعي، حيث يتم تقليل جوهره إلى الاشتراكية. في التيارات التي تربط الجوهر بالروحانية، تكون الشخصية هي الشخص ككائن روحي وعقلاني، وما إلى ذلك. وبعبارة أخرى، لا تُفهم الشخصية على أنها " رجل متميز"، ولكنها سمة أساسية للشخص. ويمكن أيضًا اعتبار الشخصية شخصية بشكل عام وشخصية تاريخية محددة وشخصية الفرد.
الفردية هي التفرد الشامل وأصالة الفرد، على عكس النموذجية والمجتمع.
2. مشكلة بداية الإنسان. جوهر نظرية الأنثروبوسوسيوجينيسيس
في الدراسة الفلسفية للإنسان، هناك مشكلة بيولوجية اجتماعية. انها لديها أهمية عظيمةلممارسة التعليم، لأنه من سمات الطبيعة البشرية.
المشكلة البيولوجية والاجتماعية هي مشكلة العلاقة والتفاعل بين ما هو اجتماعي وبيولوجي، مكتسب وموروثة، "ثقافي" و"بري" في الإنسان.
من المعتاد أن نفهم من الناحية البيولوجية في الشخص تشريح جسده والعمليات الفسيولوجية فيه. تشكل القوى الطبيعية للإنسان ككائن حي. تؤثر العوامل البيولوجية على شخصية الشخص وتطور قدرات معينة: الملاحظة، وأشكال التفاعل مع العالم الخارجي. تنتقل كل هذه القوى من الوالدين وتمنح الشخص إمكانية الوجود في العالم.
من خلال الاجتماعي في الإنسان، تفهم الفلسفة، أولا وقبل كل شيء، قدرته على التفكير والتصرف العملي. وهذا يشمل الروحانية والموقف تجاه العالم الخارجي والموقف المدني. كل هذا يشكل معًا قوى اجتماعية إنسانية. يكتسبها في المجتمع من خلال آليات التنشئة الاجتماعية، أي. مدخل إلى عالم الثقافة باعتباره بلورة للتجربة الروحية والعملية للإنسانية، ويتم تحقيقه في سياق الأنشطة المختلفة.
هناك ثلاثة مواقف مشتركة بشأن مسألة العلاقة بين الاجتماعي والبيولوجي.
النهج الأول هو التفسير البيولوجي للإنسان (S. Freud، F. Galton). يقترح اعتبار صفاته الطبيعية هي الصفات الرئيسية في الإنسان. كل شيء في سلوك الإنسان وتصرفاته يرجع إلى معطياته الجينية الموروثة.
النهج الثاني هو التفسير الاجتماعي السائد للإنسان (T. More، T. Campanella). أنصارها إما ينكرون المبدأ البيولوجي في الإنسان تمامًا أو يقللون من أهميته بشكل واضح.
النهج الثالث لحل مشكلة بيولوجية اجتماعية يحاول تجنب التطرف المذكور أعلاه. يتميز هذا الموقف بالرغبة في النظر إلى الشخص على أنه توليفة معقدة وتشابك بين المبادئ البيولوجية والاجتماعية. ومن المسلم به أن "الإنسان يعيش في نفس الوقت وفق قوانين عالمين: الطبيعي والاجتماعي". ولكن يتم التأكيد على أن الصفات الأساسية (القدرة على التفكير والتصرف بشكل عملي) لا تزال ذات أصل اجتماعي.
في القرن 20th يتغير المبدأ البيولوجي لدى الشخص بسرعة كبيرة تحت التأثير النشط للعوامل الاجتماعية والتكنولوجية والتكنولوجية غير المواتية العوامل البيئية. هذه التغييرات أصبحت سلبية على نحو متزايد.
طبيعي في الرجل - شرط ضروريتنمية صفاته الاجتماعية لدى الفرد. جوهر المشكلة الاجتماعية الحيوية هو أن الشخص، لكي يبقى إنسانا، يجب أن يحافظ على طبيعته البيولوجية كأساس للوجود. وتتمثل المهمة في الجمع بين ما هو طبيعي واجتماعي في الإنسان، وإدخالهما في حالة من الانسجام والانسجام.
إن القوى الأساسية للإنسان تخلق له كل الإمكانيات الذاتية اللازمة ليكون حرا، أي. تصرف في العالم كما يحلو لك. إنها تسمح له بوضع نفسه والعالم من حوله تحت سيطرة معقولة، والتميز عن هذا العالم وتوسيع نطاق أنشطته الخاصة. إن أصول كل انتصارات الإنسان ومآسيه، وكل صعوده وهبوطه، متجذرة في هذه الفرصة للتحرر.
دعونا نفكر في النقاط الرئيسية وجوهر نظرية التكوين البشري. أولاً، دعونا نحدد مصطلح "النشوء البشري".
إن عملية تكوين الإنسان هي عملية مزدوجة لتكوين الإنسان (التكوين البشري) وتكوين المجتمع (التكوين الاجتماعي).
بدأت دراسة مشاكل التولد البشري في القرن الثامن عشر. وحتى هذا الوقت، كانت الفكرة السائدة هي أن الإنسان والشعوب كانوا وما زالوا كما خلقهم الخالق. ومع ذلك، تدريجيا، تم تأسيس فكرة التنمية والتطور، بما في ذلك فيما يتعلق بالإنسان والمجتمع، في العلم والثقافة والوعي العام.
في منتصف القرن الثامن عشر، وضع سي. لينيوس الأساس للفكرة العلمية عن أصل الإنسان. وفي كتابه «نظام الطبيعة» (1735)، صنف الإنسان ضمن عالم الحيوان، ووضعه في تصنيفه بجوار القردة العليا. كما ظهر علم الرئيسيات العلمي في القرن الثامن عشر؛ لذلك ظهر عام 1766 عمل علميجي بوفون عن إنسان الغاب. أظهر عالم التشريح الهولندي ب. كامبر أوجه تشابه عميقة في بنية الأعضاء الرئيسية للإنسان والحيوان.
في القرن الثامن عشر - النصف الأول من القرن التاسع عشر، جمع علماء الآثار وعلماء الحفريات وعلماء الإثنوغرافيا كمية كبيرة من المواد التجريبية، التي شكلت الأساس لعقيدة تكوين الإنسان. لعبت الأبحاث التي أجراها عالم الآثار الفرنسي باوتشر دي بيرت دورًا رئيسيًا. في الأربعينيات والخمسينيات. في القرن التاسع عشر، بحث عن الأدوات الحجرية وأثبت أنها كانت تستخدم من قبل الإنسان البدائي، الذي عاش في نفس الوقت الذي عاش فيه الماموث، وما إلى ذلك. وقد دحضت هذه الاكتشافات التسلسل الزمني الكتابي ولاقت مقاومة عنيفة. فقط في الستينيات. في القرن التاسع عشر، تم الاعتراف بأفكار بوشيه دي بيرت في العلوم.
لكن حتى لامارك لم يجرؤ على الوصول إلى نتيجتها المنطقية لفكرة تطور الحيوانات والبشر وإنكار دور الله في أصل الإنسان (في كتابه “فلسفة علم الحيوان” كتب عن فكرة مختلفة أصل الإنسان وليس من الحيوان إلا).
لعبت أفكار داروين دورًا ثوريًا في عقيدة تكوين الإنسان. لقد كتب: “إن من لا ينظر، كالهمجي، إلى ظواهر الطبيعة كشيء غير متماسك، لم يعد بإمكانه أن يعتقد أن الإنسان هو ثمرة عمل خلقي منفصل”.
الإنسان كائن بيولوجي واجتماعي في نفس الوقت، وبالتالي فإن التولد البشري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتكوين الاجتماعي، وهو ما يمثل في الأساس عملية واحدة من التولد الاجتماعي.
وبالتالي، يمكننا القول أن تكوين الإنسان هو عملية التكوين التاريخي والتطوري للنوع الجسدي للشخص، والتطور الأولي لنشاط عمله، وكلامه، ومجتمعه.
إن تكوين الإنسان هو انتقال من الشكل البيولوجي لحركة المادة إلى شكل منظم اجتماعيًا ، ومحتواه هو ظهور وتشكيل الأنماط الاجتماعية وإعادة الهيكلة والتغيير القوى الدافعةالتطورات التي حددت اتجاه التطور. تتطلب هذه المشكلة النظرية العامة المعقدة تجميعًا لإنجازات العلوم المختلفة لحلها. السؤال المركزي للتكوين البشري هو مشكلة القوى والأنماط الدافعة. وبما أن القوى الدافعة للتطور ليست ثابتة، فلا يمكن دراستها إلا عمليًا، أي في الوقت الحالي، بناءً على الاستقراء. يتم إعادة بناء الصورة العامة للتكوين البشري على أساس بيانات غير مكتملة جغرافيًا (لا تزال مساحات شاسعة من آسيا وأفريقيا غير مستكشفة) وتسلسلًا زمنيًا، حيث يتم ملء الفجوات بفرضيات أكثر أو أقل احتمالية. ينبع الخلل في المعلومات من الطبيعة المتفرقة للاكتشافات في كل موقع. يختلف الأفراد كثيرًا عن بعضهم البعض، ولا يمكن الحصول على صورة جماعية لمجموعة محلية إلا من خلال الاعتماد على بيانات العديد من الأفراد.
تشير أحدث البيانات الأنثروبولوجية القديمة إلى تعدد الاتجاهات وعدم انتظام عملية الأنسنة، والتي يمكن من خلالها تتبع العناصر الفردية لمجمع الإنسان بالفعل في أقدم الحفريات، ويمكن أن يكون تكوين متغيرات لاحقة لتوحيد الشخصيات العاقلة قد حدث لفترة طويلة الوقت بالتوازي في مناطق مختلفة. في التفسيرات الحديثة للمواد الحفريات البشرية المعيار المورفولوجيلا يزال أساسيا في الوقت الراهن، ولكن مع مزيد من التقدم في الكيمياء الحيوية و البحوث الجينيةسوف يزداد دور المبدأ الوراثي في تصنيف البشر.
الأنثروبوسوسيوجينيسيس هي حالة انتقالية للمادة. تمثل أي حالة انتقالية حلقة في سلسلة تطور كائن أو ظاهرة، حيث لم يتم التعبير بوضوح بعد عن علامات الجودة الجديدة، ولم تكشف عن نفسها على أنها عكس الجودة القديمة، ولم تتعارض معها . هناك طريقتان لمشكلة أنماط الحالات الانتقالية:
1) تتحدد الحالات الانتقالية بمجموعة قوانين للحركة الأولية والعليا، على أن يحتفظ كل قانون بطبيعته ومنطقة نفوذه. من هذه المواقف، يعتبر التكوّن البشري بمثابة عملية تخضع لسيطرة قوانين مختلفة في طبيعتها: الاجتماعية (نشاط العمل) والبيولوجية (الانتقاء الطبيعي)؛
2) هناك أنماط خاصة للفترة الانتقالية كأنماط محددة للتكوين البشري.
ونظرا لعدم وجود بيانات مباشرة عن طبيعة العلاقات الاجتماعية في الحقبة الأولى من تاريخ البشرية، لا يمكن الاعتماد إلا على البيانات غير المباشرة. ولكن حتى لو كان من الممكن تفسير البيانات المباشرة (بقايا الأشخاص وآثار أنشطتهم) بطرق مختلفة، فهذا ينطبق بشكل أكبر على البيانات غير المباشرة (بيانات من علم وظائف الأعضاء وعلم الأخلاق والإثنوغرافيا). إن أي إعادة بناء أكثر أو أقل تفصيلاً لعملية التكوين الاجتماعي هي حتماً افتراضية.
في الظروف التي تكون فيها البيانات قليلة وكلها غير مباشرة، تصبح المبادئ النظرية العامة التي توجه الباحث ذات أهمية قصوى. وهذا يعني أنه عند حل مشكلة النشوء البشري وقواه الدافعة، فإن الاتصال بمجال الفئات الفلسفية والقوانين العامة للكون أمر لا مفر منه.
3. جوهر الوجود الإنساني
طوال تاريخ البشرية، يسأل الناس أنفسهم باستمرار: لماذا نعيش؟ الشخص الذي يريد أن يكون واعيًا بنفسه وبالعالم من حوله سيكون دائمًا مهتمًا بمعنى وجوده وكل الأشياء. هل لحياة الإنسان أي معنى؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما معنى الحياة ومما تتكون، وهل لها مضمون عالمي مجرد أم أنها خاصية فريدة لحياة كل إنسان؟
على عكس الكائنات الحية الأخرى، فإن الإنسان يدرك حياته الخاصة. يتم التعبير عن موقف الإنسان ككائن واعي تجاه حياته ونفسه في معنى حياته والغرض منها. "إن معنى الحياة هو القيمة (القيم) المدركة التي يخضع لها الإنسان حياته، والتي من أجلها يضع ويحقق أهداف الحياة." إنها ذات طبيعة وظيفية، فهي تنشأ فقط لشخص لا "يعيش فقط"، ولكنه يعكس، يشعر أنه يحتاج إلى العيش من أجل شيء ما. المعنى هو عنصر من عناصر مجال القيمة التحفيزية للحياة الروحية للشخص.
يقترب الفلاسفة من فهم هذه المشكلة، وبالتالي حلها من موقعين مختلفين: من وجهة نظر الفرد والإنسان ككائن عام، أي الإنسانية.
في الفهم الأول، معنى الحياة هو عنصر من عناصر الحياة الروحية الداخلية الفريدة للفرد، وهو ما يصوغه لنفسه، بغض النظر عن أنظمة القيم الاجتماعية السائدة. من هذه المواقف، من المستحيل التحدث عن معنى واحد للحياة للجميع. ويكتشفها كل فرد في أفكاره وتجاربه الخاصة، فيبني التسلسل الهرمي للقيم الخاص به.
أ. كامو، الذي احتلت مسألة معنى الحياة مكانًا مركزيًا في عمله، يحلها بشكل متناقض: بحجة أن العالم سخيف وفوضوي، وبالتالي فإن الإيمان بمعنى الحياة هو أيضًا أمر سخيف، فإنه لا يزال يجد معنى الحياة الحياة في تمرد ضد العبث. ردا على سؤال حول ما تعنيه الحياة في عالم سخيف، يكتب: "لا شيء سوى اللامبالاة بالمستقبل والرغبة في استنفاد كل ما هو معطى. الإيمان بمعنى الحياة يفترض دائمًا مقياسًا للقيم والاختيار والتفضيل. الإيمان في العبث، بحكم تعريفه، يعلمنا العكس تمامًا"؛ "إن تجربة حياتك، وتمردك، وحريتك على أكمل وجه ممكن يعني أن تعيش، وعلى أكمل وجه"؛ "التمرد هو الثقة في قوة القدر الساحقة، ولكن من دون التواضع الذي يصاحبه عادة... هذا التمرد يعطي قيمة للحياة."
وهذا الموقف هو أيضًا سمة من سمات الفلاسفة الوجوديين الآخرين. إنهم يربطون الهدف الإنساني، الوجود الإنساني الأصيل مع ملء الخبرة الحياة الخاصة، مع البحث عن "الذات الشخصية" الفريدة وإظهارها من خلال التمرد والنضال والحب والمعاناة والارتفاع في الفكر والإبداع وفرحة تحقيق الذات.
إن الفهم الوجودي لمعنى الحياة يعارض الرغبة في فرض مملكة الحقيقة والمعنى "المكتشف أخيرًا" من قبل شخص ما. كتب الفيلسوف الروسي س. ل. فرانك: «هؤلاء المنقذون، كما نرى الآن، بالغوا في كراهيتهم العمياء إلى حد لا يقاس في شر الماضي، وشر كل الحياة التجريبية، المتحققة بالفعل، التي أحاطت بهم، وبالغت أيضًا في تضخيمهم في كبريائهم الأعمى بقواهم العقلية والأخلاقية."
إن الوعي بمعنى الوجود هو عمل متواصل لفهم وإعادة التفكير في القيم التي يعيش الإنسان من أجلها. وتسير عملية البحث بالتوازي مع تنفيذها، ونتيجة لذلك تتم إعادة تقييم القيم وإعادة تشكيل الأهداف والمعاني الأصلية. يسعى الشخص إلى جعل أنشطته تتماشى معها أو يغير الأهداف والمعاني ذاتها.
وفي الوقت نفسه، فإن معنى الوجود الإنساني موجود أيضًا كظاهرة لوعي الجنس البشري. ويمثل بحثه الجانب الثاني من فهم مسألة معنى الحياة. يتم إعدادهم من خلال العملية الطويلة لتطور الإنسان، وتطوير القدرة الانعكاسية لتفكيره، وتكوين الوعي الذاتي. تاريخيا، أصبحت الأفكار الدينية هي الشكل الأول للوعي بمشكلة معنى الوجود الإنساني، ولماذا هو مطلوب. وفيما بعد أصبحت الفلسفة رفيقتهم وخصمهم.
لقد احتفظت الفلسفة الدينية بأكبر قدر من الإخلاص في البحث عن المعنى العالمي المجرد للحياة البشرية. إنه يربط معنى الحياة البشرية بالتأمل وتجسيد المبدأ الإلهي للإنسان في الإيمان، في السعي وراء الأضرحة الفائقة للإنسان، في الشركة مع الحقيقة والخير الأسمى. وفقًا لـ ف.س. يقول سولوفيوف: "إن معنى الحياة لا يمكن أن يتطابق مع المطالب التعسفية والمتغيرة لكل فرد من أفراد الجنس البشري الذين لا يحصى عددهم".
على الرغم من أن البحث عن المعنى المجرد والعالمي للحياة البشرية قد حظي تقليديًا بأكبر قدر من الاهتمام في الفلسفة الدينية، إلا أنه سيكون من الخطأ إنكار مساهمة مفكري الاتجاه الإلحادي. وهكذا، في الفلسفة الماركسية، يُرى معنى الحياة الإنسانية في الإدراك الذاتي للقوى الأساسية للإنسان من خلال نشاطه التحويلي النشط. موقف مماثل للفيلسوف والمحلل النفسي إي. فروم: "معنى الحياة هو في تطور الإنسانية: العقل، الإنسانية، حرية الفكر".
إن الجانبين المدروسين لحل مسألة معنى الحياة ليسا متعارضين. إنهم يكملون بعضهم البعض، ويكشفون عن جوانب مختلفة لهذه القضية.
السؤال عن معنى الوجود هو أيضًا سؤال عن معنى موت الإنسان وخلوده. إن معنى الحياة يتحدد ليس فقط فيما يتعلق بالواقع، ولكن أيضا فيما يتعلق بالزمن الأبدي، الذي لم يعد فيه فرد حي جسديا. إن فهم معنى الوجود يعني تحديد مكانك في التدفق الأبدي للتغييرات. إذا لم يترك الإنسان ظلاً بعد حياته، فإن حياته بالنسبة إلى الأبدية كانت مجرد وهم.
إن مشكلة معنى وجود الإنسان وموته لن تفقد أهميتها أبدًا. بالنسبة للإنسانية، التي تتسارع حركتها نحو المرتفعات التقنية والمعلوماتية، فهي ملحة بشكل خاص.
الاستنتاجات
إن العلاقة بين الإنسان والفلسفة هي تعبير عن جوهر الثقافة الفلسفية. الثقافة الفلسفية هي شكل من أشكال معرفة الإنسان لذاته ونظرته للعالم وتوجهه القيمي في العالم. لذلك، يكون الإنسان دائمًا في أساس التوجه الفلسفي، فهو يعمل كشرط أساسي إنساني طبيعي له، وكهدف طبيعي، والمهمة العليا للفلسفة.
بمعنى آخر، الشخص هو موضوع وموضوع للمعرفة الفلسفية. بغض النظر عن القضايا المحددة التي تتعامل معها الفلسفة في مرحلة أو أخرى من تطورها، فإنها تتخللها دائمًا الحياة البشرية الحقيقية والرغبة في حل المشكلات الإنسانية الملحة. إن ارتباط الفلسفة بالإنسان واحتياجاته واهتماماته ثابت ودائم.
الإنسان ليس مجرد حيوان بيولوجي أو شخص اجتماعي تمامًا. الإنسان عبارة عن مزيج فريد من الخصائص البيولوجية والاجتماعية المتأصلة فيه فقط دون غيره من بين الكائنات الحية التي تسكن الأرض. الإنسان كائن اجتماعي حيوي، ومحاولة رفض أحد مبادئه الأصلية ستؤدي في النهاية إلى انهيار الشخصية: لا يمكن للمرء أن يتجنب إلى الأبد الرغبات "الحيوانية"، ولا يمكن للمرء أن يعيش إلى الأبد "مثل الحيوان".
أسأل نفسي السؤال: لماذا ولدت ولماذا أعيش على الأرض، لا أستطيع إعطاء إجابة محددة. ما يتبادر إلى الذهن أولاً يتم رفضه على الفور بعد بعض التفكير المعقول في هذه الأسباب. أعترف أنهم مخطئون ولا يمكن أن يكونوا إجابة جدية على هذا السؤال. لكن كلما فكرت في إجابة هذا السؤال، كلما أدركت أنني لا أعرف ذلك على وجه اليقين، كما لم يعرفه الآخرون قبلي، كما لن يعرفوا مرة أخرى لفترة طويلةبعدي.
الأدب
1. Berdyaev N. A. عن غرض الإنسان // العلوم الفلسفية، 1999، رقم 2.
2. Erygin A. E. أساسيات الفلسفة: كتاب مدرسي. - م: "دار النشر داشكوف وك"، 2006.
3. إيفيموف يو.آي. المشاكل الفلسفيةنظريات تكوين الإنسان. ل.: ناوكا، 1981.
4. كرابيفنسكي إس.إي. الدورة العامة للفلسفة. – فولجوجراد: دار فولجوجرادسكي للنشر جامعة الدولة, 1998.
5. Solopov E. F. الفلسفة. – سانت بطرسبورغ: بيتر، 2004.
6. الفلسفة / إد. Tsaregorodtseva G.I. - M.: "دار النشر Dashkov and K"، 2003.
7. الفلسفة: دورة المحاضرات: كتاب مدرسي للجامعات / إد. في إل. كلاشينكوف. - م: فلادوس، 2002.
8. فرانك إس. إل. معنى الحياة // أسئلة الفلسفة. 1990، رقم 6.
9. خروستاليف يو.م. الدورة العامة للفلسفة. - م: إنفرا-م، 2004.
10. المعجم التوضيحي لمصطلحات العلوم الاجتماعية. – سانت بطرسبورغ: بيتر، 1999.
"الرجل" كموضوع للبحث
هناك عدد كبير من المفاهيم الفلسفية لـ "الإنسان". في علم الاجتماع وعلم النفس، لا توجد وجهات نظر مختلفة أقل حول "الإنسان" ومحاولات لوصف خصائصه وصفاته المختلفة بشكل أو بآخر. كل هذه المعرفة، كما قلنا، لا يمكن أن ترضي علم أصول التدريس، وبنفس الطريقة، عندما ترتبط ببعضها البعض، لا تصمد أمام النقد المتبادل. إن تحليل وتصنيف هذه المفاهيم ووجهات النظر، بالإضافة إلى تفسير سبب عدم قدرتها على توفير المعرفة التي ترضي أصول التدريس، هو مسألة بحث خاص وموسع للغاية، ويتجاوز نطاق هذه المقالة بكثير. لا يمكننا الدخول في مناقشة هذا الموضوع حتى في أقسى التقريبات وسنتخذ مسارًا مختلفًا جذريًا: سوف نقدم، بناءً على أسس منهجية معينة (ستصبح أكثر وضوحًا)، ثلاث أفكار قطبية، وهمية في الأساس وغير متناظرة. لأي من تلك المفاهيم الحقيقية التي كانت موجودة في تاريخ الفلسفة والعلوم، ولكنها ملائمة جدًا للوصف الذي نحتاجه للوضع العلمي المعرفي الحقيقي الموجود الآن.
وبحسب أول هذه الأفكار فإن "الإنسان" هو عنصر من عناصر النظام الاجتماعي، و"جزء" من كائن حي واحد ومتكامل للإنسانية، يعيش ويعمل.
نهاية الصفحة 96
أعلى الصفحة 97
وفقا لقوانين هذا كله. وبهذا النهج، فإن الواقع الموضوعي "الأول" لا يتمثل في الأفراد الأفراد، بل في الموضوع الرئيسي للإنسانية برمته، و"اللوياثان" بأكمله؛ يمكن عزل الأفراد كأشياء ولا يمكن اعتبارهم إلا فيما يتعلق بهذا الكل، باعتباره "أجزائه"، أو أعضائه، أو "تروسه".
وفي الحالة القصوى، فإن وجهة النظر هذه تختزل البشرية إلى بنية متعددة تتكاثر، أي تستمر وتتطور، على الرغم من التغير المستمر للمادة البشرية، والأفراد إلى أماكن في هذا الهيكل لا تملك سوى خصائص وظيفية تولدها الروابط المتقاطعة. والعلاقات داخلها. صحيح، إذن - وهذا طبيعي تماما - الآلات، وأنظمة الإشارة، "الطبيعة الثانية"، وما إلى ذلك، تبين أنها نفس العناصر المكونة للإنسانية مثل الناس أنفسهم؛ يعمل الأخير كنوع واحد فقط من مواد ملء الأماكن، متساوية فيما يتعلق بالنظام مع جميع الآخرين. ولذلك، ليس من المستغرب أن في وقت مختلفيتم شغل نفس الأماكن (أو ما شابه ذلك) في البنية الاجتماعية مواد مختلفة: فيأخذ الناس مقام "الحيوانات"، كما كان الحال مع العبيد في روما القديمةثم يتم وضع "الآلات" في مكان "الحيوانات" و "الناس" أو على العكس من ذلك، يتم وضع الناس في مكان "الآلات". وليس من الصعب أن نلاحظ أن هذه الفكرة، على الرغم من طبيعتها المتناقضة، تجسد جوانب الحياة الاجتماعية المقبولة عمومًا والتي لا يتم وصفها أو تفسيرها بأفكار أخرى.
أما الرأي الثاني، فهو على العكس من ذلك، يرى أن الفرد هو الحقيقة الموضوعية الأولى، ويمنحه خصائص مستمدة من التحليل التجريبي، ويعتبره في شكل كائن حي مستقل معقد للغاية، يحمل في داخله جميع الخصائص المحددة للفرد. الانسان". يتبين بعد ذلك أن الإنسانية ككل ليست أكثر من عدد كبير من الأشخاص الذين يتفاعلون مع بعضهم البعض. بمعنى آخر، مع هذا النهج، يصبح كل فرد جزيءًا، والبشرية جمعاء تشبه غازًا يتكون من جزيئات متحركة بشكل فوضوي وغير منظم. وبطبيعة الحال، ينبغي النظر هنا إلى قوانين الوجود الإنساني على أنها نتيجة للسلوك والتفاعل المشترك فرادى، في الحالة المقيدة - كتراكب أو آخر لقوانين حياتهم الخاصة.
هاتان الفكرتان عن "الإنسان" تتعارضان مع بعضهما البعض.
نهاية الصفحة 97
أعلى الصفحة 98
قو على أساس منطقي واحد. الأول يتم بناؤه بالانتقال من الكل الموصوف تجريبيًا إلى العناصر المكونة له، لكن في الوقت نفسه لا يمكن الحصول على العناصر نفسها - فهي لا تظهر - ولا يبقى سوى الهيكل الوظيفي للكل، فقط "شبكة" "من الاتصالات والوظائف التي تنشئها؛ على وجه الخصوص، في هذا المسار، لا يمكن أبدا شرح الشخص نفسه كشخص، ونشاطه، الذي لا يطيع قوانين الكل الذي يبدو أنه يعيش فيه، ومعارضته ومعارضته لهذا الكل. تم بناء الفكرة الثانية من خلال الانتقال من العناصر التي تتمتع بالفعل بخصائص "خارجية" معينة، على وجه الخصوص، من "شخصية" الفرد إلى الكل، والتي يجب جمعها وبنائها من هذه العناصر، ولكنها في نفس الوقت ليس من الممكن أبدًا الحصول على مثل هذا الهيكل للكل ونظام التنظيم الذي يشكله، والذي يتوافق مع ظواهر الحياة الاجتماعية التي تمت ملاحظتها تجريبيًا، على وجه الخصوص، ليس من الممكن تفسير واستخلاص الإنتاج والثقافة والمنظمات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع، ولهذا السبب، تظل "الشخصية" الموصوفة تجريبيا نفسها غير قابلة للتفسير.
على الرغم من الاختلاف في النقاط المشار إليها أعلاه، إلا أن هاتين الفكرتين تتطابقان من حيث أنهما لا تصفان أو تشرحان البنية "المادية" الداخلية للأفراد وفي نفس الوقت لا تثيران على الإطلاق مسألة الروابط والعلاقات بين 1) " "البنية الداخلية" لهذه المادة، 2) الخصائص "الخارجية" للأفراد كعناصر للكل الاجتماعي و 3) طبيعة بنية هذا الكل.
وبما أن أهمية المادة البيولوجية في حياة الإنسان لا جدال فيها من الناحية التجريبية، وأن الفكرتين النظريتين الأوليين لا تأخذانها في الاعتبار، فمن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى ظهور فكرة ثالثة معارضة لهما، ترى في الإنسان في المقام الأول فكرة بيولوجية. فهو "حيوان" وإن كان اجتماعيا، ولكنه في الأصل لا يزال حيوانا، وهو حتى الآن محتفظ بطبيعته البيولوجية التي تضمن حياته العقلية وجميع الروابط والوظائف الاجتماعية.
وبالإشارة إلى وجود معلمة ثالثة تدخل في تعريف "الإنسان" وأهميتها التي لا جدال فيها في تفسير كافة آليات وأنماط الوجود الإنساني، فإن وجهة النظر هذه، مثل الأولين، لا تستطيع تفسير الارتباطات والعلاقات بين العوامل البيولوجية.
نهاية الصفحة 98
أعلى الصفحة 99
ركيزة الإنسان ونفسيته وبنيته الاجتماعية الإنسانية؛ فهو يفترض فقط ضرورة وجود مثل هذه الروابط والعلاقات، لكنه لم يؤكدها بعد بأي شكل من الأشكال أو يميزها بأي شكل من الأشكال.
لذلك، هناك ثلاثة تمثيلات قطبية لـ "الإنسان". أحدهما يُعطى بالأداة المادية، في شكل "كائن حي"، والثاني يرى في الإنسان مجرد عنصر من عناصر النظام الاجتماعي الإنساني المنظم بشكل صارم، ولا يمتلك أي حرية واستقلال، "فرد" مجهول الهوية وغير شخصي (في الحد - "مكان وظيفي" خالص في النظام)، والثالث يصور الشخص على أنه جزيء منفصل ومستقل، يتمتع بنفسية ووعي، وقدرات على سلوك وثقافة معينة، ويتطور بشكل مستقل ويدخل في اتصالات مع جزيئات أخرى مماثلة في شكل "شخصية" حرة وذات سيادة. تسلط كل فكرة من هذه الأفكار الضوء على بعض الخصائص الحقيقية للشخص وتصفها، ولكنها تأخذ جانبًا واحدًا فقط، دون ارتباطات وتبعيات مع جوانب أخرى. لذلك، تبين أن كل واحد منهم غير مكتمل ومحدود للغاية، ولا يمكن أن يعطي صورة شاملة للشخص. وفي الوقت نفسه، فإن متطلبات "تكامل" و"اكتمال" الأفكار النظرية حول الإنسان لا تنشأ حتى من الاعتبارات النظرية والمبادئ المنطقية، بل من احتياجات الممارسة والهندسة الحديثة. لذلك، على وجه الخصوص، كل فكرة من الأفكار الإنسانية المذكورة أعلاه ليست كافية لأغراض العمل التربوي، ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن أن يساعدها الارتباط الميكانيكي البحت بينها وبين بعضها البعض، لأن جوهر العمل التربوي هو تشكل قدرات عقلية معينة للفرد، والتي من شأنها أن تتوافق مع الروابط والعلاقات التي يجب أن يعيش من خلالها هذا الشخص في المجتمع، ولهذا تشكل هياكل وظيفية معينة على "الحيوية الحيوية"، أي على المادة البيولوجية للشخص. بمعنى آخر، يجب على المعلم أن يعمل عمليًا فورًا على جميع المعرفة التي سيتم من خلالها تسجيل المراسلات بين المعلمات المتعلقة بهذه "الشرائح" الثلاث.
ولكن هذا يعني، كما قلنا من قبل، أن علم التربية يتطلب معرفة علمية عن الإنسان من شأنها أن توحد الأفكار الثلاثة المذكورة أعلاه [عن الإنسان]، وتجمعها في فكرة واحدة ملموسة ومتعددة الأوجه.
نهاية الصفحة 99
أعلى الصفحة 100
المعرفة النظرية: هذه هي المهمة التي يفرضها علم أصول التدريس على العلوم "الأكاديمية" المتعلقة بـ"الإنسان".
لكن اليوم لا تستطيع الحركة النظرية حلها، لأنه لا توجد وسائل وأساليب تحليل وتصميم ضرورية لذلك. ويجب حل المشكلة أولا على المستوى المنهجي، وتطوير وسائل للحركة النظرية اللاحقة، ولا سيما على مستوى منهجية البحث البنيوي النظامي.
من هذا الموقف، تظهر مشاكل تجميع المفاهيم النظرية القطبية الموصوفة أعلاه بشكل مختلف - مثل مشاكل بناء نموذج هيكلي للشخص حيث 1) ثلاث مجموعات من الخصائص ستكون مرتبطة عضويا: الروابط الهيكلية S،
للنظام المحيط، "الوظائف الخارجية" f 1 لعنصر النظام و"المورفولوجيا الهيكلية" للعنصر L (خمس مجموعات من الخصائص، إذا قمنا بتمثيل التشكل الهيكلي للعنصر في شكل نظام من الاتصالات الوظيفية s q p المضمنة على المادة م ع) وفي نفس الوقت 2) تم استيفاء متطلبات إضافية، ناشئة عن الطبيعة المحددة للإنسان، ولا سيما إمكانية أن يشغل نفس العنصر "أماكن" مختلفة من الهيكل، كما هو الحال عادة في المجتمع، القدرة على الانفصال عن النظام، والوجود خارجه (على أي حال،
نهاية الصفحة 100
أعلى الصفحة 101
خارج علاقاته وارتباطاته المحددة)، يواجهه ويعيد بناءه.
ربما يمكن القول أنه لا توجد اليوم وسائل وأساليب عامة لحل هذه المشكلات، حتى على المستوى المنهجي.
لكن الأمر يزداد تعقيدًا بسبب حقيقة أن المعرفة التجريبية والنظرية، التي تطورت تاريخيًا في العلوم حول "الإنسان" و"الإنسان" - في الفلسفة وعلم الاجتماع والمنطق وعلم النفس واللسانيات، وما إلى ذلك - قد تم بناؤها وفقًا لمخططات تصنيفية أخرى. ولا يتوافق مع الأشكال النقية لخصائص الكائن الهيكلي للنظام؛ إن هذه المعرفة، في معناها الموضوعي، تتوافق مع المحتوى الذي نريد تسليط الضوء عليه وتنظيمه في المعرفة التركيبية الجديدة عن الإنسان، لكن هذا المحتوى مؤطر في مثل هذه المخططات الفئوية التي لا تتوافق مع المهمة الجديدة والشكل الضروري لتوليف الماضي. المعرفة في معرفة واحدة جديدة. لذلك، عند حل المشكلة المطروحة أعلاه، أولاً، سيكون من الضروري إجراء تنظيف أولي وتحليل لجميع المعرفة الخاصة بالموضوع من أجل تحديد الفئات التي تم بناؤها من خلالها وربطها بجميع المعرفة المحددة وغير المحددة. فئات محددة من البحوث البنيوية النظامية، وثانيًا، سيتعين علينا حساب الوسائل والأساليب المتاحة لهذه العلوم، والتي قامت بتحليل "الإنسان" بشكل لا يتوافق مع جوانب ومستويات التحليل البنيوي للنظام، ولكن بما يتوافق مع التقلبات التاريخية في تشكيل موضوعات بحثهم.
إن التطور التاريخي للمعرفة حول الإنسان، سواء في مجموعها أو في موضوعاتها الفردية، له منطقه وأنماطه الضرورية. وعادة ما يتم التعبير عنها بالصيغة: "من الظاهرة إلى الجوهر". ولجعل هذا المبدأ عمليًا وعمليًا في دراسات محددة في تاريخ العلوم، من الضروري بناء صور للمعرفة ذات الصلة وموضوعات الدراسة، وتقديمها في شكل "كائنات" أو "آلات علمية" وإظهار كيف يمكن لهذه تتطور الأنظمة العضوية، ويعاد بناء الأنظمة الشبيهة بالآلات، وتولد في داخلها معرفة جديدة عن الإنسان، ونماذج ومفاهيم جديدة. في هذه الحالة، سيتعين إعادة بنائها وتصويرها في مخططات خاصة؛ جميع عناصر نظم العلوم والمواد العلمية: تجريبية
نهاية الصفحة 101
أعلى الصفحة 102
المواد التي يتعامل معها العديد من الباحثين، والمشاكل والمهام التي يطرحونها، والوسائل التي يستخدمونها (بما في ذلك المفاهيم وأنظمة التشغيل)، وكذلك التعليمات المنهجية التي ينفذون بموجبها "إجراءات التحليل العلمي".
بطريقة أو بأخرى، كما يصف هوبز، تم تمييز الشخص ذات مرة، منذ فترة طويلة جدًا، باعتباره موضوعًا تجريبيًا للملاحظة والتحليل، وهكذا، على أساس إجراء تأملي معقد للغاية، بما في ذلك لحظة من التأمل، تشكلت المعرفة الأولى عنه. لقد جمعوا بشكل توفيقي بين خصائص المظاهر الخارجية للسلوك (خصائص الأفعال) وخصائص محتويات الوعي (الأهداف، والرغبات، ومعنى المعرفة المفسر بموضوعية، وما إلى ذلك). إن استخدام هذه المعرفة في ممارسة الاتصال لم يسبب صعوبات ولم يخلق أي مشاكل. في وقت لاحق فقط، في المواقف الخاصة التي لا نقوم بتحليلها الآن، تم طرح السؤال المنهجي والفلسفي الفعلي: "ما هو الشخص؟"، والذي وضع الأساس لتشكيل الموضوعات الفلسفية ثم العلمية. ومن المهم التأكيد على أن هذا السؤال لم يطرح فيما يتعلق بالأشخاص الموجودين فعليا، بل فيما يتعلق بالمعرفة عنهم التي كانت موجودة في ذلك الوقت، وكان يتطلب خلق مثل هذه الفكرة العامة عن الشخص أو مثل هذا النموذج منه ما يفسر طبيعة المعرفة الموجودة ويزيل التناقضات التي ظهرت فيها (قارن ذلك باستدلالنا حول شروط ظهور مفهومي “التغيير” و”التطور” في الجزء السابع من المقال).
إن طبيعة وأصل مثل هذه المواقف، التي تؤدي إلى السؤال الفلسفي أو "الميتافيزيقي" الفعلي حول ماهية الشيء قيد الدراسة، قد تم وصفها بالفعل في عدد من أعمالنا.
(2). علاقة الجسم بالبيئة. هنا عضوا العلاقة غير متساويين بالفعل؛ الموضوع أساسي وأولي، يتم تعيين البيئة فيما يتعلق به، كشيء له أهمية معينة بالنسبة للكائن الحي. في الحالة القصوى، يمكننا أن نقول أنه لا توجد حتى علاقة هنا، ولكن هناك كائن واحد كامل وواحد - كائن حي في البيئة؛ وهذا يعني في جوهره أن البيئة تدخل في بنية الكائن الحي نفسه.
لم يتم استخدام هذا المخطط حقًا لشرح شخص ما، لأنه من وجهة نظر منهجية
نهاية الصفحة 106
أعلى الصفحة 107

نهاية الصفحة 107
أعلى الصفحة 108
معقدة للغاية ولم يتم تطويرها بشكل كافٍ بعد؛ أدى هذا التعقيد المنهجي إلى تعليق استخدام هذا المخطط في علم الأحياء، حيث يجب أن يكون بلا شك أحد المخططات الرئيسية.
(3). تصرفات الفاعل فيما يتعلق بالأشياء المحيطة به. هنا، في جوهرها، لا توجد علاقة بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكن هناك كائن واحد معقد - الفاعل؛ الكائنات، إذا تم تحديدها، يتم تضمينها في مخططات وهياكل الإجراءات نفسها، وتتحول إلى لتكون عناصر هذه الهياكل. بشكل منفصل، نادرًا ما يتم استخدام هذه الدائرة، ولكن غالبًا ما يتم استخدامها مع دوائر أخرى كمكون لها. من هذا المخطط غالبًا ما ينتقل المرء إلى أوصاف تحويلات الكائنات التي يتم إجراؤها من خلال الإجراءات، أو إلى أوصاف العمليات مع الكائنات، والعكس صحيح، من أوصاف تحويلات الكائنات والعمليات إلى أوصاف تصرفات الموضوع.
(4). علاقة الشراكة الحرة بين شخص وآخر. هذا هو شكل مختلف من التفاعل بين الموضوع والأشياء في تلك الحالات التي تكون فيها الكائنات أيضًا موضوعات للفعل. يتم تقديم كل واحد منهم لأول مرة بشكل مستقل عن الآخرين ويتميز ببعض الخصائص المنسوبة أو الوظيفية، بغض النظر عن نظام العلاقات الذي سيتم وضعه فيه بعد ذلك والذي سيتم أخذه في الاعتبار.
يستخدم مفهوم "الإنسان" هذا على نطاق واسع الآن في النظرية الاجتماعية للجماعات والجماعات.
(5)، مشاركة "الشخص" باعتباره "عضوًا" في أداء النظام الذي هو عنصر فيه. سيكون الكائن الوحيد هنا هو بنية النظام الذي يتضمن العنصر الذي نفكر فيه؛ ويتم تقديم العنصر نفسه بطريقة ثانوية على أساس علاقته بالكل وبعناصر النظام الأخرى؛ يتم تحديد هذه العلاقات من خلال المعارضة الوظيفية للهيكل الذي تم تقديمه بالفعل للكل. إن عنصر النظام، بحكم تعريفه، لا يمكن أن يوجد بشكل منفصل عن النظام، وبنفس الطريقة، لا يمكن وصفه دون الرجوع إليه.
يتطلب كل من هذه المخططات لنشرها جهازًا منهجيًا خاصًا للتحليل الهيكلي للنظام. والفرق بينهما يمتد حرفيا
نهاية الصفحة 108
أعلى الصفحة 109
مهم في كل شيء - في مبادئ تحليل ومعالجة البيانات التجريبية، من أجل بناء "كيانات" مختلفة تحول هذه المخططات إلى كائنات مثالية، في مخططات ربط ودمج الخصائص المتعلقة بطبقات مختلفة من وصف الكائن، إلخ.
مكان خاص بين جميع المشاكل المنهجية التي تنشأ هنا تحتلها مشاكل تحديد حدود موضوع الدراسة والموضوع المثالي المتضمن فيه. تحتوي على جانبين: 1) تحديد الحدود الهيكلية لكائن ما على المخطط الممثل بيانيًا نفسه و2) تحديد مجموعة الخصائص التي تحول هذا المخطط إلى شكل من أشكال التعبير عن كائن مثالي وتشكل حقيقة الدراسة والقوانين التي نبحث عنها. ليس من الصعب ملاحظة أنه اعتمادًا على كيفية حل هذه المشكلات، سنحدد ونعرّف "الإنسان" بطرق مختلفة تمامًا.
لذا، على سبيل المثال، إذا اخترنا النموذج الأول، الذي يعتبر فيه الشخص موضوعًا يتفاعل مع الأشياء من حوله، فعندئذ، سواء أردنا ذلك بوعي أم لا، سيتعين علينا أن نحصر الشخص في ما يصوره. الدائرة المظللة في مخطط التفاعل المقابل، وهذا يعني - فقط من خلال الخصائص الداخلية لهذا العنصر. إن علاقة التفاعل والتغيير التي ينتجها الموضوع في الأشياء ستُعتبر حتماً مجرد مظاهر خارجية للشخص، عشوائية إلى حد كبير، اعتمادًا على الموقف، وعلى أي حال، ليست مكوناته المكونة. إن فكرة الخصائص التي يتميز بها الشخص وترتيب تحليلها ستكون مختلفة تماما إذا اخترنا النموذج الخامس. هنا، ستكون العملية الرئيسية والمبدئية هي عمل النظام، الذي يكون أحد عناصره شخصًا، وستكون الخصائص الوظيفية الخارجية لهذا العنصر - سلوكه أو نشاطه الضروري - حاسمة، وستكون الخصائص الداخلية، الوظيفية والمادية، حاسمة. ، سيتم استخلاصها من الخارجية.
فإذا اخترنا نموذجا للعلاقة بين الكائن الحي وبيئته، فإن تفسير "الإنسان" وطبيعة خصائصه المحددة وترتيب تحليلها سيختلف عن كلا الخيارين اللذين سبق أن أشرنا إليهما. إن تحديد علاقة الكائن الحي ببيئته يعني التوصيف
نهاية الصفحة 109
أعلى الصفحة 110
لقد قدمنا هذه الاعتبارات السريعة فقط من أجل توضيح وجعل الفرضية القائلة بأن كل نموذج من النماذج المذكورة أعلاه، من ناحية، تفترض جهازًا منهجيًا خاصًا بها في التحليل، والذي لا يزال بحاجة إلى تطوير، ومن ناحية أخرى تحدد اليد تمثيلًا مثاليًا خاصًا تمامًا لـ "الشخص". كل نموذج له أسسه التجريبية والنظرية الخاصة به، كل منها يجسد بعض جوانب الوجود الإنساني الحقيقي. إن التركيز على كل هذه المخططات، وليس على أي منها، له ما يبرره ليس فقط في "مبدأ التسامح" فيما يتعلق بالنماذج المختلفة والمخططات الوجودية، ولكن أيضًا في حقيقة أن الشخص الحقيقي لديه الكثير من العلاقات المختلفة. لبيئته وللإنسانية بشكل عام.
هذا الاستنتاج لا يلغي الحاجة إلى تكوين كل هذه الآراء والنماذج. لكن صنع نموذج نظري الآن، كما قلنا سابقاً، يكاد يكون مستحيلاً. لذلك، ومن أجل تجنب الانتقائية، لم يتبق لدينا سوى طريقة واحدة: تطوير مخططات، في إطار المنهجية، تحدد التسلسل الطبيعي والضروري لاستخدام هذه النماذج عند حل المشكلة.
نهاية الصفحة 110
أعلى الصفحة 111
مختلف المشاكل العملية والهندسية، على وجه الخصوص - مشاكل التصميم التربوي.
عند بناء هذه المخططات، يجب علينا الالتزام بثلاث بيانات مباشرة وأساس مخفي واحد: أولا، مع المبادئ المنهجية والمنطقية العامة لتحليل الكائنات الهرمية النظامية، وثانيا، مع صورة رؤية الكائن، التي تم تعيينها من خلال العمل العملي أو الهندسي الذي اخترناه، ثالثًا، مع العلاقات بين محتويات الموضوع للنماذج التي نوحدها، وأخيرًا، رابعًا، الأساس المخفي - مع القدرة على تفسير المخطط المنهجي لكامل مساحة الكائن بشكل هادف التي نقوم بإنشائها عند الانتقال من نموذج إلى آخر (المخطط 23).

الأسباب المذكورة كافية لتحديد تسلسل صارم تمامًا للنظر في الجوانب والجوانب المختلفة للكائن.
وهكذا، في المنهجية العامة للبحث البنيوي للنظام، هناك مبدأ مفاده أنه عند وصف العمليات الوظيفية للكائنات الممثلة عضويًا أو آليًا، يجب أن يبدأ التحليل بوصف بنية النظام الذي يشمل الكائن المحدد، من شبكة اتصالاتها إلى وصف وظائف كل عنصر على حدة (أحدها أو حسب ظروف المشكلة يكون الكائن الذي ندرسه عدة)، ومن ثم
نهاية الصفحة 111
أعلى الصفحة 112
حدد بالفعل البنية "الداخلية" (الوظيفية أو المورفولوجية) للعناصر بحيث تكون كذلك. تتوافق مع وظائفهم واتصالاتهم "الخارجية" (انظر الشكل 21؛ تم وصف المبادئ المنهجية العاملة في هذا المجال بمزيد من التفصيل وبشكل أكثر دقة في.
لو كان هناك تمثيل بنيوي واحد فقط لـ "الإنسان"، لتصرفنا وفق المبدأ المذكور، "تراكب" المخطط البنيوي القائم على المادة التجريبية المتراكمة من مختلف العلوم، وبهذه الطريقة نربطها في إطار واحد. مخطط.
لكن العلوم الموجودة، التي تصف "الإنسان" بطريقة أو بأخرى، بنيت، كما قلنا من قبل، على أساس تمثيلات نظامية مختلفة للموضوع (شكل 22)، وجميع هذه التمثيلات عادلة ومشروعة في العالم. بمعنى أنهم يلتقطون بعض "جوانب" الكائن بشكل صحيح. ولذلك، فإن المبدأ المذكور أعلاه وحده لا يكفي لبناء مخطط منهجي يمكن أن يوحد المادة التجريبية لجميع العلوم المعنية. واستكمالا لذلك، يجب علينا إجراء مقارنة خاصة لجميع هذه التمثيلات النظامية، مع مراعاة محتوى موضوعها. في هذه الحالة (إذا كانت موجودة بالفعل) أو تم تطويرها أثناء المقارنة نفسها، من ناحية، تمثيلات موضوعية معممة خاصة، ومن ناحية أخرى، المبادئ المنهجية والمنطقية التي تميز العلاقات المحتملة بين النماذج الهيكلية من هذا النوع.
في هذه الحالة، عليك أن تفعل كلا الأمرين. كمفاهيم أولية للموضوع المعمم، نستخدم المخططات والصور الوجودية لنظرية النشاط (انظر الجزء الثاني من المقالة، بالإضافة إلى أجزاء من المفاهيم الاجتماعية التي تم تطويرها على أساسها. لكن من الواضح أنها ليست كافية لتكوين أساس جيد حل المهمة وبالتالي يتعين علينا في نفس الوقت تقديم العديد من الافتراضات "العملية" والمحلية البحتة فيما يتعلق بالتبعيات الموضوعية والمنطقية بين المخططات المقارنة.
وبدون عرض الخطوات المحددة لمثل هذه المقارنة الآن - وهذا سيتطلب مساحة كبيرة - سنعرض نتائجها كما تظهر
نهاية الصفحة 112
أعلى الصفحة 113
بعد التحليل الأول والخشن للغاية. ستكون هذه قائمة بالأنظمة الرئيسية التي تشكل كائنات مختلفة للدراسة وترتبط ببعضها البعض، أولاً، من خلال العلاقة "المجردة - الملموسة" (انظر)، ثانياً، من خلال علاقة "الأجزاء الكاملة"، ثالثاً، من خلال علاقة "نموذج التكوين" - الإسقاط" و"الإسقاط - الإسقاط" (انظر الجزء الرابع)؛ سيتم تحديد تنظيم الأنظمة ضمن مخطط واحد من خلال هيكل ترقيمها والمؤشرات الإضافية على اعتماد نشر بعض الأنظمة على توفر ونشر أنظمة أخرى 1 .
(1) نظام يصف الأنماط والأنماط الأساسية لإعادة الإنتاج الاجتماعي.
(1.1) نظام يصف الكل الاجتماعي بأنه نشاط "جماهيري" يتضمن عناصر مختلفة بما في ذلك الأفراد (اعتمادًا على (1)).
(2.1) أداء النشاط "الجماهيري".
(2.2) تطوير الأنشطة "الجماهيرية".
(3) نظام يصف الكل الاجتماعي بأنه تفاعل بين العديد من الأفراد (لا يمكن إقامة علاقة مع (1).
(4) الأنظمة التي تصف وحدات النشاط الفردية وتنسيقها وتبعيتها في مختلف مجالات النشاط "الجماهيري" (اعتمادًا على (2)، (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (و ).
(5) الأنظمة التي تصف الأشكال المختلفة للثقافة وتطبيع النشاط وتنظيمه الاجتماعي (اعتمادًا على (1)، (2)، (4)، (5)، (7)، (8)، (9)، (10) )).
(6.1) الوصف البنيوي السيميائي.
(6.2). الوصف الظاهري.
(7) الأنظمة التي تصف أشكالًا مختلفة من "سلوك" الأفراد (تعتمد على (3)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)؛ يتم تحديدها ضمنيًا بواسطة (4)، (5)، (6).
(8) الأنظمة التي تصف ارتباط الأفراد في مجموعات وجماعات وما إلى ذلك (يعتمد على (7)، (9)، (10)، (11)، (12)؛ يتم تحديدها ضمنيًا بواسطة (4)، (5) )، (6).
1 ومن المثير للاهتمام أن تحديد المنطق العام للجمع بين مبادئ التصميم المحددة عند إنشاء أنظمة معقدة من مختلف الأنواع أصبح الآن مشكلة شائعة في جميع العلوم الحديثة تقريبًا، ولا توجد نتائج مشجعة بما فيه الكفاية في حلها.
نهاية الصفحة 113
أعلى الصفحة 114
(9) أنظمة تصف تنظيم الأفراد في البلدان والطبقات وما إلى ذلك. (يعتمد على (4)، (5)، (6)، (8)، (10)، (11)).
(1ج) الأنظمة التي تصف "شخصية" الشخص وأنواع "الشخصية" المختلفة (تعتمد على (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (ط)، (12) .
(11) الأنظمة التي تصف بنية “الوعي” ومكوناته الرئيسية، وكذلك أنواع “الوعي” المختلفة (اعتماداً على (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، ( 9)، (10)).
12. الأنظمة التي تصف النفس البشرية (تعتمد على (4)، (6)، (7)، (10)، (11)) 1.
لا تتوافق موضوعات الدراسة الموضحة في هذه القائمة مع النماذج المجردة المعروضة في الرسم البياني 22، ولا مع موضوعات العلوم الموجودة حاليًا. هذا تصميم تقريبي للأنظمة النظرية الأساسية التي يمكن بناؤها إذا أردنا الحصول على وصف منهجي كامل إلى حد ما لـ "الإنسان".
بمجرد تقديم هذه المجموعة من موضوعات الدراسة (أو غيرها، ولكنها مماثلة في الوظيفة)، يمكننا النظر في وتقييم المخططات الوجودية ومعرفة جميع العلوم الموجودة بالفعل فيما يتعلق بها.
لذلك، على سبيل المثال، بالنظر إلى علم الاجتماع في هذا الصدد، يمكننا أن نجد أنه منذ لحظة بدايته كان يركز على تحليل وتصوير العلاقات وأشكال سلوك الناس داخل النظم الاجتماعية والمجموعات المكونة لها، لكنه في الواقع هو كان قادرًا على تمييز ووصف المنظمات الاجتماعية والأعراف الثقافية التي تحدد سلوك الناس والتغيرات في كليهما على مدار التاريخ ووصفها بطريقة ما.
ولم يكن من الممكن إلا في الآونة الأخيرة تحديد مجموعات صغيرة وبنية الشخصية كمواضيع خاصة للدراسة وبالتالي البدء
1 جميع التبعيات المشار إليها في هذه القائمة ذات طبيعة "موضوعية"، أي أنها تبعيات تفكير تتجلى في تطور موضوعات الدراسة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسيرها بشكل موضوعي على أنها روابط ذات تحديد طبيعي أو اجتماعي.
ومن المهم أيضًا ألا يتوافق الترتيب الذي يتم به إدراج العناصر مع تسلسل نشرها: لا تعتمد كافة العناصر على العناصر التي تسبقها في القائمة فحسب، بل تعتمد أيضًا على العناصر التي تليها. وفي هذه الحالة، بطبيعة الحال، فإن التبعيات لها طبيعة مختلفة، ولكن هذا لم يكن مهما بالنسبة لنا في هذا الاعتبار.
نهاية الصفحة 114
أعلى الصفحة 115
البحث في مجال ما يسمى بعلم النفس الاجتماعي،
وبالنظر إلى المنطق بهذه الطريقة، يمكننا أن نجد أنه انطلق في أصوله من مخطط النشاط البشري مع الأشياء المحيطة به، ولكنه توقف، في الواقع، عند وصف تحولات العلامات التي تنتج في عملية النشاط العقلي، وعلى الرغم من أن وفي المستقبل، كانت تطرح باستمرار مسألة العمليات والأفعال البشرية التي تتم من خلالها هذه التحولات، ولكنها كانت مهتمة حقًا فقط بالقواعد التي تطبع هذه التحولات ولم تذهب أبعد من ذلك أبدًا.
الأخلاق، على عكس المنطق، انطلقت من مخطط الشراكة الحرة للشخص مع الآخرين، لكنها ظلت، في جوهرها، في نفس طبقة المظاهر "الخارجية" مثل المنطق، على الرغم من أنها لم تعد تمثلها كعمليات أو أفعال، بل كعلاقات. مع أشخاص آخرين، ودائمًا ما يحدد ويوصف فقط ما الذي يعمل على تطبيع هذه العلاقات وسلوك الأشخاص عند إقامتها.
علم النفس، على عكس المنطق والأخلاق، انطلق منذ البداية من فكرة الفرد المنعزل وسلوكه؛ يرتبط بالتحليل الظاهري لمحتويات الوعي، ومع ذلك، كعلم، تم تشكيله على أسئلة الطبقة التالية: ما هي العوامل "الداخلية" - "القوى"، "القدرات"، "العلاقات"، وما إلى ذلك التي تحدد و شرط نصوص سلوك وأنشطة الأشخاص الذين نلاحظهم. فقط في بداية قرننا، تم طرح مسألة وصف "سلوك" الأفراد (السلوكية وعلم التفاعل) لأول مرة، ومنذ العشرينات - حول وصف تصرفات وأنشطة الفرد (السوفيتي والفرنسي). علم النفس). كان هذا بمثابة بداية تطوير عدد من العناصر الجديدة من قائمتنا.
لقد قمنا بتسمية بعض العلوم الموجودة فقط ووصفناها بشكل تقريبي للغاية. ولكن سيكون من الممكن أخذ أي واحد آخر، ومن خلال تطوير إجراءات الارتباط المناسبة، وإذا لزم الأمر، ثم إعادة ترتيب القائمة المقصودة، وإقامة مراسلات بينها وبين جميع العلوم التي تتعلق بطريقة أو بأخرى بـ "الإنسان". نتيجة لذلك، سيكون لدينا نظام غني إلى حد ما يجمع بين كل المعرفة الموجودة حول الكائن الذي اخترناه.
نهاية الصفحة 115
أعلى الصفحة 116
بعد بناء مثل هذا النظام، حتى في الشكل الأكثر تخطيطًا وغير التفصيلي، من الضروري اتخاذ الخطوة التالية والنظر فيها من وجهة نظر مهام التصميم التربوي. في الوقت نفسه، سيتعين علينا "قطع" في هذا النظام هذا التسلسل من المعرفة، سواء الحالية والمطورة حديثا، والتي يمكن أن توفر الأساس العلمي للتصميم التربوي للشخص.
ليست هناك حاجة لإثبات أن تنفيذ برنامج البحث المذكور هو أمر معقد للغاية، ويتضمن الكثير من الأبحاث المنهجية والنظرية الخاصة. إلى أن يتم تنفيذها وعدم إنشاء موضوعات الدراسة الموضحة أعلاه، لم يتبق لدينا سوى شيء واحد - وهو استخدام المعرفة العلمية الموجودة بالفعل حول "الإنسان" عند حل المشكلات التربوية نفسها، وفي حالة عدم وجودها، استخدم المعرفة العلمية الموجودة بالفعل حول "الإنسان" أساليب العلوم الموجودة للحصول على معرفة جديدة، وفي سياق هذا العمل (التربوي في مهامه ومعناه) لانتقاد المفاهيم العلمية الموجودة وصياغة المهام لتحسينها وإعادة هيكلتها.
علاوة على ذلك، إذا أخذنا في الاعتبار مهمة إنشاء نظام جديد للموضوعات وانطلقنا من خطتها المحددة بالفعل، فإن هذه الدراسات، في جوهرها، ستمنحنا تجسيدًا تجريبيًا ملموسًا للعمل على إعادة هيكلة نظام العلوم حول " رجل" الذي تحتاجه التربية.
من وجهة النظر هذه، دعونا نفكر في الأفكار الهيكلية حول "الإنسان" و"الإنسان"، التي تقدمها حاليًا العلوم الرئيسية في هذا المجال - علم الاجتماع والمنطق وعلم النفس، وتقييم قدراتها في تبرير التصميم التربوي. وفي الوقت نفسه، لن نسعى جاهدين للحصول على وصف كامل ومنهجي - فمثل هذا التحليل سيذهب إلى ما هو أبعد من نطاق هذا العمل - ولكننا سنقدم كل شيء من حيث الرسوم التوضيحية المنهجية الممكنة لشرح النقطة الرئيسية حول توحيد المعرفة وأساليب من العلوم المختلفة في منظومة الهندسة التربوية والبحث التربوي.
| " |
المحاضرة 2.
الإنسان كموضوع للأنثروبولوجيا التربوية.
موضوع الأنثروبولوجيا التربوية هو العلاقات الإنسانية والإنسانية، والموضوع هو الطفل. من أجل فهم هذا الكائن واختراق هذا الموضوع، من الضروري أولا أن نفهم ما هو الشخص، ما هي طبيعته. هذا هو السبب في أن "الإنسان" يعتبر أحد المفاهيم الرئيسية في الأنثروبولوجيا التربوية. ومن المهم بالنسبة لها أن تكون لديها الصورة الأكثر اكتمالاً عن الشخص، فهذا سيعطي فكرة كافية عن الطفل والتربية التي تتوافق مع طبيعته.
لقد كان الإنسان موضوع دراسة العديد من العلوم لعدة قرون. المعلومات المتراكمة عنه خلال هذا الوقت هائلة. لكن هذا لا يقلل فقط من عدد الأسئلة المتعلقة بالتبصر في جوهر الطبيعة البشرية، بل يضاعف هذه الأسئلة أيضًا. ولا يؤدي إلى مفهوم واحد للإنسان يرضي الجميع. وكما كان من قبل، فإن العلوم المختلفة، بما في ذلك تلك التي ظهرت للتو، تجد في الإنسان "مجال نشاطها"، وجانبها، وتكتشف فيه شيئًا لم يكن معروفًا حتى الآن، وتحدد بطريقتها الخاصة ماهية الشخص.
الإنسان متنوع للغاية و"متعدد الأصوات" لدرجة أن العلوم المختلفة تكتشف فيه خصائص بشرية معاكسة مباشرة وتركز عليها. لذا، إذا كان بالنسبة للاقتصاد مخلوقًا يفكر بعقلانية، فهو بالنسبة لعلم النفس غير عقلاني إلى حد كبير. يعتبره التاريخ "المؤلف"، وموضوع بعض الأحداث التاريخية، والتربية - كموضوع للرعاية والمساعدة والدعم. إنه مثير للاهتمام في علم الاجتماع باعتباره كائنًا ذو سلوك ثابت، وفي علم الوراثة باعتباره كائنًا مبرمجًا. بالنسبة لعلم التحكم الآلي، فهو روبوت عالمي، وبالنسبة للكيمياء فهو عبارة عن مجموعة من المركبات الكيميائية المحددة.
إن الخيارات المتاحة لدراسة البشر لا حصر لها وتتضاعف طوال الوقت. ولكن في الوقت نفسه، أصبح اليوم أكثر وضوحًا: الإنسان كائن معقد للغاية، لا ينضب، وغامض من نواحٍ عديدة؛ إن فهمها الكامل (المهمة التي طُرِحَت في فجر الأنثروبولوجيا) مستحيل من حيث المبدأ.
وقد تم تقديم عدد من التفسيرات لذلك. على سبيل المثال: دراسة الإنسان يقوم بها الإنسان نفسه، ولهذا السبب وحده لا يمكن أن تكون كاملة ولا موضوعية. يعتمد تفسير آخر على حقيقة أن المفهوم الجماعي للشخص لا يمكن تشكيله، كما لو كان من القطع، من مواد المراقبة ودراسات الأشخاص المحددين. حتى لو كان هناك الكثير منهم. ويقولون أيضًا أن ذلك الجزء من حياة الشخص الذي يمكن دراسته لا يستنفد الشخص بأكمله. "لا يمكن اختزال الإنسان في الوجود التجريبي لذات تجريبية. يكون الإنسان دائمًا أعظم من نفسه، لأنه جزء من شيء أكبر، وكل أوسع، وعالم متعالٍ» (جي بي شيدروفيتسكي). ويشيرون أيضًا إلى أن المعلومات الواردة عن شخص ما في قرون مختلفة لا يمكن دمجها في وحدة واحدة، لأن الإنسانية مختلفة عصور مختلفة، تمامًا كما يختلف كل شخص إلى حد كبير في فترات مختلفةالحياة الخاصة.
ومع ذلك، فإن صورة الشخص وعمق وحجم الأفكار عنه تتحسن من قرن إلى قرن.
دعونا نحاول رسم هذا المخطط التفصيلي العرض الحديثعن الشخص الذي يتطور عند تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من مختلف العلوم. في الوقت نفسه، سيتم استخدام مصطلح "الرجل" من قبلنا كمصطلح جماعي، أي لا يدل على بعض الأشخاص الفرديين المحددين، ولكن ممثل معمم للإنسان العاقل.
مثل كل الكائنات الحية، يكون الشخص نشطا، أي أنه قادر على التفكير بشكل انتقائي، وإدراك، والرد على أي تهيج وتأثير، ولديه، على حد تعبير F. Engels، "قوة رد الفعل المستقلة".
وهو من البلاستيك، أي أنه يتمتع بقدرات تكيفية عالية مع الظروف المعيشية المتغيرة مع الحفاظ على خصائص الأنواع.
إنه مخلوق ديناميكي ومتطور: تحدث تغييرات معينة في الأعضاء والأنظمة والدماغ البشري على مدار القرون، وفي مجرى حياة كل شخص. علاوة على ذلك، كما يعتقد العلم الحديثإن عملية تطور الإنسان العاقل لم تكتمل، وإمكانيات الإنسان للتغيير لم تستنفد.
مثل كل الكائنات الحية، ينتمي الإنسان عضويا إلى طبيعة الأرض والكون، حيث يتبادل المواد والطاقات باستمرار. ومن الواضح أن الإنسان جزء لا يتجزأ من المحيط الحيوي، من نباتات وحيوانات الأرض، ويكشف في نفسه عن علامات الحياة الحيوانية والنباتية. على سبيل المثال، تشير أحدث اكتشافات علم الحفريات والبيولوجيا الجزيئية إلى أن الرموز الوراثية للإنسان والقردة تختلف بنسبة 1-2% فقط (في حين تبلغ الاختلافات التشريحية حوالي 70%). إن قرب الإنسان من عالم الحيوان واضح بشكل خاص. ولهذا السبب غالبًا ما يعرّف الناس أنفسهم بحيوانات معينة في الأساطير والحكايات الخيالية. ولهذا السبب يعتبر الفلاسفة الإنسان أحيانًا حيوانًا: شاعريًا (أرسطو)، ضاحكًا (رابليه)، تراجيديًا (شوبنهاور)، صانعًا للأدوات، مخادعًا...
ومع ذلك، فإن الإنسان ليس مجرد حيوان أعلى، وليس مجرد تاج تطور طبيعة الأرض. هو، وفقا لتعريف الفيلسوف الروسي I. A. Ilyin، "كل الطبيعة". "إنه ينظم ويركز ويركز كل ما هو موجود في السدم البعيدة وفي أقرب الكائنات الحية الدقيقة، ويحتضن كل ذلك بروحه في المعرفة والإدراك".
يتم تأكيد الانتماء العضوي للإنسان إلى الكون من خلال بيانات من علوم تبدو بعيدة مثل كيمياء فحم الكوك، والفيزياء الفلكية، وما إلى ذلك. وفي هذا الصدد، نتذكر بيان N. A. Berdyaev: "الإنسان يفهم الكون، لأنهما لهما نفس الطبيعة".
الإنسان هو "عامل التكوين الجيولوجي الرئيسي للمحيط الحيوي" (وفقًا لـ V. I. Vernadsky). إنه ليس مجرد جزء من أجزاء الكون، أو أحد العناصر العادية في عالم النبات والحيوان. إنه العنصر الأكثر أهمية في هذا العالم. مع ظهورها، تغيرت طبيعة الأرض في نواح كثيرة، واليوم يحدد الإنسان حالة الكون. وفي الوقت نفسه، يكون الإنسان دائمًا مخلوقًا يعتمد إلى حد كبير على الظواهر والظروف الكونية والطبيعية. يفهم الإنسان الحديث: الطبيعة التي شوهتها تهدد وجود البشرية، وتدمرها، وفهم الطبيعة، وإنشاء توازن ديناميكي معها، وتسهيل وتجميل حياة البشرية، يجعل الإنسان كائنًا أكثر اكتمالًا وإنتاجية.
الاجتماعية والعقلانية للإنسان
الإنسان ليس مجرد كائن كوني وطبيعي. إنه كائن اجتماعي وتاريخي. ومن أهم خصائصها الاجتماعية. دعونا نفكر في هذا البيان.
تمامًا كما هو الحال بالنسبة للكون وطبيعة الأرض، ينتمي الإنسان إلى المجتمع، إلى المجتمع البشري. إن ظهور الإنسان العاقل، كما يدعي العلم الحديث، يرجع إلى تحول قطيع من أشباه البشر، حيث حكمت القوانين البيولوجية، إلى مجتمع بشري، حيث كانت القوانين الأخلاقية سارية المفعول. تطورت الخصائص المحددة للإنسان كنوع تحت تأثير أسلوب الحياة الاجتماعي. كانت أهم شروط الحفاظ على كل من نوع الإنسان العاقل والفرد وتنميتهما هي مراعاة المحظورات الأخلاقية والالتزام بالتجربة الاجتماعية والثقافية للأجيال السابقة.
إن أهمية المجتمع لكل فرد هائلة أيضا، لأنه ليس إضافة ميكانيكية للأفراد الأفراد، ولكن دمج الناس في كائن اجتماعي واحد. "إن أول الشروط الأولى لحياة الإنسان هو وجود شخص آخر. الأشخاص الآخرون هم المراكز التي يتم تنظيم العالم البشري حولها. إن الموقف تجاه شخص آخر، تجاه الناس، يشكل النسيج الأساسي للحياة البشرية، وجوهرها. لا يمكن الكشف عن يانا إلا من خلال الموقف تجاه الذات (ليس من قبيل الصدفة أن يكون النرجس في أسطورة قديمة- مخلوق غير سعيد). يتطور الشخص فقط من خلال "النظر" (ك. ماركس) إلى شخص آخر.
أي شخص مستحيل بدون مجتمع، دون أنشطة مشتركة والتواصل مع الآخرين. يتم تمثيل كل شخص (وأجيال عديدة من الناس) بشكل مثالي في الآخرين ويأخذ دورًا مثاليًا فيهم (V. A. Petrovsky). حتى من دون فرصة حقيقية للعيش بين الناس، يظهر الشخص نفسه كعضو في مجتمعه، مجتمعه المرجعي. إنه يسترشد (ليس دائمًا بوعي) بقيمه ومعتقداته وأعرافه وقواعده. يستخدم الكلام والمعرفة والمهارات وأشكال السلوك المعتادة التي نشأت في المجتمع قبل وقت طويل من ظهوره فيه وانتقلت إليه. كما تمتلئ ذكرياته وأحلامه بالصور التي لها معنى اجتماعي.
في المجتمع تمكن الإنسان من إدراك الفرص المحتملة التي منحها له الكون والطبيعة الأرضية. وهكذا، تحول النشاط البشري ككائن حي إلى قدرة ذات أهمية اجتماعية على النشاط الإنتاجي، للحفاظ على الثقافة وخلقها. الديناميكية والمرونة - القدرة على التركيز على الآخر، والتغيير في حضوره، وتجربة التعاطف. الاستعداد لإدراك الكلام البشري - في التواصل الاجتماعي، في القدرة على الحوار البناء، وتبادل الأفكار والقيم والخبرة والمعرفة، وما إلى ذلك.
لقد كانت الطريقة الاجتماعية التاريخية للوجود هي التي جعلت من الإنسان البدائي كائنًا عقلانيًا.
من خلال العقلانية، تفهم الأنثروبولوجيا التربوية، بعد K. D. Ushinsky، ما هو مميز للإنسان فقط - القدرة على فهم ليس فقط العالم، ولكن أيضًا فهم الذات فيه:
وجودك في الزمان والمكان؛
القدرة على تسجيل وعيك بالعالم وبنفسك؛
الرغبة في الاستبطان والنقد الذاتي واحترام الذات وتحديد الأهداف والتخطيط لأنشطة الحياة، أي الوعي الذاتي والتفكير.
العقلانية فطرية في الإنسان. بفضلها يستطيع تحديد الأهداف والفلسفة والبحث عن معنى الحياة والسعي لتحقيق السعادة. بفضله، فهو قادر على تحسين نفسه وتثقيف نفسه وتغيير العالم من حوله وفقًا لأفكاره الخاصة حول ما هو ذو قيمة ومثالية (الوجود، الإنسان، إلخ). إنه يحدد إلى حد كبير تطور التعسف في العمليات العقلية وتحسين الإرادة البشرية.
يساعد العقل الشخص على التصرف بشكل يتعارض مع احتياجاته العضوية والإيقاعات البيولوجية (قمع الجوع، والعمل بنشاط في الليل، والعيش في انعدام الوزن، وما إلى ذلك). في بعض الأحيان يجبر الشخص على إخفاء خصائصه الفردية (مظاهر المزاج، والجنس، وما إلى ذلك). إنه يعطي القوة للتغلب على الخوف من الموت (تذكر، على سبيل المثال، أطباء الأمراض المعدية الذين أجروا تجارب على أنفسهم). هذه القدرة على التعامل مع الغريزة، والذهاب بوعي ضد المبدأ الطبيعي في حد ذاته، ضد جسده، هي سمة محددة للشخص.
الروحانية والإبداع الإنساني
السمة المحددة للإنسان هي روحانيته. تعتبر الروحانية سمة مميزة لجميع الناس باعتبارها حاجة إنسانية عالمية أساسية للتوجه نحو القيم العليا. وسواء كانت روحانية الإنسان نتيجة لوجوده الاجتماعي والتاريخي أم أنها دليل على أصله الإلهي، فإن هذا السؤال يظل محل جدل. ومع ذلك، فإن وجود هذه الميزة كظاهرة إنسانية بحتة لا يمكن إنكاره.
في الواقع، البشر وحدهم هم الذين يتميزون باحتياجات لا تشبع للمعرفة الجديدة، وللبحث عن الحقيقة، وللقيام بأنشطة خاصة لخلق قيم غير ملموسة، وللعيش وفقًا للضمير والعدالة. فقط الشخص قادر على العيش في عالم غير ملموس وغير واقعي: في عالم الفن، في الماضي أو المستقبل الخيالي. وحده الإنسان قادر على العمل من أجل المتعة والاستمتاع بالعمل الجاد إذا كان مجانيًا وله معنى شخصي أو اجتماعي مهم. فقط الشخص يمكنه تجربة حالات يصعب تحديدها على المستوى العقلاني، مثل الخجل، والمسؤولية، واحترام الذات، والتوبة، وما إلى ذلك. الشخص وحده هو القادر على الإيمان بالمثل العليا، في نفسه، في مستقبل أفضل، في الخير. ، في الله. الإنسان وحده هو القادر على الحب، ولا يقتصر على الجنس فقط. الإنسان وحده هو القادر على التضحية بالنفس وضبط النفس.
كونه عقلانيًا وروحيًا، يعيش في المجتمع، لا يمكن للإنسان إلا أن يصبح كائنًا مبدعًا. ويتجلى إبداع الإنسان أيضًا في قدرته على خلق شيء جديد في جميع مجالات حياته، بما في ذلك السعي وراء الفن والحساسية تجاهه. إنه يتجلى بشكل يومي في ما يسميه V. A. Petrovsky "القدرة على تجاوز الحدود المحددة مسبقًا بحرية ومسؤولية" (من الفضول إلى الابتكارات الاجتماعية). وهو يتجلى في عدم القدرة على التنبؤ بالسلوك ليس فقط للأفراد، ولكن أيضًا للفئات الاجتماعية والأمم بأكملها.
إن الطريقة الاجتماعية التاريخية للوجود والروحانية والإبداع هي التي تجعل الشخص قوة حقيقية، وهو العنصر الأكثر أهمية ليس فقط في المجتمع، ولكن أيضًا في الكون.
النزاهة والتناقض البشري
السمة العالمية الأخرى للإنسان هي نزاهته. وكما أشار ل. فيورباخ، فإن الإنسان "كائن حي يتميز بوحدة الكائن المادي والحسي والروحي والعقلاني الفعال". يؤكد الباحثون المعاصرون على سمة من سمات النزاهة البشرية مثل "الصورة المجسمة": في أي مظهر من مظاهر الشخص، في كل من خصائصه وأعضائه وأنظمته، يتم تمثيل الشخص بأكمله بشكل ثلاثي الأبعاد. على سبيل المثال، في كل مظهر عاطفي للشخص، يتم الكشف عن حالة صحته الجسدية والعقلية، وتطور الإرادة والفكر، والخصائص الجينية والالتزام بقيم ومعاني معينة، وما إلى ذلك.
والأكثر وضوحًا هو السلامة الجسدية لجسم الإنسان (أي خدش يتسبب في تفاعل الجسم بأكمله)، لكنه لا يستنفد سلامة الإنسان - كائن فائق التعقيد. تتجلى سلامة الشخص، على سبيل المثال، في حقيقة أن خصائصه الفسيولوجية والتشريحية والعقلية ليست كافية لبعضها البعض فحسب، بل إنها مترابطة ومحددة بشكل متبادل ومترابطة مع بعضها البعض.
الإنسان كائن، وهو الكائن الوحيد من بين جميع الكائنات الحية الذي يربط عضويًا بشكل لا ينفصم داخل نفسه بين جوهره البيولوجي والاجتماعي وعقلانيته وروحانيته. وبيولوجيا الإنسان واجتماعيته وعقلانيته وروحانيته هي أمور تاريخية: يحددها تاريخ البشرية (وكذلك الفرد). وتاريخ نوع ما (وأي شخص) في حد ذاته هو تاريخ اجتماعي وبيولوجي في نفس الوقت، ولذلك يتجلى البيولوجي في أشكال تعتمد إلى حد كبير على تاريخ الإنسان العالمي، ونوع مجتمع معين، والخصائص الثقافية لمجتمع معين. مجتمع.
باعتباره كائنًا متكاملاً، يكون الشخص دائمًا في نفس الوقت في موضع كل من الموضوع والموضوع (ليس فقط أي موقف في الحياة العامة والشخصية، والتواصل، والنشاط، ولكن أيضًا في الثقافة والمكان والزمان والتعليم).
في الإنسان، العقل والشعور، والعواطف والفكر، والكائن العقلاني وغير العقلاني مترابطة. إنه موجود دائمًا "هنا والآن" و"هناك وبعد ذلك"، ويرتبط حاضره ارتباطًا وثيقًا بالماضي والمستقبل. أفكاره حول المستقبل تحددها انطباعات وتجارب حياته الماضية والحاضرة. والفكرة الخيالية للمستقبل تؤثر على السلوك الحقيقي في الحاضر، وفي بعض الأحيان حتى على إعادة تقييم الماضي. نظرًا لكونه مختلفًا في فترات مختلفة من حياته، فإن الشخص في نفس الوقت هو نفس ممثل الجنس البشري طوال حياته. إن وجوده الواعي واللاواعي والفائق الوعي (الحدس الإبداعي، وفقًا لـ P. Simonov) مترابطة وملائمة لبعضها البعض.
في حياة الإنسان، تكون عمليات التكامل والتمايز في النفس والسلوك والوعي الذاتي مترابطة. على سبيل المثال، من المعروف أن تطوير القدرة على التمييز بين المزيد والمزيد من ظلال اللون (التمايز) يرتبط بزيادة القدرة على إعادة إنشاء صورة كائن كامل من تفاصيل واحدة مرئية (التكامل).
يوجد في كل شخص وحدة عميقة للفرد (المشترك بين الإنسانية كنوع)، والخصائص النموذجية (خاصية مجموعة معينة من الناس) والخصائص الفريدة (المميزة فقط لشخص معين). يتجلى كل شخص دائمًا في نفس الوقت ككائن حي وكشخص وكفرد. في الواقع، فإن المخلوق الذي لديه شخصية، ولكنه خالي تماما من الجسم، ليس فقط شخصا، بل شبح. إن الفكرة المنتشرة جدًا في الوعي التربوي بأن الكائن الحي والشخصية والفردية هي مفاهيم تجسد مستويات مختلفة من التطور البشري غير صحيحة. في الإنسان ككائن متكامل، تكون الأقانيم المذكورة جنبًا إلى جنب، ومترابطة، ومتحكم فيها بشكل متبادل.
كل فرد ككائن حي هو حامل لنمط وراثي معين، وهو الحارس (أو المدمر) لمجموعة الجينات البشرية، وبالتالي فإن صحة الإنسان هي إحدى القيم العالمية.
من وجهة نظر الأنثروبولوجيا التعليمية، من المهم أن نفهم أن جسم الإنسان يختلف اختلافًا جوهريًا عن الكائنات الحية الأخرى. ولا يتعلق الأمر فقط بالسمات التشريحية والفسيولوجية. وليس الأمر أن جسم الإنسان متآزر (غير متوازن): يشمل نشاطه عمليات فوضوية ومنظمة على حد سواء، وكلما كان الكائن الحي أصغر سنا، كلما كان النظام أكثر فوضوية، وأكثر عشوائية. (بالمناسبة، من المهم للمعلم أن يفهم ما يلي: الأداء الفوضوي لجسم الطفل يسمح له بالتكيف بسهولة أكبر مع التغيرات في الظروف المعيشية، والتكيف بشكل بلاستيكي مع السلوك غير المتوقع للبيئة الخارجية، والتصرف بطريقة نطاق أوسع من الحالات.إن انتظام العمليات الفسيولوجية الذي يأتي مع تقدم العمر يعطل تآزر الجسم، وهذا يؤدي إلى الشيخوخة والدمار والمرض.)
هناك شيء آخر أكثر أهمية: يرتبط عمل الجسم البشري ارتباطًا وثيقًا بروحانية الشخص وعقلانيته واجتماعيته. في الحقيقة الحالة الفيزيائيةيعتمد جسم الإنسان على الكلمة الإنسانية، وعلى “قوة الروح”، وفي الوقت نفسه تؤثر الحالة الجسدية للإنسان على حالته النفسية والعاطفية وأداءه في المجتمع.
يحتاج جسم الإنسان منذ ولادته (وربما قبل ذلك بوقت طويل) إلى أسلوب حياة الإنسان، وأشكال الوجود البشري، والتواصل مع الآخرين، وإتقان الكلمة والاستعداد لها.
يعكس المظهر الجسدي للشخص العمليات الاجتماعية والحالة الثقافية وخصائص نظام تعليمي معين.
كل فرد باعتباره عضوا في المجتمع هو شخص، أي:
مشارك في العمل المشترك والمقسم في نفس الوقت وحامل نظام معين من العلاقات؛
الأس وفي نفس الوقت المنفذ للمتطلبات والقيود المقبولة عموما؛
حامل معنى للآخرين ولنفسه الأدوار الاجتماعيةوالحالات؛
مؤيد لأسلوب حياة معين.
أن تكون شخصًا، أي حاملًا للاشتراكية، هي ملكية متكاملة، وهي صفة فطرية طبيعية مميزة للإنسان.
وبنفس الطريقة فإن لدى الإنسان القدرة الفطرية على أن يكون فرداً، أي كائناً لا يشبه الآخرين. ويوجد هذا الاختلاف على المستويين الفسيولوجي والنفسي (الفردية الفردية)، وعلى مستوى السلوك والتفاعل الاجتماعي وتحقيق الذات (الفردية الشخصية والإبداعية). وهكذا، فإن الفردية تدمج خصائص الجسم والشخصية لشخص معين. إذا كان الاختلاف الفردي (لون العين، نوع النشاط العصبي، وما إلى ذلك)، كقاعدة عامة، واضحًا تمامًا ولا يعتمد كثيرًا على الشخص نفسه والحياة من حوله، فإن الاختلاف الشخصي يكون دائمًا نتيجة لجهوده الواعية وتفاعله مع نفسه. البيئة. تعتبر كلا الشخصيتين من المظاهر ذات الأهمية الاجتماعية للشخص.
إن النزاهة العميقة والعضوية الفريدة للإنسان تحدد إلى حد كبير مدى تعقيده الفائق كظاهرة حقيقية وكموضوع للدراسة العلمية، كما نوقش أعلاه. وينعكس ذلك في الأعمال الفنية المخصصة للإنسان وفي النظريات العلمية. وعلى وجه الخصوص، في المفاهيم التي تربط بين "الأنا" و"الهو" ومن الأعلى؟ الأنا و alyperego. المواقف الداخلية "طفل"، "بالغ"، "والد"، إلخ.
التعبير الفريد عن سلامة الشخص هو تناقضه. كتب N. A. Berdyaev أن الشخص يمكن أن يعرف نفسه "من أعلى ومن أسفل"، من البداية الإلهية ومن البداية الشيطانية في نفسه. "ويمكنه أن يفعل ذلك لأنه كائن مزدوج ومتناقض، كائن في أعلى درجةمستقطب وشبيه بالله ووحشي. مرتفع ومنخفض، حر وعبد، قادر على الصعود والهبوط، على الحب الكبير والتضحية والقسوة العظيمة والأنانية التي لا حدود لها" (بيرديايف ن. أ. حول العبودية وحرية الإنسان. تجربة الفلسفة الشخصية. - باريس، 1939. - ج . 19 ).
من الممكن تسجيل سلسلة كاملة من التناقضات الإنسانية البحتة المثيرة للاهتمام والمتأصلة في طبيعته. وبالتالي، كونه كائنا ماديا، لا يستطيع الشخص أن يعيش فقط في العالم المادي. الانتماء إلى الواقع الموضوعي، يستطيع الإنسان في كل لحظة من وجوده الواعي أن يتجاوز كل ما يُعطى له في الواقع، وأن ينأى بنفسه عن وجوده الحقيقي، ويغوص في الواقع الداخلي "الافتراضي" الذي يخصه وحده. . إن عالم الأحلام والتخيلات والذكريات والمشاريع والأساطير والألعاب والمثل والقيم له أهمية كبيرة بالنسبة للإنسان لدرجة أنه مستعد لتقديم أغلى شيء له - حياته وحياة الآخرين. يتم دائمًا دمج تأثير العالم الخارجي عضويًا مع التأثير الكامل لعالمه الداخلي على الشخص، والذي أنشأه الخيال ويُنظر إليه على أنه حقيقة. في بعض الأحيان يكون التفاعل بين المساحات الحقيقية والخيالية للوجود الإنساني متناغمًا ومتوازنًا. في بعض الأحيان ينتصر أحدهما على الآخر، أو ينشأ شعور مأساوي بالاستبعاد المتبادل لهذين الجانبين من حياته. لكن كلا العالمين ضروريان دائما للإنسان، فهو يعيش دائما في كليهما.
من الطبيعة البشرية أن تعيش في وقت واحد وفقًا للقوانين العقلانية وقوانين الضمير والخير والجمال، وهي في كثير من الأحيان لا تتطابق فحسب، بل تتعارض بشكل مباشر مع بعضها البعض. يتم تحديده حسب الظروف والظروف الاجتماعية، ويركز على اتباع الصور النمطية والمواقف الاجتماعية حتى في العزلة الكاملة، وفي نفس الوقت يحافظ دائمًا على استقلاليته. في الواقع، لا يوجد شخص واحد يمتص بالكامل في المجتمع، أو "يذوب" فيه. حتى في أشد الظروف الاجتماعية قسوة، في المجتمعات المغلقة، يحتفظ الشخص على الأقل بالحد الأدنى من استقلال ردود أفعاله وتقييماته وأفعاله، والحد الأدنى من القدرة على التنظيم الذاتي، واستقلالية وجوده، وعالمه الداخلي، الحد الأدنى من الاختلاف عن الآخرين. لا يمكن لأي ظروف أن تحرم الإنسان من الحرية الداخلية التي يكتسبها في الخيال والإبداع والأحلام.
الحرية هي واحدة من أسمى القيم الإنسانية، وترتبط إلى الأبد بالسعادة. ومن أجلها يستطيع الإنسان أن يتنازل حتى عن حقه غير القابل للتصرف في الحياة. لكن تحقيق الاستقلال الكامل عن الآخرين، من المسؤولية تجاههم ومن أجلهم، من المسؤوليات يجعل الشخص وحيدا وغير سعيد.
يدرك الإنسان "عدم أهميته" أمام الكون، والعناصر الطبيعية، والكوارث الاجتماعية، والمصير... وفي الوقت نفسه، لا يوجد أشخاص ليس لديهم شعور باحترام الذات، فإهانة هذا الشعور مؤلمة للغاية لجميع الناس: الأطفال والمسنين، الضعفاء والمرضى، والمعالين اجتماعيا والمضطهدين.
يحتاج الشخص بشكل حيوي إلى التواصل وفي نفس الوقت يسعى إلى العزلة، وهذا أيضًا مهم جدًا لتطوره الكامل.
تخضع التنمية البشرية لقوانين معينة، ولكن أهمية الصدفة لا تقل أهمية، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بنتيجة عملية التنمية بشكل كامل.
الإنسان هو كائن روتيني ومبدع في نفس الوقت: فهو يظهر الإبداع وينجذب نحو الصور النمطية، وتحتل العادات مكانًا كبيرًا في حياته.
بداية النموذج
إنه مخلوق محافظ إلى حد ما، يسعى للحفاظ على العالم التقليدي، وفي الوقت نفسه ثوري، يدمر الأسس، ويعيد صنع العالم ليناسب الأفكار الجديدة، "لنفسه". قادر على التكيف مع ظروف الحياة المتغيرة وفي نفس الوقت يظهر "النشاط غير التكيفي" (V. A. Petrovsky).
من المؤكد أن قائمة التناقضات المتأصلة عضويًا في الإنسانية غير مكتملة. لكنه مع ذلك يظهر أن الإنسان متناقض، وأن تناقضات الإنسان ترجع إلى حد كبير إلى طبيعته المعقدة: وفي نفس الوقت، فهي عقلانية بيولوجيًا وروحيًا، وهي جوهر الإنسان. الإنسان قوي في تناقضاته، رغم أنها تسبب له في بعض الأحيان متاعب كبيرة. يمكن الافتراض أن "التطور المتناغم للإنسان" لن يؤدي أبدًا إلى التجانس الكامل للتناقضات الأساسية، وإلى إضعاف الجوهر الإنساني.
الطفل كشخص
جميع خصائص الأنواع المدرجة متأصلة في البشر منذ الولادة. كل طفل كامل، كل منها مرتبط بالفضاء والطبيعة الأرضية والمجتمع. ولد كائن بيولوجي، فرد، عضو في المجتمع، حامل محتمل للثقافة، خالق العلاقات بين الأشخاص.
لكن الأطفال يعبرون عن طبيعتهم الإنسانية بشكل مختلف إلى حد ما عن البالغين.
الأطفال أكثر حساسية للظواهر الكونية والطبيعية، وإمكانيات تدخلهم في الطبيعة الأرضية والكونية ضئيلة. في الوقت نفسه، ينشط الأطفال إلى أقصى حد في إتقان البيئة وإنشاء العالم الداخلي وأنفسهم. نظرًا لأن جسم الطفل أكثر فوضوية وبلاستيكًا، فقد حدث ذلك اعلى مستوىالقدرة على التغيير، أي أنها الأكثر ديناميكية. إن هيمنة تلك العمليات العقلية في مرحلة الطفولة، والتي لا ترتبط بقشرة المخ، ولكن بهياكل الدماغ الأخرى، تضمن قدرًا أكبر بكثير من قابلية التأثر والعفوية والعاطفية وعدم قدرة الطفل على التحليل الذاتي في بداية الحياة وتطوره السريع كطفل. ينضج الدماغ وبسبب الخصائص العقلية وقلة الخبرة الحياتية والمعرفة العلمية، يكون الطفل أكثر التزاماً بالعالم الخيالي واللعب من الشخص البالغ. لكن هذا لا يعني أن الشخص البالغ أذكى من الطفل أو أن العالم الداخلي للشخص البالغ أفقر بكثير من عالم الطفل. التقييمات في هذه الحالة غير مناسبة بشكل عام، لأن نفسية الطفل تختلف ببساطة عن نفسية شخص بالغ.
تتجلى روحانية الطفل في القدرة على الاستمتاع بالسلوك البشري (الأخلاقي)، وحب الأحباء، والإيمان بالخير والعدالة، والتركيز على المثل الأعلى ومتابعته بشكل أكثر أو أقل إنتاجية؛ في الحساسية للفن. في الفضول والنشاط المعرفي.
إن إبداع الطفل متنوع للغاية، ومظاهره واضحة جدًا لدى الجميع، وقوة الخيال على العقلانية كبيرة جدًا لدرجة أنه في بعض الأحيان تُنسب القدرة على الإبداع خطأً إلى الطفولة فقط، وبالتالي لا تؤخذ المظاهر الإبداعية للطفل على محمل الجد.
يُظهر الطفل بشكل أكثر وضوحًا كلاً من الاجتماعية والترابط العضوي بين الأقانيم البشرية المختلفة. في الواقع، يبدو أن السلوك والخصائص الشخصية وحتى المظهر الجسدي وصحة الطفل لا تعتمد فقط وليس كثيرًا على خصائص إمكاناته الداخلية والفطرية، بل على الظروف الخارجية: على طلب الآخرين لصفات معينة. والقدرات. من التعرف على الكبار؛ من موقع مناسب في نظام العلاقات مع أشخاص مهمين; من تشبع مساحة حياته بالتواصل والانطباعات والنشاط الإبداعي.
يمكن للطفل، مثل شخص بالغ، أن يقول عن نفسه بكلمات جي آر ديرزافين:
أنا صلة الوصل بين العوالم الموجودة في كل مكان.
أنا الدرجة القصوى من الجوهر.
أنا مركز الحياة،
السمة الأولية للإله.
جسدي يتفتت إلى غبار،
أنا آمر الرعد بعقلي.
أنا ملك، أنا عبد،
أنا دودة، أنا الله!
وهكذا يمكننا القول أن كلمة "الطفل" هي مرادف لكلمة "الشخص". الطفل هو كائن كوني-بيولوجي-نفسي-اجتماعي-ثقافي، وهو في طور النمو المكثف؛ إتقان وإنشاء الخبرة والثقافة الاجتماعية والتاريخية بنشاط؛ تحسين الذات في المكان والزمان؛ التمتع بحياة روحية غنية نسبياً؛ تتجلى على أنها سلامة عضوية، وإن كانت متناقضة.
لذلك، بعد فحص الخصائص المحددة للشخص، يمكننا الإجابة على السؤال: ما هي طبيعة الطفل التي دعا المعلمون العظماء في الماضي إلى الاسترشاد بها. إنها نفس طبيعة جنس الإنسان العاقل. الطفل، مثل الشخص البالغ، متأصل عضويًا في الاجتماعية الحيوية والعقلانية والروحانية والنزاهة والتناقض والإبداع.
وبالتالي، فإن التكافؤ والمساواة في حقوق الطفل والبالغ لها ما يبررها بشكل موضوعي.
بالنسبة للأنثروبولوجيا التعليمية، من المهم ليس فقط أن نعرف الميزات الفرديةالطفولة، ولكن فهم أن طبيعة الطفل تجعله حساسا للغاية، ومستجيبا لمؤثرات التربية والبيئة.
يسمح هذا النهج تجاه الطفل بتطبيق المعرفة الأنثروبولوجية بوعي ومنهجية في علم أصول التدريس وحل مشاكل تربية وتعليم الطفل بشكل فعال بناءً على طبيعته.